أول ما يذكره الشاعر والمترجم والناقد المغربي المهدي أخريف في حواره مع الآخرين هو هذه العبارة «إن أصيلة مدينتي التي ربتني جمالياً، هي مدينة تشكيلية بامتياز، بل وتحرض على ذلك.
أصيلة الهادئة، مدينة الفنانين التي تختلف عن مدن المغرب الأخرى بألوانها وبحرها وحتى رياحها». كما أن من يعرف أخريف يتعرف عليه أيضاً ناقداً مولعاً بالكتابة عن التشكيل، لا لمضاهاته كما يقول، وإنما للكتابة عن أعمال تجعل من النص الشعري موازياً لها ولكن بلغة أخرى.
التقت «البيان» المهدي أخريف في حوار شيق، كشف لها أثناءه عن نيته خلال الأيام المقبلة نشر كتاب حول الشاعر العربي الكبير المتنبي يحمل عنوان «ما لي وما للدنيا»، وآخر هو كتاب «المعمار والشعر» 2018 الذي سيصدر بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على التجربة المشتركة بينه وبين المعماري المغربي الشهير عبد الواحد منتصر، وانشغاله هو كشاعر بالقضايا نفسها، قضايا المعمار والعمران. حول الشعر، وعن قضايا جمالية يراها مهمة في حياتنا قدم لها شرحاً وافياً في كتاب المعمار والشعر حدثنا المهدي أخريف في اللقاء التالي.

جمال منشود
الشاعر المهدي أخريف نحييك ونبارك لك قرب صدور كتابك الجديد المعمار والشعر، وفي الواقع سنبدأ من الأخير، ما هو سر انشغالك كشاعر بالمعمار والهندسة؟
أنا هنا، في هذا العمل وفي الحقيقة أيضاً، معني بالجمال، وبالقيمة الجمالية للمعمار كفن، إذ ليس المهم هو الواجهات الجميلة التي تتراءى لنا من بعيد وإنما الأهم هو أن تكون هذه الواجهة مفيدة، ويمكن أن تكون على سبيل المثال لها وظيفة معينة مفيدة لحياتنا الإنسانية.
إنها كما تبدو لي وظيفة جمالية تدعو إلى القول بأهمية الجمال في معيشتنا اليومية. أما عبد الواحد منتصر فهو معماري أعتبره أحد مبدعي بلادي، المغرب، من الدار البيضاء على وجه التحديد، وفي أعماله ما يدعو إلى التفكير في حياتنا كبشر ننشد الجمال باستمرار.
منتصر درس في فرنسا وتخرج فيها، كما أنه حاصل على الخبرة في مجال المعمار من هناك، وفي ألمانيا تحديداً والمغرب بصورة عملية. وهو شديد الاعتزاز بلغته العربية، هذا ما لفت انتباهي إليه وإلى مكتبته الخاصة التي تحتوي على الشعر العربي بكثرة وبكتابات عربية فلسفية وغيرها، وكلها مكتوبة باللغة العربية، وكان حريصاً على أن تكون كتاباتنا معاً أولاً باللغة العربية، ثم تأتي الترجمة إلى لغات أخرى.
وهناك ما يحمل على الفخر في أعماله التي أنجزها داخل بلاده، في المغرب، حيث إن «المكتبة الوطنية» هي من إنجازه، وكذلك محطات القطار في «الرباط» و«وجدة» و«مكناس» وغيرها، هي من ضمن إنجازاته، ولعل واحداً من أهم الصروح المعرفية الثقافية هي أيضاً من إنجازاته وتلك هي المدينة الجامعية في الرباط.
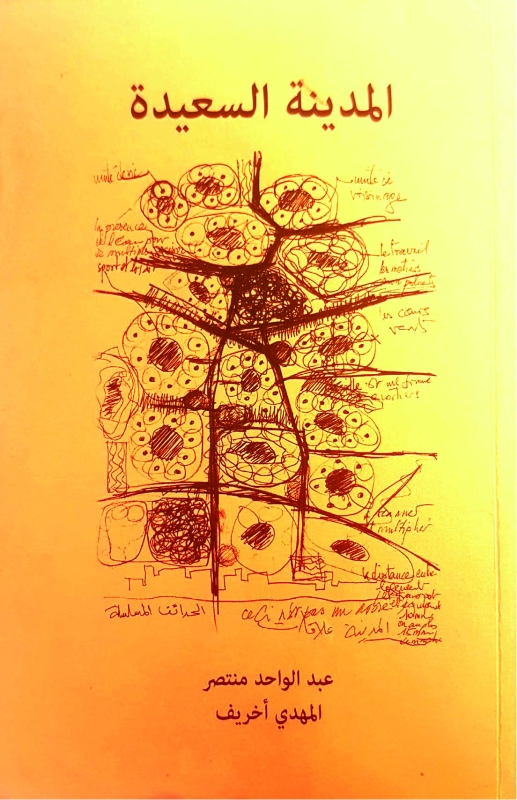
المدينة السعيدة
ما هو الجديد والمتميز في تلك الأعمال كي ترقى إلى ذلك التعاون والتشارك بينكما لتخرجا بعمل مشترك؟
القيمة الجمالية في فن المعمار الذي يقوم بتنفيذه؛ فهي أن أعماله تظل حاضرة في الأذهان على الدوام، ومن وجهة نظري فهي تتلخص في جعله يعبر عن مفهوم «المدينة السعيدة»، وقد كتبنا معاً كتاباً عن ذلك باللغتين العربية والفرنسية، قدمنا من خلاله رؤية عن هذه المدينة منذ «أفلاطون» وحتى اليوم.
إن عبد الواحد منتصر يعتبر ما يحصل لمدننا العربية الأصيلة جريمة في حد ذاتها. أما كتاب «المعمار والشعر» وهو الأخير في سلسلة أعمالنا المشتركة حول المعمار، فهو يتحدث عن المعمار والشعر، بوصفي شاعراً وبوصفه معمارياً.
والحقيقة أن فكرة الكتاب لم يكن مخططاًَ لها مسبقاً، ولكنها بدأت عندما طُلب مني أن أكتب عن علاقة الشعر بالمعمار، فأخبرت بذلك صديقي منتصر فأعجبته الفكرة، لاسيما وأننا في الشعر نتحدث عن معمار القصيدة، فنقول: بناء القصيدة، بناء القصيدة الجاهلية، بناء القصيدة المعاصرة.. ونستعمل لهذا مصطلحات، وهم في المعمار يستعملون ويتحدثون عن بلاغة المعمار ويستخدمون كذلك مصطلحات منها «شاعرية الفضاء»، وبالتالي فإننا نقترض مصطلحات من المعمار والمعماريون يقترضون من مصطلحاتنا؛ فالعلاقة قائمة، لذا فإننا نقول على سبيل المثال بأن «هذا البناء شاعري».
إن العلاقة بين الشعر وبين المعمار موجودة فعلاً وقائمة، وفي هذا الكتاب تجد بعض الصور الفوتوغرافية لأحد الأبنية الفريدة التي أنجزها منتصر، والذي يعتبر نصاً إبداعياً بمعنى الكلمة، فهو قد أبدع فيه ليس فقط في طريقة التصميم، بل إنه استطاع أن يأتي بتقنية جديدة من ثنائية الماء والضوء تؤدي وظيفة جمالية ووظيفية؛ فالمدينة التي أنشأ فيها المشروع هي مدينة حارة في الصيف وباردة جداً في الشتاء، وهو لم يلجأ إلى الوسائل الحديثة المعقدة، بل استخدم هذه التقنية لكي يقوم بما يضمن تحسن أجوائها في فصلي الصيف والشتاء.
وللعلم فهذا المشروع يدرس الآن على المستوى العالمي باعتباره ابتكاراً مهماً جداً يعمل لصالح البيئة، وفي صالح جمال ووظيفة المشروع. إن هذا ما يفعله المعمار في الفن في الواقع. ولقد أغنت هذه الأعمال المعمارية تجربتي الشعرية بعناصر جديدة كما تعززت معارفنا معا في المجالات المعرفية الأخرى كالموسيقى، وحتى الغناء.
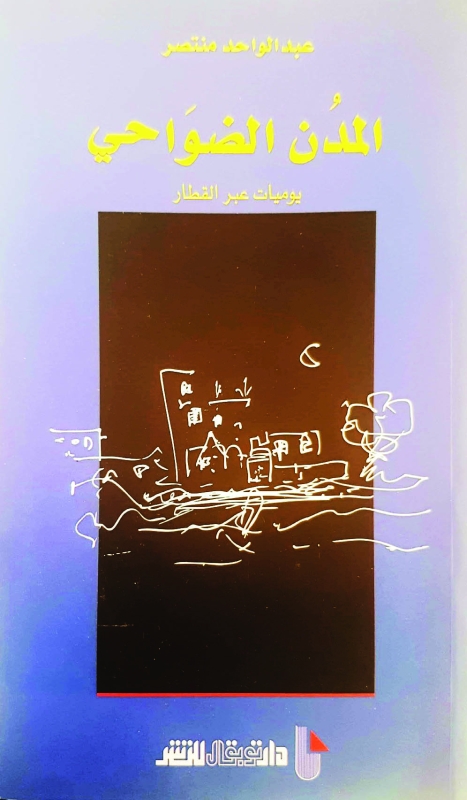
تجربة
نعود إلى علاقتك بمهرجان أصيلة الثقافي، كيف تصفها لنا وأنت من أعمدة هذه التظاهرة الثقافية؟
نلت جائزة «أوتاوا تامسي للشعر» 2011 في «مهرجان أصيلة الثقافي» وهي جائزة أفتخر بها، وهذه السنة أنا عضو في لجنة التحكيم، لقد أتاحت لي المشاركة في مهرجان أصيلة أن أتعرف إلى الشاعر الأفريقي الراحل تامسي في سنة 1989، وهو أحد الذين رسخوا تجربة مهرجان أصيلة بنبل أخلاقهم ومحبتهم وعملهم من أجل هذه التجربة الثقافية.
كما تعرفت على الشاعر العراقي الراحل بلند الحيدري وواحد من أهم أعماله وهو ديوان«أبواب إلى البيت الضيق»، وفيه قصيدة «أصيلة إذ تحيا نحيا» فعلى الرغم من أنها ليست أفضل من قصائده السابقة، إلا أنك تلمس فيها قوة وبعداً إنسانياً وانفعالياً مدهشاً، كما تعرفت على الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. ومنذ ذلك الحين لم أبرح مكاني في هذه التظاهرة التي أعشقها.
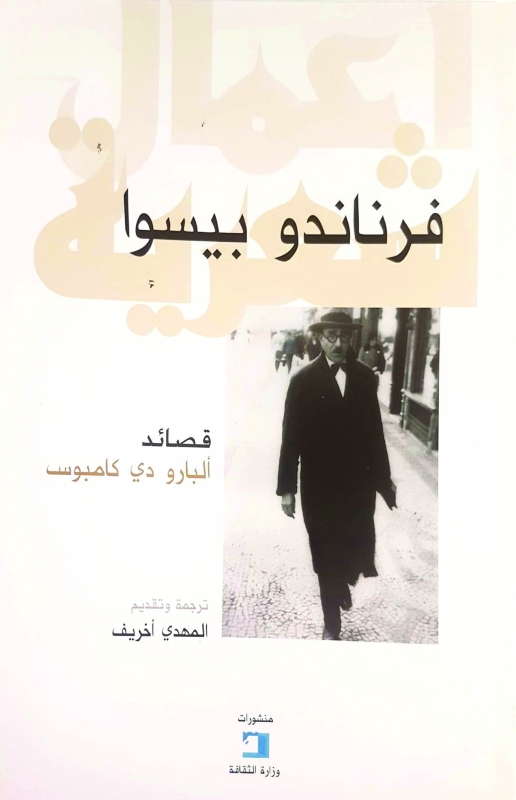
«الفرتاخ»
نود كذلك أن نتحدث عن أعمالك الشعرية، وإن كنت تفضل أعمالاً على أخرى؟
في الواقع لدي أحياناً وجهة نظر في من يكتب الشعر، إن عليه ألا يتخلص تماماً مما يكتب، لأنه ينبغي لذلك الخيط الذي يربط بينه وبين ما يكتب أن يبقى حياً، وأن يأخذ المسافة الكافية بينه وبين الشعر، وأنت عندما تقرأ تجربتك تعاود النظر إليها فتجد أنك متعدد وتسكنك ربما ذوات عدة، وإلا فماذا أقول عن تنوع بعض اللغات في كتابتي مثلاً، إنني أفاجأ بلغة بل لغات جديدة مختلفة أكتب بها لم أختبرها من قبل في بعض الأوقات، ولكن بمرور التجربة بدأت أدخل في تعديلات.
وأقول هنا على سبيل المثال إنني شديد الاعتزاز بقصيدة كتبتها في سنة 1973 وفي يوم 29 ديسمبر في جلسة واحدة من الثانية عشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً هنا في «أصيلة»، وكان عنوانها «رسوم الفرتاخ على أسوار أصيلة» والفرتاخ هو شخصية حقيقية، رجل كان مدمناً وكان شخصاً لطيفاً جداً وبسيطاً وعلى قدر من الثقافة والمعرفة، ولم يعرف عنه أنه قد آذى أحداً في حياته، لكن انتهى به المطاف إلى أن يعيش في ملجأ خيري حتى وفاته.
وكانت «موضة» الشعراء المحدثين بمن فيهم الرواد وقتها هي أن يأخذوا نماذج من التراث في قصائدهم، ولدى «السياب» و«البياتي» وخليل حاوي وصلاح عبد الصبور مثلاً تجد أنهم قد لجأوا إلى التراث، أما التراث الصوفي فكما فعل البياتي والحلاج، وكما فعل السياب مع الإغريقي والبابلي، وكذلك سعدي يوسف فقد ابتكر هو الآخر نماذج.
والحقيقة أن ما فعلته كان مختلفاً، فقد كنت قد قرأت التصوف، ولكن أخذت المفردات من البيئة المحلية المحيطة بي لتكون القناع (قناع القصيدة كما لدى أدونيس)، كانت صوراً تنتمي كلها لعالم البحر، وربما كان هو ما يعطيها القوة بالنسبة لي، وبالمناسبة فأنا لم أستطع أن أستعيدها على الإطلاق إلا بعد عشرين عاماً، وقد تجاهلها النقاد في ذلك الحين، ولكن أقول لكم بصراحة شديدة: إنني لا أعتبر كل ما كتبته بعدها في مستوى تلك القصيدة التي تظل بالنسبة لي يتيمة زمنها المغربي وربما العربي.
وأذكر ما حدث في «المهرجان العالمي للشعر» في «قرطبة» سنة 2007 عندما سألني محمود درويش ذات مرة، ونحن نتمشى في صباح ممطر ونتحدث عن الشعر: ما رأيك بما ألقيته بالأمس؟ فقلت له: شعرك أنت لا تسألني عنه لكن في اعتقادي أن هنالك أشياء كان يمكن التخلي عنها، فأجابني: إذا رأيت مقاطع في قصيدة لي ليست في مستوى المقاطع الأخرى فالمقاطع الجيدة تبرر المقاطع الأقل جودة... (يضحك، يقهقه) في الحقيقة أنه ليست هنالك قصيدة جيدة، هنالك نفس يستمر وينخفض، فلا بد أن تكون القصيدة بهذا الشكل.
بصراحة، من الذي يعجبك من شعراء الإمارات؟
في الشعر الإماراتي يعجبني حبيب الصايغ وقد قابلته ذات يوم في مهرجان أصيلة في الثمانينيات، ولكنني ما زلت إلى اليوم أقرأ له. تعجبني في الواقع تجريبيته وجرأته وتمكنه من الصنعة الشعرية.
وما أريد أن أقوله الآن عن تجربة الصايغ هو أنها تجربة مهمة في الشعر العربي، فهنالك لغة عالية المستوى، قوية، ونحن نتحدث عن الصايغ، كما نتحدث عن شعراء عرب كبار في الشعر العربي الحديث والمعاصر، وهو من الأسماء التي أضافت في مجال الإبداع الشعري العربي من خلال قدرته على التجريب. لاحظ أنه ينتقل من الوزن أحياناً إلى الشعر النثري بسلاسة، كما أن لغته تختلف من العربية الحديثة التي تحتوي النفس الإبداعي، إلى غيرها كما لو أنه نحت، هنالك بصمة في شعر حبيب الصايغ.
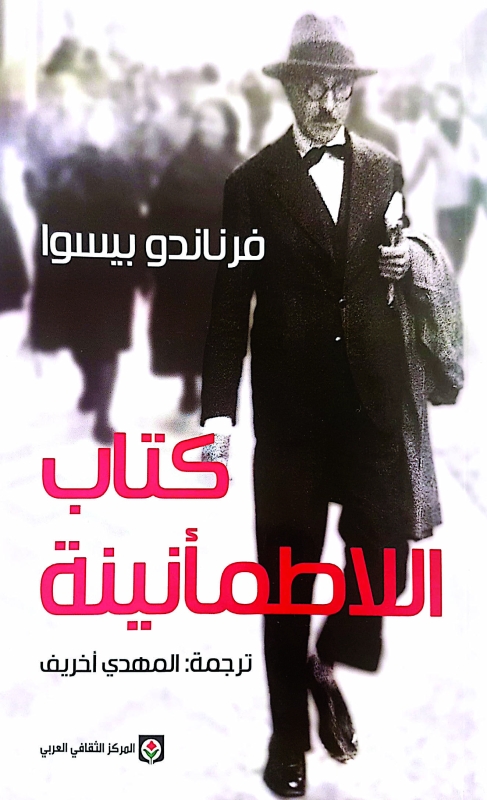
أولويتنا تقليص الفجوة بين حاضر مدننا وماضيها
قدم المهندس المعماري عبد الواحد منتصر رؤيته للمدينة، وكيف يمكن أن تصبح الفجوة بين المدينة القديمة التي ورثناها في عالمنا العربي قبل مرحلة الاستعمار، ثم مرحلة الاستعمار، وما بعده ضيقة، بمعنى ألا نكون قد أهملنا مدينتنا العربية الأصيلة لصالح مدينة عشوائية لا فائدة منها، مدينة متناثرة، خالية من الجمال لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الإنسانية. يقول المهدي أخريف في هذا الصدد: وفي اعتقادي أن الحرب الحقيقية في حياة مدننا العصرية هي أن نقلص الفجوة بينها وبين ماضيها، تاريخها، أصالتها، بخلق فضاءات سكنية ملائمة.

المستقبل هو الحَكَم والبقاء للأفضل
يقول المهدي أخريف: إنني لا أقيم نفسي ولكنني لا أخجل من أن أعتز ببعض أعمالي، هناك قصيدة أعتز بها هي «محض قناع» التي رثيت فيها صديقي العماني حسن باقر، وقصيدة «لا أحد اليوم ولا سبت» و«بين الحبر وبيني» و«في الثلث الخالي من البياض» ثم قصيدة «تمتع بالمحو»، هنا يمكنني أن أزعم بأنه من بين عدد الصفحات التي كتبتها في الشعر كلها 300 صفحة يمكنني أن أقول إنها تستحق البقاء، فهذا في الواقع هو ما يسرني وما يحذف من تجربتي لا يهمني، هذه ليست مشكلة والمستقبل هو الذي يحكم في النهاية، إن هذا ما أقوله لطلابي: من كل شاعر لا يبقى إلا القليل، لحياة الأجيال القادمة.
سيرة ذاتية
المهدي أخريف شاعر وكاتب مغربي، من مواليد مدينة أصيلة، أتم دراسته الابتدائية والثانوية في مدينتي أصيلة والقصر الكبير شمال المغرب والجامعية في مدينة «فاس» بكلية الآداب. عمل في مجال التدريس إلى سنة 2000. نشر له 13 ديواناً شعرياً منها: «مسافات البداية في عشق بدائي» 1979، «باب البحر»، «ضوضاء نبش في حوش البحر»، «لا أحد اليوم ولا السبت».
كما صدرت له مجموعة من الأعمال المترجمة عن الإسبانية منها «لا طمأنينة»، و«لكل الأنداد» لفرناندو بوسوا، ولأنطونيو غامونيدا «كتاب البر»، ترجم عدداً من أعمال لوركا منها «اللهب المزدوج». نشر له 14 عملاً نثرياً ونقدياً في (النقد التشكيلي) منها «الصوت التشكيلي» وفي النقد الشعري نشر له كتاب «الصوت الحتمي» و«بديع الرماد» وغيرها.

