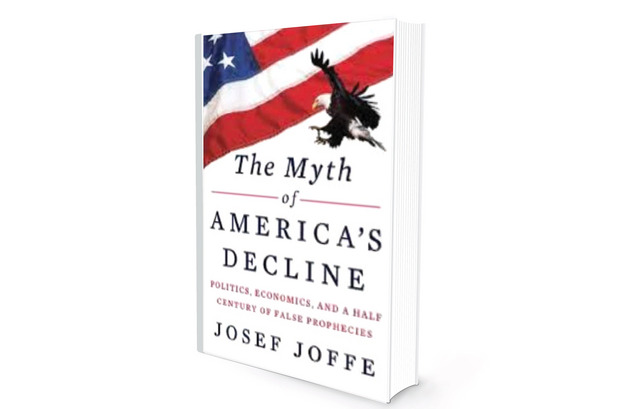خرافة انحدار أميركا
الانتصارات الناعمة وراء تعزيز مكانة أميركا عالمياً
يأتي هذا الكتاب أقرب إلى مرافعة فكرية تتوسل بأساليب البحث السياسي والتحليل الاقتصادي والسرد الإحصائي دفاعاً عن موقع الولايات المتحدة الأميركية الراهن، بوصفها بلداً قائداً أو رائداً في العالم المعاصر.
ويصدر المؤلف عبر فصول هذا الكتاب عن حالة مجابهة للرد على الطروحات التي ما برح أصحابها من المفكرين والكتّاب يسوقون تنبؤات عن انحسار النفوذ الأميركي أو تراجع الأنساق الحضارية أو انقطاع العمران فيها ،حسب المصطلح الذي سبق إلى صياغته منذ عدة قرون المفكر العربي المسلم عبد الرحمن بن خلدون، وكان في مقدمة هؤلاء المحللين الكاتب الأميركي من أصل هندي فريد زكريا، وخاصة في كتابه الشهير الصادر منذ سنوات قلائل بعنوان »عالم ما بعد أميركا«، وفيه يرشح مع غيره الصين لكي تصبح القوة المهيمنة رقم واحد في عالم القرن الواحد والعشرين.
في ضوء المقارنة بين تراجع أميركا وصعود الصين، وخاصة في مجال النمو الاقتصادي والإنتاج السلعي. وفي معرض هذا الدفاع الذي يتبناه الكتاب، يسوق المؤلف ما يراه من إيجابيات لاتزال أميركا تتمتع، بل تتفوق، بها على كثير من منافسيها، ويرى أن في مقدمة هذه النقاط الإيجابية ما يتمثل في استمرار تدفق التيارات المهاجِرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يزود مجتمعها في نهاية المطاف بقدرات التجديد والابداع، فضلاً عن تجديد دماء شعبها بقدرات الشباب، مقابل ما آلت إليه أحوال مجتمعات أوروبية وآسيوية أيضاً من الإصابة بسلبيات شيخوخة سكانها وهو ما قد يحرمها من طاقات التجدد وهمة الابتكار.
في السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر نشر المؤرخ العربي المسلم عبد الرحمن بن خلدون أطروحته الشهيرة باسم »المقدمة«، وتحدث فيها عن ظاهرة الانحسار والتداعي التي تلحق بالدول والحضارات، ثم وصَفَ الظاهرة في عبارة تقول: »انقطاع العمـــران«. وبعد 400 سنة من ابن خلدون، نشر المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون (1737- 1794) كتابه الذي لايزال من عيون الأدبيات الإنجليزية وكان النشر خلال الفترة (1776- 1788) حيث جاء الكتاب تحت العنوان التالي: »اضمحلال وانهيار الإمبراطورية الرومانية«
هكذا انشغل المفكرون ومحللو ظاهرة الاجتماع الإنساني ودارسو بدايات ومآلات الحضارة البشرية بمسار كل ظاهرة حضارية عاشتها البشرية على سطح الأرض.
والحاصل أن متابعة مسارات الحضارات الإنسانية ستظل جهداً لا ينقطع من جانب من يتحملونه من مؤرخين ومفكرين وباحثين وأكاديميين، ورغم تباين هذه التخصصات على نحو ما نرى، إلا أن مثل هذه الكوكبة من أهل الفكر والبحث المهتمين بمصائر الحضارات كان لابد وأن تضم راصدين للحضارة، منهم من يتوقع استمرارها وازدهارها، وإن كانت كثرتهم لا تلبث أن تحّذر من أفول شمس الحضارة وتحولها إلى مواجهة مصير التعثر والانحسار.
وبعيداً عن الإغراق في تناول تاريخ الحضارات الغابرة، وهو موضوع يطول ويطول بحكم تعريفه، فإن الكتاب الذي نعايشه فيما يلي من سطور سوف يشغل نفسه ،ويشغل قارئه بالتالي، بقضية طالما شغلت بدورها أفهام واهتمامات الكثيرين منذ منتصف الفرن العشرين وحتى هذه السنوات الاستهلالية من هذا القرن الواحد والعشرين.
الظاهرة المطروحة حاليا تتعلق بالولايات المتحدة التي يمكن أن يقال عنها إنها ذلك الكيان السياسي الذي اتسعت شهرته في زماننا، حتى أنه ملأ الدنيا وشَغَل الناس، كما يقول التعبير المأثور في معاجم البلاغة العربية.
عن أميركا وأصولها
لقد ظلت الولايات المتحدة (أميركا كما يعرفها العالم اختصاراً أو تبسيطاً) كياناً ناشئاً، مترامي الأطراف، لكنه كان متباعداً عن سائر بقاع العالم، وبغير تأثير يذكر على امتداد القرن التاسع عشر وحتى السنوات الأولى من القرن العشرين.
لكن لم يكن العالم يملك سوى الإصغاء إلى صوت الولايات المتحدة، وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبالذات خلال ملابسات مؤتمر الصلح في باريس، حين أعلن رئيس أميركا في ذلك الحين وودرو ويلسون (1856- 1924) مبادئه الأربعة عشر الشهيرة في ديسمبر من عام 1918 وكان من أبرزها المناداة بحق تقرير المصير لسائر الأمم والشعوب.
من هنا نال الرئيس ويلسون إعجاب العالم في تلك الفترة، وتكلل هذا الإعجاب بمنح الرجل جائزة نوبل للسلام عام 1919، مع تدشين ما نادى به ويلسون بإنشاء عصبة الأمم مع عقد العشرينات، وهي الجد الأعلى لمنظومة الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها، كما هو معروف، في منتصف أربعينات القرن الماضي.
مع هذا كله، فقد ظلت أميركا قابعة على حافة أحداث العالم، إن لم يكن عند هامش تلك الأحداث، وخاصة بعد أن حلّت بها أزمة الكساد الفادح الكبير ،كما وصفوه، على مدار عقد الثلاثينات.
بعدها كانت مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، وهي الحدث الفاصل بحق من حيث تحديد موقع أميركا، بل وتحّولها من مجرد مكان جغرافي في غربي الكرة الأرضية إلى احتلال مكانة جيو- سياسية واستراتيجية على امتداد سنوات النصف الثاني من القرن العشرين.
القوي الخشنة والناعمة
والنظرة الموضوعية إلى عوامل التحول المذكور تنبئ بأن الفضل فيه إنما يرجع أولاً إلى أن أميركا قادت قوات الحلفاء للانتصار على ألمانيا النازية وشريكتيها في دول المحور، وهما إيطاليا واليابان.
هذه النظرة نفسها تفيد على وجه التأكيد بأنه إلى جانب هذا الإنجاز الخشن كما قد نسميه، فقد تعززت مكانة أميركا بفضل انتصارات ناعمة بكل معنى الكلمة، وكان في طليعتها فتوحات الولايات المتحدة في مجالات العلم التطبيقي والإبداع الفني.
حيث أهدت إلى عقود القرن العشرين إنجازات مشهودة في ميدان الطب والعلاج، وفي عالم السينما وفي اختراع- اكتشاف الراديو ومن بعده التليفزيون، وهو ما أدى إلى استحداث مساق للدرس الأكاديمي تحت عنوان علم الاتصال الجماهيري ووسائل الإعلام، فضلاً عن إضافات كان لها وربما لايزال لها تأثيرها، بل جاذبيتها وذيوع صيتها على صعيد الكرة الأرضية وعلى اختلاف الأنساق الثقافية والأنماط السلوكية، وهي تبدأ مثلاً بمشروبات الكولا، ولن تنتهي بسراويل الجينز وملبوسات »الكاجوال« ثم وجبات الطعام الجاهزة والسريعة، ومنها إلى ثورة الحاسوب بكل ابداعاتها.
في ضوء هذا كله، ظهر من أهل السياسة والفكر، ناهيك عن أهل الدعاية والتزويق والتمجيد، من يتحدث عن أميركا الفتية الصاعدة، وربما الجبارة، كما كان يحلو للبعض أن يصفها في مراجع شتى.
وكان طبيعياً، ربما لكي تستقيم الأمور، أن جاء من النقاد والمفكرين والفلاسفة والمحللين من تناول أحوال أميركا من المنظور المقابل هنالك استدعى القوم مقولات ابن خلدون العربي المسلم، وطروحات إدوارد جيبون المؤرخ الإنجليزي، وكلها مقولات أسلمت إلى أن أميركا في طريقها إلى حالة من التراجع إلى الانحسار والانحدار، كما قال جيبون، أو إلى انقطاع العمران، على نحو ما ذهب إليه ابن خلدون.
بين الهواجس والوقائع
ولم يكن التعبير عن انحدار أميركا مجرد هواجس ساورت نفراً من المتشائمين، لقد كان بيــن صفوفهم مَنْ رَصَد ورطة أميركا بكل قدراتها وإمكاناتها في أوحال مستنقع فيتنام خلال عقد الستينات، وكان من بينهم من رصد أيضاً تقدم الاتحاد السوفيتي المنافس، وخــاصة السبق الذي حققه في مجال استكشاف وغـزو الفضاء الخارجي، منذ أطلق أول قمر اصطناعي في التاريخ دار حول كرة الأرض يدعى »سبوتنيك« في عام 1957، ومن بعــده توالت انتصارات موسكو السوفيتية على واشنطن الأميـــركـــية، علــــى شكل أول إنسان حلّــق في الفضاء في مطلع الستينات، ويدعى يــورى جاجارين، ومن بعده كانت أول امرأة - سوفيتية طبعاً- حققت هذا الإنجاز، وكان اسمها فالنتينا تريشكوفا.
ومع توالي سنوات السبعينات وما بعدها، عانت أميركا من فضائح سياسية ،كانت أشهرها قضية ووترغيت، التي أوصلت رئيس البلاد آنذاك ريتشارد نيكسون إلى حافة المحاكمة، وإلى حد أن وصفته وسائل الإعلام الأميركي عند منتصف السبعينات بأنه الرجل الذي كَذَب على الأمة.
وعلى متن هذا التيار تصاعدت الأصوات، منذرة بخطر الانهيار الأميركي، بمعنى تراجع نفوذ أميركا وتقزيم مكانتها في العالم وانحسار الهيبة التي طالما نَعِمت بها في مجتمع الدول. صحيح أن توقفت أو خفتت مثل هذه الأصوات بعد زوال الخصم السوفيتي وظهور الشعارات التي رافقت مطالع تسعينات القرن حول أميركا بوصفها القطب العالمي رقم واحد.. إلخ، لكن الصحيح أيضاً أن أميركا لم تكد تنعم طويلاً بهذه الهدية التي تلقتها من ملابسات التاريخ: لقد جاء الصعود السريع وربما غير المتوقع في وتيرته ونتائجه لبلد آسيوي، اسمه الصين، ليؤكد أن هناك منافساً مستجداً آسيوياً هذه المرة- ويتسم بالإصرار والمثابرة وخطورة التحدي في آن معاً.
في ضوء هذا كله كان على مؤلف كتابنا أن يتصدى لهذه المقولات، التي طالما دارت حول انهيار أو انحدار أميركا.
يصفها المؤلف في عنوان كتابه بأنها مجرد خرافة يحلو للبعض ترديدها. ويختار للكتاب من ثم العنوان التالي: »خرافة انحدار أميركا: السياسة، الاقتصاد، ونصف قرن من النبوءات الزائفة«.
المتهم الأميركي
من هنا يأتي الكتاب أقرب إلى مرافعة حارة، مـــعززة بالأدلة، ومزودة بالمراجع والأسانيد. وهو دفاع يتميز بأن صاحبه، مؤلف هذا الكتاب، ألماني المولد ولكنه أميركي الإقامة والتكوين، وهو الكاتب جوزيف جوف.
يبدأ المؤلف كتابه باستعراض وافِ لما سبق وعرضْنا له من قصائد الرثاء السياسي، كما قد نسميه، تلك التي طالما نعت تراجع مكانة أميركا وأبرزت واقع معاناتها في الداخل والخارج على السواء.
في ذلك الإطار تسامَع أهل الجيل المخضرم بعبارة الزعيم الشيوعي الأسبق خروشوف خلال زيارته لأميركا أواخر الخمسينات. ويومها خاطب مضيفيه بعبارة مدوية قال فيها: سوف ندفنكــــــم، !
يستعيد المؤلف أيضاً وصف دور أميركا في فيتنام بأنه محاولة جماعية للانتحار، ويستعيد كذلك تعليق رئيسهم الأسبق جيمي كارتر معلقاً في السبعينات على هبوط قيمة الدولار فقال: إن أميركا مصابة بمرض عضال. كما يستعيد ملابسات التسعينات التي وصفت أميركا بأنها شمس غاربة مقابل اليابان الموصوفة بأنها شمس مشرقة.
هنالك يخّف مؤلف الكتاب إلى تركيز مرافعته تفنيداً في تصوره- لمقولات انهيار أو انحسار يصيب أميركا وأسلوب حياتها، وذوْداً في تصوره أيضاً عن مستقبل أميركا، وفي سياق هذا التركيز تطرح المرافعة الإيجابيات التالية:
إن تيار الهجرة الذي ما برحت أميركا تستقبله وافداً من كل فجــاج المعمورة كفيل بأن يزود مجـــتمعها بعــناصر التجديد والعافية والحيوية، بحيث أصبح ممكناً معها أن توصف الولايــات المتحدة بأنها مازالت أكبر معمل لتصنيع درجة الدكتوراه التخصصية في عالمنا، ولاسيما في مجالات العلم والهــندسة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل عام.
إن أميركا لاتزال تضم معدلات صحية إلى حد مُطمئن للمواليد وبالتالي تضم المعدلات المطلوبة من المواطنين في سن الشباب والفتّوة، بالمقارنة مع ظاهرة الأفول، الغروب الديمغرافي الذي باتت تعانيه القوى المرشحة للمنافسة سواء في غرب أوروبا أو في شرقي آسيا، (ألمانيا أو إيطاليا، دع عنك اليابان، كمجرد أمثلة- أصبحت تعاني من ازدياد عدد المتقدمين بل الطاعنين في السن على حساب عدد النشء الطالع، وهو ما أصبح يعرف باسم شيخوخة السكان .
هاجس اسمه آسيـــا
رغم هذا كله، يلاحظ القارئ اللبيب أن ثمة هاجساً لا يلبث يراود باستمرار تلك المرافعات البليغة، التي يحشدها مؤلف كتابنا دفاعاً عن بقاء أميركا على سطح أو فوق قمة الأحداث، هذا الهاجس تلخصه كلمة واحدة هي آسيا. صحيح أن المؤلف يتوقف ملياً، وبقدر لا يخفي من التفصيل، إن لم يكن من التشفي- كما قد نعترف عند علامات الوَهَن أو التراجع التي أصابت أخيرا، اندفاعة اليابان ولأسباب عديدة.
لكن الأصح أن الهاجس الأكبر للمؤلف، ولكثير من محللي الشأن الأميركي مدافعين كانوا أو منتقدين هو الصـــين. ولهذا السبب ينطلق مؤلفنا موضحاً أن الصين ، مهما بلغت أشواط تقدمها الراهن في مضمار البحث والتطوير أو مجالات العلم والتكنولوجيا، وخاصة ما يتعلق بأحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مازالت عاجزة، كما تؤكد فصول هذا الكتاب، عن التوصل إلى ما يصفه المؤلف بأنه ثقافة تقنية متكاملة ومتبلورة ومستقلة بذاتها.
على كل حال، يشدد الكتاب على أن من عوامل استمرار القوة الأميركية هو استمرار تعاطيها مع قضايا العالم الخارجي، بمعنى مواصلة رفضها أي منطق للانعزال أو التباعد عن التيارات السياسية والاقتصادية التي يموج بها الواقع الحي الذي يعيشه عالم هذه السنوات الاستهلالية من الألفية الثالثة.
وبحكم التوجهات الأكاديمية التي يصدر عنها مؤلف الكتاب، فهو لا يفوته القول بأن أي انحسار أو أي انهيار يمكن أن يتعرض له الكيان الأميركي المعاصر لن يكون إلا من صنع هذا الكيان ذاته، وبمعنى أن بناة الكيان المذكور استطاعوا أن يزودوه في تصور مؤلفنا- بقدرات الدفاع الذاتي مستغلين في ذلك كما نتصور من جانبنا أيضاً بُعد المكان (الجغرافيا) الذي اختار لأميركا زاوية قصية أو شبه قصية في غرب العالم، ثم بُعد الزمان (التاريخ) الذي اختار لأميركا موعداً في روزنامة التطور السياسة العالمي كاد يتزامن مع غروب الكيانات الإمبراطورية والممالك المستبدة.
فيما كان يتزامن بالفعل مع انبلاج عصر الثورة السياسية، التي نادت بالحرية والديمقراطية منذ أحداث 14 يوليو1789 في فرنسا ثم عصر الثورة الصناعية الاقتصادية التي تزامنت بدورها مع اكتمال الكيان الذي آذن بنضوجه وبلورته باسم الولايات المتحدة الأميركية مع انتصاف القرن التاسع عشر.
مع هذا كله لا يملك المؤلف أيضاً سوى الاعتراف بأوجه القصور التي يعيشها الواقع الأميركي الراهن، ما بين سوء الأداء الحكومي أو معاناة الفروق الطبقية بين الذين يملكون والذين لا يملكون، أو عيوب التغطية بالرعاية العلاجية والتأمين الصحي، بل وحالة التنافر إلى حد التباغض أحياناً بين الأعراق الأثنية التي تشــكل نسيج المجتمع الأميركي المعاصر.
لكن مرافعاته الحارة التي يسوقها على مدار صفحات هذا الكتاب تجعله لا ينسى التركيز على الصين بالذات، التي يحاول المؤلف أن يفتّش عن أوجه ضعفها الراهنة، في مسعى حثيث من جانبه للرد على جمهرة المحللين السياسيين الذين يتوقعون أن تحوز بكين الصينية قصب السبق على واشنطن الأميركية، ومنهم من يتجاوز إلى تحديد الأمد الزمني لهذا السبق الذي يجعل من الصين القوة العولمية رقم واحد بدلاً من أميركا، فيجعله في نطاق قد لا يتجاوز عام 2025 فقط لا غير.
المؤلف في سطور
يتسّم جوزيف جوف بما يمكن وصفه بأنه ازدواجية أو ثنائية الثقافة، حيث يجمع بين الثقافتين الألمانية والأميركية في آن معاً. يبلغ من العمر 75 عاماً. وفي إطار هذا الازدواج البنّاء، يجمع أيضاً بين مسار الصحافة والتعامل مع وسائل الإعلام، وبين مسار الأكاديمية والتواصل مع مؤسسات البحوث العلمية الأكاديمية.
وفي المسار الأول، عمل المؤلف رئيساً لتحرير صحيفة أسبوعية ألمانية مرموقة هي »داي زايت« بعد أن ولد في بولندا، ونشأ في برلين الغربية، فيما حصل على الماجستير في أميركا من جامعة هوبكنز، ثم على الدكتوراه من جامعة هارفارد في موضوع أصول الحكم، وبعدها انخرط في السلك الأكاديمي باحثاً وأستاذاً محاضراً في كبرى الجامعات الأميركية.
وبحكم اهتمامه بالسياسة الدولية، وبخاصة دور أميركا على مستوى العالم، تعاون المؤلف مع زميليه زبنغيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، وفرانسيس فوكوياما، المفكر الأميركي الياباني المعروف، على تأسيس مجلة»أميركان إنترست«، التي لاتزال معنية بهذا الدور الأميركي سلباً وإيجاباً في دنيا العولمة، وهو ما ظل يبحثه مؤلف الكتاب إلى جانب مقالاته الشهيرة التي ينشرها في مجلة»فورين بوليسي«.
على أن هناك من يصنّف المؤلف ضمن فئة المثقفين المحافظين وأحياناً في خانة المحافظين الجدد في ميدان السياسة الأميركية، وإن كانت توجهاته الأكاديمية قد حالت بينه وبين التوّرط في المواقف السياسية المرفوضة لهذه الفئة من المفكرين والسياسيين الأميركيين.
عدد الصفحات : 352 صفحة
تأليف: جوزيف جوف
عرض ومناقشة: محمد الخولي
الناشر: مؤسسة فرايت، نيويورك، 2014