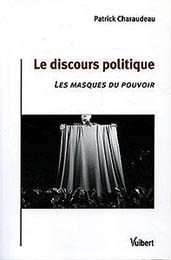مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور «باتريك شارودو،» الذي يدرس في جامعة باريس ـ الجنوب، والذي يدير مركز تحليل الخطاب في فرنسا. لقد حرر »شارودو» عديداً من الكتب التي جعلته مختصاً في تحليل الخطاب وفي الوسائل الإعلامية، من بينها: خطاب الأخبار الإعلامي (1977)، الخطاب المصادر (1977)، التلفزيون والحرب (2001)، قاموس تحليل الخطاب (2002)، وسائل إعلام الأنباء ـ استحالة شفافية الخطاب (2004).
يتناول الكاتب الخطاب السياسي من زاوية الكلام المستخدم، ومن هذه الزاوية بالذات فإنه يعتبر هذا الخطاب ممارسة اجتماعية تسمح للأفكار والآراء والتصورات أن تنتقل في مجال عمومي يتواجد فيه مختلف الفاعلين الذين يرتبطون فيما بينهم باحترام بعض قواعد النقاش والتداول.
ولكن الخطاب السياسي يتغذى أيضاً بالرغبة بل والحاجة إلى التأثير على الآخرين بما يخلق علاقات قوة تقود في وضع السيادة الديمقراطية إلى استخدام استراتيجيات متعددة وبوجه خاص الإقناع والاجتذاب والتي توظف فيها مختلف «الرساميل السياسية والثقافية والاجتماعية» لرجال السياسة، ومختلف التصورات الاجتماعية القائمة التي تشترط بشكل ما الخطاب. فالصورة التي يريد فيها صاحب الخطاب إبرازها إزاء منافسه ولإقامة علاقة بينه وبين الجمهور الواسع مرتبطة بهذه الوقائع الملموسة.
بمعنى آخر فإن المؤلف لا يريد تناول هذا الخطاب السياسي أو ذلك سواء أكان خطاب يسار أم يمين، أم كان خطاباً فاشياً أم توليتارياً أم متطرفاً، بقدر ما أنه يهدف إلى تعيين مجال الممارسة الاجتماعية التي يتحرك فيها الخطاب وتوضيح شروط ظهوره وانتشاره.كل سلطة قائمة هي «بجزء منها سلطة القول والصورة كما يعبر الكاتب «مارك أوجيه». هذه السلطة تمر إذن بمد وقائع الكلام الذي يستخدم وعبر الانطباع الذهني لدى الجمهور حول السياسي.
ذا يطرح مشكلة أساسية: هل الأمر يتعلق بخطاب يُنتج في المجال السياسي، أم أنه يتعلق بالسياسة كخطاب، هل الفعل السياسي ثانوي بالعلاقة مع الخطاب، أو أن هذا الأخير يمثل عكس ذلك قاعدة السياسة بما يجعله يشكل بنية فوقية لها.
وإذا ذهبنا أبعد من ذلك نرى أن مشكلة تناول الخطاب السياسي تطرح قضايا متعددة ألا وهي: الكلام ـ الفعل ـ الحقيقة ـ السلطة وبالتالي تعدد الأبحاث حول ذلك حسب الاختصاصات، فلسفة، أم علم اجتماع، أم علم النفس الاجتماعي، أم العلوم السياسية، أم العلوم الألسنية بحيث يصعب تحديد إشكاليات السياسة والخطاب السياسي.
وفي هذا لابد من تمييز بين السياسة والفعل السياسي. فالأولى تتعلق بكل ما ينظم الحياة الاجتماعية باسم بعض المبادئ التي تشكل نوعاً من المرجعية المعيارية. بعبارة أخرى السياسة هي نمط من الوجود لحياة مشتركة يتوافق عليها مجتمع بشكل أو بآخر. والثاني يعني الممارسة السياسية في إدارة شؤون الحياة الاجتماعية عبر علاقات سلطة وسلطة موازية أو مقابلة.
إذن وبالتأكيد أن العلاقة بين السياسة والممارسة السياسية هي علاقة جدلية لأن هذه الممارسة لا يمكن أن تجري دون المبادئ التي تؤسس السياسة، ولأنه لا يمكن تصور السياسة إلا ضمن فاعلية تجعلها محط التجربة والاختبار.
ومن هنا فإذا كان الخطاب السياسي يحتاج إلى مرجعية السياسة فإنه يعمل عبر ممارسة اجتماعية للفعل السياسي، ومن خلال مجال عمومي يتحرك فيه داخل النظم الديمقراطية.
والواقع أننا أمام هيئتين إن صح التعبير ألا وهي الهيئة السياسية التي تأخذ على عاتقها القيام بالفعل السياسي، والهيئة المواطنية التي تضطلع باختيار ممثليها إلى السلطة السياسية. إلا أن هناك فرقاً بينهما، لماذا؟ لأن عمل الهيئة السياسية يتمحور على اتخاذ القرار بينما يرتكز عمل الهيئة المواطنية على التفويض. وإذا كانت فاعلية الهيئة الأولى قائمة على «ما هو ممكن»، فإن فاعلية الهيئة الثانية قائمة على «ما هو مرغوب».
والمهم في هذا أنه لا يمكن فصل الخطاب السياسي عن كل من الهيئتين، وبما يجعله لا يعني المبادئ والمعايير للحياة السياسية، وإنما أيضاً «مكونات الظاهرة السياسية» برمتها حسب تعبير المفكر الفرنسي «كلود لوفور». وإذا كان لابد من التأكيد على أننا كائنات فردية، فإننا كائنات جماعية بنفس الوقت، أي أنه لا يمكن تخيل فرد دون محيط اجتماعي، بنفس الوقت الذي لا يمكن فيه تصور ذات إنسانية لا تتميز عن غيرها بشكل أو بآخر.
والخلاصة أنه عندما يفتح خطاباً فنحن أمام إكراهات معيارية ومصطلحات لغوية نستخدمها في علاقتنا مع الآخرين في الوقت الذي نمارس فيه ذاتنا الإنسانية، الأمر الذي يفسر في النهاية تناول السياسة برمتها (مبادئ ومعايير وفعلاً أو ممارسة سياسية) عبر الخطاب السياسي بالذات. من ذلك فإن الاتصال الإنساني هو نوع من مسرح واسع تتحقق عليه علاقات البشر، أدواراً معروفة أو متوقعة في بعضها، وأدواراً غير مرئية ولا منتظرة في بعضها الآخر.
وفي المجال السياسي، فإن هذه العلاقات هي علاقات تأثير ونفوذ وسلطة حسب مواقع وأدوار الفاعلين السياسيين، وذلك ضمن ما يسميه الكاتب بـ «عقد الاتصال السياسي» لماذا؟ لأن كل خطاب هو نقطة تقاطع بين حقل الفعل السياسي (مكان التبادلات الرمزية، الحقل المنظم حسب علاقات النفوذ والقوة فيه كما يقول العالم الاجتماعي «بورديو») وبين حقل المنطوق السياسي (مكان الكلام المستخدم مرجعيات وتصورات بين الفاعلين السياسيين).
ويحيلنا الكاتب إلى مسألة أساسية، ألا وهي العلاقة التي يقيمها السياسيون مع «المتصور الاجتماعي»، أي جملة الرؤى والأحكام والمعايير القائمة في الذهنية الاجتماعية حول الواقع والآخر والعالم. فهذه المنظومة هي التي تقوم بتأويل الواقع وإدخاله عالم المعنى الذي تحتاجه كل جماعة بشرية. وهذا لا يعني أن المتصور الاجتماعي صائب أم خاطئ ولكن يعني ذلك أنه يؤخذ من قبيل الحقيقة.
وهذا المتصور الاجتماعي من شأنه أن يدخل مجال النظريات والعقائد والايديولوجيات. إنه ما يعتقده الناس على أنه حقيقي ويدركون من خلاله الأحداث والأفعال الإنسانية، بل انه يشكل نوعاً من هوية لهم. بمعنى آخر فإن الخطاب، أي خطاب كان مرتبطا بعالم المتصور الاجتماعي المختلط والمتداخل والذي يستعم بعضه بعضاً. وإذا كان المتصور الاجتماعي ليس عقلانياً فإن الخطاب يعمل على إكسائه بالطابع العقلاني مثل خطاب «الصفاء الوفي» أو «التفوق الثقافي» أو «التقدم التكنولوجي» أو «السوق الحرة» ... الخ.
هذا ما ينقلنا إلى الخطاب السياسي بحد ذاته، لماذا؟ لأن المتصور الاجتماعي جزء لا يتجزأ منه. فمهما كانت الطرق التي تعالج بها هذا الخطاب، فإنها تعيدنا دائماً إلى قيم في الحياة الاجتماعية، قيم إيجابية بطبيعة الحال، لأنها تتعلق بالرفاه للفرد، والازدهار الاجتماعي، والمساواة، والعدالة ... والمسألة هنا لا تتعلق بمصداقية هذه القيم وإنما بقوة الحقيقة التي تكتسيها والتي تجعلها تعلو فوق كل شيء. ولكن هل قوة الحقيقة موجودة في جوهر الحقيقة بالذات أم أنها موجودة في الأثر الذي تتركه في الجمهور؟ في الحالة الأولى تبدو الحقيقة وكأنها بدهية مستقلة، وفي الحالة الثانية فإن قوة ا��حقيقة تعني الاعتقاد بها وكفى.
في كافة الأحوال فإن بعض الحقائق تظل موضوع النقاش والسجال في المجال السياسي، بينما إذا أخذ بالحقيقة كأمر على الجمهور، فإن هذا الأمر نفسه مرتبط بالقصور الذي تحمله كل جماعة إنسانية عن نفسها وواقعها والعالم. وباعتبار أن المتصور الاجتماعي متعدد فإن الخطاب السياسي ليس واحداً بالضرورة، لأن بعضه يقيم نفسه على «متصور التقاليد» التي يعتقد بصحتها أو متصور «الماضي الذهبي» أو متصور «الأصول الخاصة» أو «متصور الحداثة» أو متصور «المجتمع الإعلامي» وذلك كحالة مثالية مرغوبة.
وهذا التعدد في التصورات الاجتماعية يمكن أن يطرح حتى بالنسبة لمجال واحد فيها. فمثلاً الخطاب السياسي حول الديمقراطية ليس واحداً. هل الأمر يتعلق بديمقراطية تمثيلية وكيف؟ أم أنه يتعلق بديمقراطية مباشرة وبأية شروط؟ أم أنها ديمقراطية لا مركزية (أقاليمية) أو طائفية (بالنسبة لبعض بلدان الجنوب)؟
هل الخطاب الديمقراطي في حالة أوروبا يعني إقامة فيدرالية دول ـ أمم أم أنه اتحاد أمم سيادية تحتفظ بخصوصياتها القومية، أم أنه يعني تحقيق تضامنات لا تحقق وحدة ولا اتحاداً والكاتب يلح على أن الخطاب السياسي كممارسة اجتماعية قد تغير بفعل التطورات التي جرت في المجتمع:
تفكك الجماهير الواسعة إلى مجموعات اجتماعية واعية لمصالحها وتدافع عنها، ارتفاع مستوى المعيشة، انتشار التعليم، ازدهار المعرفة، تضارب العلاقة بين النخب والشعب، وجود سلطات وسلطات مقابلة، بروز مجتمع مدني، مواطني جديد، انحسار دور الدولة، الراعية، تضعضع الايديولوجيات الكبرى.. لقد قاد هذا كله إلى متصورات جديدة للحياة الاجتماعية.
ولعل خطاب «ليونيل جوسبان»، رئيس وزراء فرنسا الاشتراكي عام 2001 يرمز إلى نوعية الخطاب السياسي الجديد. فالأمر لا يتعلق بالنسبة له بوجود فرنسا قوية أو حداثية لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون هناك من فرنسا قوية وحداثية إلا إذا تم العمل ضد الظلم الاجتماعي.. وإلا بالتضامن بين المواطنين، وإلا بجمهورية أكثر ديمقراطية لا تقبل التقسيم وتؤكد على وجودها داخل أوروبا موحدة (السيادة ما فوق القويمة) تخدم هوية كل شعب داخلها (هوية قومية). باختيار إنه خطاب يريد الجمع بين التاريخ والجغرافيا ومتطلبات العصر القائم.
بهذا يكثر القول حول أن السياسة لم تعد كما كانت في الماضي، وأنه لا يوجد من قضايا كبرى للدفاع عنها، ولا مشاريع حقيقية لتغيير المجتمع، ولا من نقاش سياسي شامل ومعمق، ولا يوتوبيا جديدة تحرك أوسع الجماهير.
وإذا كانت التطورات الجديدة تفسر هذا الواقع، فلابد من الالتفات إلى مفعول وسائل الإعلام الحديثة وانعكاسه على الخطاب السياسي نفسه. فكل مجتمع يحتاج إلى وسيط اجتماعي أي منظومة من القيم التي تعطي الشعور بوحدة اجتماعية وبكينونة مشتركة. ولكي تلعب هذه المنظومة دور الاسمنت اللاحم،
فلابد أن تكون متقاسمة بين جميع الأفراد. ومن أجل ذلك فإنها تحتاج إلى دعامة أو هيئة اجتماعية تسهر عليها متمتعة بذلك بنوع من الهيبة والنفوذ. ففي القرون الوسطى كانت الكنيسة هي التي تؤمن انتشار «الأخلاق الدينية»، وفي القرن الثامن عشر قامت المنشأة الإنتاجية ببث «أخلاقية العمل»، وفي القرن العشرين قامت وسائل الإعلام بتعميم «أخلاقية الاتصال».
لقد أصبحت هذه الوسائل «الآلة» الجديدة لحركة المجتمع، إعلاماً وتحليلاً وشرحاً واتصالاً ومسرحة للحياة الاجتماعية واجتذابا للجمهور. علاوة على ذلك فلقد أصبحت في وضعية طرح المسائل التي تريد وحلها وبالشكل الدرامي الذي تنتهجه وعبر أنماط الإخراج التي تقدمها للوقائع والأحداث. إنها تبني رؤية للعالم بحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو واقعي وما هو خيالي، والتمييز بين العقلاني والانفعالي، والفصل بين الحقيقة وبين ما يتراءى حقيقة، والعزل بين المجال العام والمجال الخاص في الحياة الاجتماعية، والتباين بين الزمن الإعلامي وبين الزمن السياسي.
الكتاب: الخطاب السياسي
الناشر: فويبير ـ باريس 2005
الصفحات: 255 صفحة من القطع المتوسط
LE DISCOURS POLITIQUE
PATRICK CHARAUDEAU
VUIBERT - PARIS 2005
P. 255