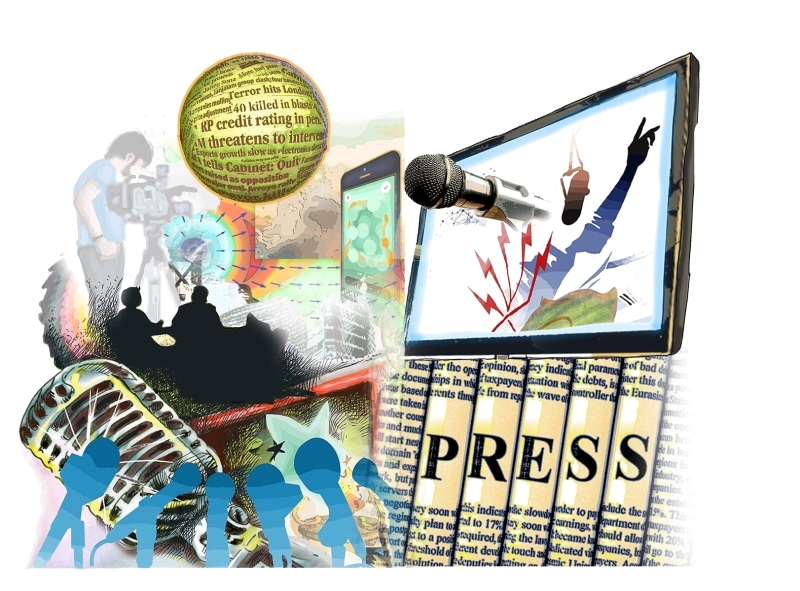منهجيات تضمن استعادة الثقة في أجهزة الإعلام
من السهل في أغلب الصناعات تحديد منتج عالي الجودة، وذلك بفضل علامات مثل السعر، والعلامة التجارية، والمراجعات. ولكن في الصحافة، أصبح تمييز الجودة أمراً معقداً على نحو متزايد، خاصة وأن العلامات التجارية التي تحظى بالثقة، والتي تلتزم بالمعايير الصحافية الراسخة، أصبحت محاطة بعدد أكبر كثيراً من المنشورات المبتدئة، والمدونات، والتقارير المجتمعية.
ليس من المستغرب إذاً أن انتشار المزاعم في السنوات الأخيرة حول «الأخبار المزيفة»، كما حدث في الولايت المتحدة، أن تتراجع الثقة في أجهزة الإعلام الإخبارية الأمريكية - الراسخة والمحدثة. إذ يشير تقرير الأخبار الرقمية لعام 2017 الصادر عن معهد رويترز إلى أن أولئك الذين يستهلكون الأخبار على نحو منتظم باتوا يفعلون هذا بقدر من التشكك.
إذ يثق نحو 50% فقط من المستخدمين في الوسائط الإعلامية التي يختارون استهلاكها؛ وتثق مجموعة أقل كثيراً من المستخدمين بالمنافذ الإعلامية التي لا يستخدمونها. وفي ظل خيارات عديدة توقف ما يقرب من ثلث الناس عن متابعة الأخبار تماماً.
لكن الصحافة الإخبارية ليست تَرَفاً يمكن الاستغناء عنه. إنها منفعة عامة بالغة الأهمية، لأنها تمكن المواطنين من اتخاذ قرارات مستنيرة، في حين تساعد في مساءلة القائمين على السلطة. لكنها من غير الممكن أن تؤدي هذه الوظيفة إلا إذا كانت تقدم منتجاً عالي الجودة ــ والناس يعرفون هذا. بيد أن تسليم مثل هذا المنتج ليس بالمهمة الواضحة المباشرة.
تكمن المشكلة الأولى في عدم وجود تعريف واضح لما يشكل ما يمكن اعتباره صحافة جيدة، مما يزيد من خطر تحول معيار «الجودة» إلى أداة للرقابة. عندما كان هتلر يريد إحراق كتاب ما، فإنه كان يؤكد أنه لم يستوف «معايير» الأيديولوجية النازية. على نحو مماثل، تستطيع أي حكومة اليوم أن تستشهد بقضايا الجودة في مهاجمة مصداقية المنتقدين أو لتبرير حرمانهم من مصداقيتهم الصحافية.
تحاول بعض المنظمات المعنية بمستقبل وسائل الإعلام التحايل على هذا الخطر من خلال تطوير مؤشرات للثقة. وأبرز هذه المحاولات مبادرة الثقة في الصحافة، التي تقودها منظمة مراسلون بلا حدود.
وهي تعمل على وضع مبادئ توجيهية طوعية، فضلاً عن إطار لأفضل الممارسات والذي يُفتَرَض أن يتطور إلى عملية رسمية للتوثيق. وتدعو بعض المنظمات إلى إنشاء مؤشرات مرور ضوئية، كتلك المستخدمة في وضع العلامات على الأغذية، في حين يسوق آخرون الحجج لصالح نظام أيزو 9000 الذي يذكرنا بإدارة الجودة الصناعية.
ولكن ما الذي قد توثقه هذه الأنظمة أو تضمن جودته على وجه التحديد؟ ربما تبدو المنظمات الإعلامية الإجابة الأكثر منطقية. ولكن حتى غرف الأخبار من الدرجة الأولى تنتج قدراً وفيراً من المحتوى من الدرجة الثانية، ويرجع هذا إلى عوامل تتراوح من الافتقار إلى المصادر المتاحة إلى الخطأ البشري البسيط. وهذا يعني ضمناً أن ليس كل المحتوى الذي تخرجه منظمة بعينها يمكن اعتباره جديراً بالثقة.
بطبيعة الحال، تتمتع بعض المؤسسات الإعلامية بسجل مثبت من اتباع إجراءات معينة للحد من الأخطاء والاستجابة لتلك التي تقع رغم ذلك. لكن هذه في الأرجح ذات المؤسسات التي تتمتع بالفعل بقدر كبير من الثقة العامة. وأياً كان المقدار الذي فقدته من الثقة في السنوات الأخيرة، فلن يتم التعويض عن الثقة المفقودة بالاستعانة بشعار جديد يؤكد جودتها.
أما عن المنشورات والمطبوعات التي قد تستفيد من هذا الطابع، فمن المرجح أن تكون أحدث وأصغر حجماً، أي أنها بالتالي غير مجهزة للتعامل مع الطبقة الإضافية من البيروقراطية التي تستتبعها إجراءات التصديق. وعلى هذا فإن توثيق الجودة على مستوى المنظمات قد يلحق الأذى بالوافدين الجدد، في حين يساعد المؤسسات القائمة.
ربما يكون بديل التوثيق على مستوى المؤسسات التركيز على الأجزاء الفردية من المحتوى. لكنها مهمة شاقة للغاية من حيث الحجم؛ الأسوأ من ذلك أنها ربما تخلق حوافز ضارة، حيث يطارد الصحافيون شهادات التوثيق والتصديق بنفس الطريقة التي ربما يلاحقون بها الآن الجوائز، وهو ما قد يضر بالعمل في بعض الأحيان. فقد فاز المراسل الألماني كلاس ريوتيوس بجوائز عديدة عن أسلوبه الرائع في سرد القصص الصحافية قبل أن يُكشَف الغطاء عن حقيقة مفادها أن القصص التي رواها لم تكن حقيقية.
في كل الأحوال، يظل السؤال المطروح هو ماذا يشكل المحتوى مرتفع الجودة على وجه التحديد. هل يجب أن يكون قائما على الحقائق ببساطة؟ هل ينطبق هذا فقط على الأخبار السياسية والتجارية الجادة، أو أنه يشمل أسلوب الحياة، أو الترفيه، أو القصص الإنسانية؟ تزداد هذه التساؤلات تعقيداً في البيئة الرقمية: فربما تشكل بعض المشاركات في المدونات صحافة جيدة، ولكن من المؤكد أن هذه ليست حالها جميعاً.
لن تكون الصحافة أبدا كصناعة الطيران على سبيل المثال، حيث تطبق معايير وإجراءات صارمة على كل حركة وكل منتج. ولكن حتى وقت قريب، لم تكن هناك حاجة لأمر كهذا: إذ التزم العاملون بقواعد السلوك المهني والأخلاقي، وكانوا خاضعين لإشراف هيئات تتخذ إجراءات محددة في حالة حدوث خرق للقواعد. وكان فِعل الصواب هو التصرف المفترض تلقائياً ــ حتى برغم أن مفهوم «الصواب» كان مفتوحاً للتفسير دوماً.
هذه هي الطريقة التي تعمل بها المجتمعات. فالفرد لا يحتاج إلى «شهادة ثقة» للمشاركة في أسرة أو مجتمع. إذ يؤسس العقد الاجتماعي لمجموعة من القواعد السلوكية التي يلتزم بها الناس في عموم الأمر؛ ولا تنشأ الحاجة إلى التمييز باستخدام بطاقة تعريف إلا عندما تنكسر الثقة.
هذا هو الوضع الذي يجب أن يعود إليه الإعلام. وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء ضرورة تحمل المنظمات الفردية المسؤولية عن جودة محتواها والتزامها بمجموعة من القواعد، بما في ذلك الإشراف والتحرير، لضمان هذه الجودة. وعندما يتعذر القيام بذلك داخل المؤسسة ذاتها ــ ولنقل عندما يعمل الصحافي في بيئة معادية للديمقراطية ــ فمن الممكن أن تتولى هيئات خارجية القيام بهذه المهمة.
في إنشاء مثل هذه المؤسسات، يمكن تعلم الدروس من مشاريع التقارير الصحافية التعاونية كتلك التي غطت «أوراق بنما»، حيث كان الباحثون يتمتعون بالحرية الفردية ــ بما يضمن تعدد الأصوات والمنافسة الصحية ــ ولكن كان لزاماً عليهم أن يلبوا معايير معينة. مع تقدم التكنولوجيا، ربما يمكن أيضاً إدخال وسائل آلية لتقصي الحقيقة، وخاصة في غرف الأخبار الأقل تجهيزاً بالموارد.
في عصر يتسم بكم غير مسبوق من القدرة على الوصول إلى المعلومات، سواء كانت صادقة أو غير ذلك، يتعين على الناس من جميع الأعمار أن يعملوا على تحسين معرفتهم بوسائل الإعلام. لكن هذا لا يُعفي المؤسسات الإعلامية من المسؤولية. وبمساعدة جمهور واع وناقد، يتعين على كل منظمة أن تراقب ذاتها، وأن تراقب كل منها الأخرى، كما كانت الحال في الماضي.