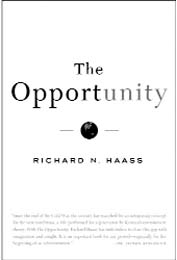في مستهل عرضنا لهذا الكتاب الذي بين أيدينا، نرى لزاماً علينا أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن صاحبه، الذي شغل مناصب مهمة في إدارات أميركية عدة، يعكس في كتابه وجهة نظر أميركية إلى جانب وجهات نظره الخاصة، الأمر الذي يملي علينا مناقشة ما يستحق منها التعليق أو المداخلة أو عرض وجهات نظر أخرى مؤيدة لها أو مختلفة عنها.
ويرأس ريتشارد هاس في الوقت الحاضر منصب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الذي يعتبر المنظمة المستقلة للشؤون الخارجية في العالم. أما قبل ذلك فقد كان المؤلف رئيساً لقسم تخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأميركية وكبير مستشاري كولين باول وزير الخارجية الأميركي. وكان كذلك السفير والمنسق الأميركي في رسم مستقبل أفغانستان،
وتولى قيادة الجهود الرسمية الأميركية في عملية السلام في أيرلندا الشمالية، وفي مرحلة سابقة كان كبير مستشاري الرئيس جورج إتش. دبليو بوش لشؤون الشرق الأوسط، وعمل أيضاً في وزارة خارجية رونالد ريغان، وفي البنتاغون في عهد جيمي كارتر.
ويرسم المؤلف في أول فصول الكتاب الثمانية صورة كئيبة للموقف الحالي في أنحاء العالم حيث أصبح الإرهاب جزءاً من نسيج الحياة الحديثة نعيش معه في أفضل الأحوال، ونموت به في أسوئها، وهو يرى أن السؤال الآن أصبح يدور عن «متى» ستعاني الولايات المتحدة من عمل إرهابي كبير آخر قد يُستخدم فيه سلاح دمار شامل.
يقول هاس إن كوريا الشمالية وإيران حققتا خطوات مهمة في إنتاج مواد نووية انشطارية، وإنتاج أسلحة نووية في حالة كوريا الشمالية. وما زال السلام بعيد المنال بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تغرق نسبة كبيرة من سكان العالم في الفقر، إذ يعيش نحو ثلاثة مليارات شخص على دخل يبلغ دولارين أو أقل في اليوم، وتتفاقم محنتهم بفعل الإيدز والأمراض المعدية الأخرى.
وتعتبر منطقة دارفور الأحدث في طابور المآسي التي تبرز حقيقة أن أكبر خطر يتهدد الناس في أنحاء العالم، ينبع من تصرفات حكوماتهم ومواطنيهم. وقد واجهت الولايات المتحدة صعوبات شاقة أعاقت الاستقرار في أفغانستان والعراق. وقد برهنت حرب العراق بالذات أنها حرب انتقائية باهظة التكاليف، وأثارت جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة والعالم حول السياسة الخارجية الأميركية وكيفية استخدام أميركا لقوتها الهائلة.
ومنذ حرب فيتنام، آخر حرب انتقائية مرهقة خاضتها الولايات المتحدة، لم تكن السياسة الخارجية الأميركية مثار جدل واسع النطاق ولم تتعرض للرفض داخل أميركا أو في الخارج مثلما تتعرض له في الوقت الحاضر.
ورغم ذلك فإن مؤلف الكتاب يرى أنه مازالت هناك «فرصة نادرة» أمام الولايات المتحدة والعالم، وبالعمل مع الحكومات والقوى الكبرى الأخرى تستطيع أميركا تشكيل مسار القرن الحادي والعشرين وإيجاد عالم يتمتع بدرجة مذهلة من السلم والازدهار والحرية من معظم أقطار الكون وشعوبها.
وهذه الفرصة تمثل «الاحتمالية لا الحتمية» الأمر الذي يفسر جزئياً السبب في أننا نعيش في زمن يوصف بأنه زمن ما بعد الحرب الباردة أو ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. ومثل هذه الأوصاف تخبرنا بما كنا عليه، لا بما نحن عليه الآن، ولا بما نحن سائرون إليه.
ولن نعرف اسماً للعصر الحالي إلا بعد أن نرى ما ستفعله الولايات المتحدة والعالم بهذه الفرصة، وقد يتحول إلى عصر مديد من السلام والازدهار، أو إلى عصر انحلال تدريجي يصبح بمثابة عصور وسطى جديدة تنشأ بسبب فقدان السيطرة من جانب الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، وتتسم بانتشار أسلحة الدمار الشامل، والدول الضعيفة، والإرهاب المتنامي، وعدم الاستقرار.
والاحتمال الثالث هو اعتبار هذه الفترة «عصراً ما بين حربين»، أو عصراً «ما بين الحرب الباردة» محصوراً بين نصف قرن من الصراع مع الاتحاد السوفييتي من ناحية، وبين تنافس مماثل آخر بين الولايات المتحدة والصين.
ونلاحظ أن ريتشارد هاس يغفل كثيراً من دول العالم ولا يهتم إلا بدور الولايات المتحدة ونفوذها ثم يُلحق بها القوى الكبرى الأخرى، بل يتحدث صراحة عن تفوق الولايات المتحدة الذي يجب ترجمته بنجاح إلى نفوذ والى ترتيبات دولية فعالة كما يقول.
وفي محاولة المؤلف لتحديد العصر في الفصل الأول من كتابه يشير إلى أنه توجد في قلب الفرصة المتاحة حقيقة معينة هي أننا نعيش في زمن لم تعد الحرب فيه بين الدول أمراً شائعاً مثلما كانت في قرون عدة، كما أن الصراع بين القوى العظمى في هذا العصر أصبح بعيد الاحتمال.
أما القرن العشرون فقد ساده الصراع بين الدول الليبرالية بقيادة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وبين نظم عسكرية مستبدة في ألمانيا واليابان في النصف الأول من القرن، والاتحاد السوفييتي في النصف الأخير منه. وقد تخللت هذا الصراع ثلاث حروب، اثنتان منها ملتهبة، والثالثة باردة لحسن الحظ. وكانت هناك مخاطر ضد الولايات المتحدة وحليفاتها من منافسي القوى العظمى.
ولكن القرن الحادي والعشرين اختلف اختلافاً جوهرياً، فلأول مرة في التاريخ لم ينشأ صراع كلاسيكي بين القوى العظمى في الوقت الحاضر لفرض هيمنتها على حساب بعضها، وهذه القوى هي حالياً الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا واليابان، وربما الهند.
وهناك منافسات قليلة على بعض الأراضي، ولكن الحرب بينها في المستقبل المنظور بعيدة الاحتمال إلى حد كبير، بل وليست محل تفكير في بعض الحالات. ولم يعد هناك حد أيديولوجي فاصل يؤدي إلى تحرش قوة كبرى بأخرى في العالم، ولم يعد هناك بالتأكيد وجه للمقارنة بمحور «الشيوعية في مواجهة العالم الحر» الذي ساد العصر السابق،
وأصبحت حكومات كثيرة تشترك في وجهة نظر واحدة مؤداها أن «قوى جديدة» بما فيها الإرهاب، والمرض، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، أصبحت تشكل أكبر المخاطر على الأمن والاستقرار، وأصبحت القوى العظمى، وجميع الدول المتوسطة والصغيرة، تشارك بنصيب في محاولة الحفاظ على الاستقرار الذي يوفر المسار الضروري للتفاعل الاقتصادي لصالح الجميع.
يضاف إلى ذلك تزايد عدد الدول التي يصح اعتبارها ديمقراطية بشكل كامل أو قريبة من الديمقراطية (وقد تجاوز عددها المئة)، وهي نسبة تعتبر الأعلى في التاريخ، وينطبق الأمر كذلك على اقتصادات السوق.
ويعتبر المؤلف أن كل ذلك يبشر بالخير لا بسبب الحرية والازدهار الإنساني وحده، بل السلام أيضا إذ يرى عدد كبير من العلماء أن الديمقراطيات الرشيدة أقل ميلاً إلى شن الحرب من الدول التي لم تضرب فيها الديمقراطية جذورها في العمق أو التي حرمت من الديمقراطية أصلاً.
قوة عسكرية حاسمة
يرى ريتشارد هاس أن تلك الحالة لم تتحقق بفضل الردع النووي الذي كان يحكم السلام بين القوتين المهيمنتين أثناء الحرب الباردة. ورغم أن الردع يظل فعالاً، إلا أن القوى العظمى في الوقت الحاضر لا تشعر بالقلق إزاء النوايا النووية لدى بعضها البعض.
وبرزت حقيقة أخرى هي أن قوة الولايات المتحدة ـ وخاصة القوة العسكرية ـ أصبحت حاسمة مما لا يشجع أي عدوان مباشر عليها من دولة أخرى. وعلى الدرجة نفسها من الأهمية يجد هاس أن القبول الدولي - أو على الأقل التسامح الدولي - للقوة والأهداف الاميركية، وصل الى درجة عالية، حتى أن القوى الأخرى لم تعد تميل الى مقاومة ما تفعله الولايات المتحدة في أنحاء العالم.
ولم تعد أي من القوى العظمى ترى في أميركا نسخة من ألمانيا القرن التاسع عشر، باعتبارها دولة تطمع في الهيمنة والغزو الاستعماري، ولهذا يجب مواجهتها. ولم تتمتع دولة واحدة عبر التاريخ بمثل هذه القوة الهائلة،
وقليل من الدول أو الامبراطوريات تميز على معاصريه بمثل ما تتميز به الولايات المتحدة اليوم. وهنا يشير صاحب الكتاب الى أن واشنطن تنفق نحو 500 مليار دولار سنوياً على الدفاع، وهو مبلغ يفوق ما تنفقه الصين وروسيا والهند واليابان وجميع الدول الأوروبية مجتمعة.
ويتميز عالم اليوم بتفوق أميركي دراماتيكي وهو ما يسميه هاس: «عدم توازن القوى المتعمد» ذلك لأن الميزة الكمية للقوة العسكرية الأميركية لا تنافسها أية دولة أخرى من حيث سرعة الحركة والدقة والقدرة التدميرية للقوات الأميركية،
ولذلك لا توجد قوة موازنة أخرى. يزيد على ذلك أن الولايات المتحدة تنعم بترف نادر من وجهة نظر صاحب الكتاب، فهي تستطيع أن تركز كل ميزانية الدفاع في الخارج، في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط الكبير، وحتى مع السماح لها بزيادة حادة في الإنفاق على الأمن الداخلي في أعقاب 11 سبتمبر، تنفق واشنطن من 10% إلى 15% فقط من دولاراتها الأمنية على ما يمكن تسميته بالدفاع الذاتي ضد مخاطر خارجية.
ويعود الكتاب الى التاريخ ليذكر لنا أن القوى العظمى كانت تنفق جزءاً كبيراً من مواردها لاتقاء خطر دول مجاورة قوية ومعادية. وعلى العكس من ذلك نجد أن للولايات المتحدة جارتين مباشرتين تمثلان أكبر شريكين تجاريين، ولا وجود لخطر بارز في نصف الكرة الأرضية الغربي. ونتيجة لذلك فهي توجه جانبا كبيرا من مخصصات الأمن القومي لاستخدامه حول العالم.
ولا يكتفي المؤلف بذلك بل إنه يستطرد في سرد نواحي القوة الأخرى غير العسكرية للولايات المتحدة فيقول إنها اقتصادية أيضا إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأميركي أكثر من 11 تريليون دولار، أي أكثر من 20% من الناتج العالمي،
كما يعادل إجمالي الناتج السنوي من السلع والخدمات في جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين مجتمعة، أو تلك الخاصة باليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. ويرتبط الأداء الاقتصادي العالمي ارتباطا وثيقا بأداء الاقتصادي الأميركي.
ويستفيض الكتاب في شرح تفاصيل اقتصادية كثيرة، ثم ينتقل الى الوزن السياسي للولايات المتحدة منذ أربعينات القرن الماضي وتمتعها بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن وحق استخدام الفيتو. أما اليوم فيقول المؤلف إنه في المواقف التي تتراوح من الشرق الأوسط وكوريا الشمالية حتى كولومبيا والسودان،
فإن أميركا هي الغوريلا ثقيلة الوزن ذات الثمانمئة باوند سواء كانت في المكان أو خارجه، وما تختار أن تفعله أو ما لا تفعله يمكن أن تكون له آثاره العميقة. ويضيف المؤلف الى جانب تلك العبارات المتعجرفة عنصرا آخر هو التأثير الثقافي الأميركي الذي يتضمن ما يسميه تأثير الجامعات الأميركية،
وأفلام هوليوود السينمائية والبرامج والأفلام التليفزيونية، ووسائل الإعلام المتمركزة في أميركا، والأفكار المتولدة من خلال المجتمع الأميركي. ويرى المؤلف أنها جميعا عوامل تزيد من النفوذ السياسي الأميركي. ومع ذلك كله يقول إن كل هذه القوى لا تضمن عصرا من السلام الراسخ، ولا تعني نهاية التاريخ ولا تمتع الأميركيين بالأمان،
ومن الممكن أن تبرز تحديات تقليدية في وجه الهيمنة الأميركية، ومن بين التحديات التي تواجهها السياسة الخارجية الأميركية العمل على ضمان ألا يعود التنافس بين القوى الكبرى الى المستوى الذي كان عليه في العصر السابق. ومن سوء الحظ أن الأعوام الخمسة عشر الأولى من عصر ما بعد الحرب الباردة لا تدعو الى التفاؤل.
ويقول ريتشارد هاس: إذا لم تحدث تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الأميركية، فسوف نشهد عالما تسوده سياسة توازن القوى وتنشغل فيه الولايات المتحدة والقوى العظمى الأخرى ببعضها بعضا، وتعجز عن توجيه مواردها إلى مواجهة التحديات الحقيقية للوقت الحاضر الناشئة عن العولمة وعن عدد من الدول المتوسطة والضعيفة.
الكيف والكم
ومع حجم القوة الأميركية الكبير واحتمال دوامه على ذلك الحال، فإن هذه القوة ليست بلا حدود إذ يبلغ عدد الجنود العاملين في الخدمة العسكرية نحو 4 ,1 مليون شخص بعد أن كان مليونين عند نهاية الحرب الباردة.
ورغم أن بعض ذلك التخفيض يمكن أن يعود إلى الإصلاحات التي أدخلت على التكنولوجيا والأساليب التكتيكية التي تجعل من الممكن بالتالي تخفيض عدد القوات دون تخفيض القدرة القتالية، تظل هناك حقيقة باقية وهي أن الكيف لا يمكن أن يكون بديلا عن الكم في جميع الأحوال.
ففي بعض المهام، وخاصة تلك التي لا تتطلب معارك في ميادين قتال مفتوحة، يحتاج الأمر الى كم كبير من الأفراد. ونتيجة لذلك فإن الولايات المتحدة سوف تخضع لضغوط هائلة لمواجهة أزمة في ذروتها في شبه الجزيرة الكورية دون خفض التزاماتها في العراق، أو لمحاولة تكرار ما تفعله في العراق في أي مكان آخر، أو للتدخل على نطاق واسع في بعض الأزمات الإنسانية مثل الحال في دارفور.
كذلك تعاني أميركا ماليا، وبعد أن كانت الحكومة الأميركية تتباهى بتحقيق فائض كبير في الميزانية منذ سنوات قليلة، أصبحت الآن تعاني عجزا ماليا يزيد على 400 مليار دولار سنويا نتيجة للضرائب المنخفضة، وبطء النمو الاقتصادي المأمول، والزيادة الهائلة في الإنفاق.
ويزيد الأمور سوءا وجود عجز في الحساب الجاري، وخاصة في الميزان التجاري، يتجاوز الآن 600 مليار دولار سنويا، وهو رقم يقترب من نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد الاقتصاد الأميركي اعتمادا متزايدا على رغبة الحكومات والمؤسسات الأجنبية في الاحتفاظ بأرصدة ضخمة من الدولارات،
غير أن الموقف الحالي ربما يستمر لبعض الوقت بشرط أن يكون ملائما للمصالح المباشرة لجميع الأطراف، ولكنه لن يستطيع الاستمرار الى ما لا نهاية. وهي مسألة وقت ليس إلا ثم قد يزداد حذر الأجانب، أو تعبهم، من الاستمرار في تكديس الدولارات،
وإذا ما اختاروا بيع جزء منها، أو إبطاء معدل زيادة كميات إضافية منها، يصبح السؤال الوحيد المطروح هو ما إذا كان هبوط قيمة الدولار سوف يحدث تدريجيا مع إمكانية التحكم فيه، أم سيحدث بسرعة بحيث يوقع أضرارا فادحة.
وبعد أن يستعرض الكتاب سبل مواجهة تأثير تلك المشاكل على الناحية العسكرية، يخرج بنتيجة مؤداها أن غالبية الأميركيين ترفض أي قانون بزيادة الضرائب وأن هناك مؤشرات على مقاومة شعبية، ضد الاعتماد الواسع على قوات الاحتياطي واستخدامها.
الدور الامبراطوري
أما النتيجة الأهم من كل ما ذكره هاس واستخرجه من الاعتبارات السابقة، هي أن الديمقراطية الأميركية ليست ملائمة للعب دور امبراطوري. وفي رأي المؤلف أن الشعب الأميركي مستعد للتضحية من أجل حرب مفروضة مكلفة مثل الحرب العالمية الثانية، أو الاشتراك في حروب انتقائية مثل التدخل في البوسنة وكوسوفو، طالما يثبت أنها ليست باهظة التكاليف.
أما الحروب الانتقائية باهظة الثمن - مثلما أثبتت حرب فيتنام، وكما تهدد بذلك حرب العراق - فإنها تتطلب تضحيات متواصلة من أجل نهايات مفتوحة وغير مؤكدة، وهي حروب لا يقبلها الشعب الأميركي. وبالرغم من مظاهر القوة التي يتصورها الكثيرون، يرى مؤلف الكتاب أن أميركا ليست منيعة وأن عوامل ضعفها حقيقية ويعود بعضها الى مخلفات الحرب الباردة وامتلاك روسيا لألف رأس نووية تزيد عما يحتاجه محو الولايات المتحدة.
وهناك أيضا ترسانة الصين النووية الصغيرة والمتنامية. والأدهى من ذلك المخزون الروسي الضخم من المواد النووية، وربما من العناصر والأسلحة البيولوجية والكيميائية، التي قد تنتهي يوما بالوقوع في أيدي دول مثل كوريا الشمالية وإيران، أو جماعات مثل القاعدة على حد قول صاحب الكتاب الذي يرى أيضا أن الإرهابيين قد يستطيعون إيجاد مصدر آخر لأسلحة متطورة،
أو حتى إقامة قاعدتهم الخاصة لأسلحة الدمار الشامل. وبدون هذا كله، قد يستطيع إرهابيو اليوم دخول الولايات المتحدة والتحرك في أنحائها، وإصابتها بدمار يحصد مليارات الدولارات وآلاف الأرواح دون استخدام أسلحة متطورة، كما ثبت ذلك في فجيعة يوم 11 سبتمبر على شاشات التليفزيون في جميع أنحاء أميركا والعالم.
ويصل ريتشارد هاس الى حقيقة تخالف ما يصدقه الكثيرون إذ يقول إن فقدان المناعة الداخلية في أميركا يسلط الأضواء على ضعفها العسكري ذلك لأن الهيمنة على ميادين القتال التقليدية - حيث يمكن الجمع بين القوات البرية والجوية والبحرية المتقدمة - شئ آخر يختلف تماما عن السيطرة على مناطق حضرية مكدسة.
ولا يتلاءم الكثير من المزايا العسكرية الأميركية مع تحدي بناء أمة أو دولة في مواقع مثل أفغانستان والعراق. وقد خرجت حكومات وأشخاص كثيرون بدرس من حرب الخليج 1991 وحربي أفغانستان والعراق مؤداه أن ميدان القتال التقليدي هو المكان الذي لا يجب تحدي الولايات المتحدة فيه، وهنا يبدو الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل البديل المعادل المفضل.
مخاطر التصدع الاقتصادي
وبعد ذلك يعدد الكتاب نواحي الضعف الأميركي الأخرى وفي مقدمتها اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز الطبيعي. ورغم ما نسمعه من الدعاوي التي تطالب بالتوقف عن الاعتماد على النفط مثلما ذكر الرئيس الأميركي بوش مؤخرا، يرى ريتشارد هاس أن الاقتصاديات الأميركية والعالمية تعتمد بشكل أساسي ومتزايد على الوقود الأحفوري،
ولذلك فإن أي قصور في الإمدادات الضرورية من النفط أو الغاز الطبيعي، أو تقلبات أسعارها وارتفاعها الكبير يمكن أن يسبب تصدعا اقتصاديا، ويفجر التضخم، ويدمر النمو الاقتصادي. وتمثل الطاقة أحد مظاهر فقدان الاستقلال الاقتصادي في نظر الكاتب. كذلك تعتمد ملايين الوظائف على القدرة على تصدير البضائع والخدمات ناهيك عن الكم والانتقاء، ولو عادت الحماية التجارية لأصبح لها أثر بالغ على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
يضاف الى ذلك أن استعداد الآخرين للاحتفاظ بمليارات الدولارات يسمح للأميركيين بالاستيراد أكثر مما يصدّرون، وبزيادة الإنفاق الحكومي على مواردها. وإذا أعاد الأجانب النظر في إبقاء أموالهم في أميركا فسوف يؤدي ذلك الى فقدان الوظائف نتيجة الحاجة الى رفع معدلات الفائدة لاجتذاب الدولارات لتمويل ديون الولايات المتحدة، وتشجيع الموارد الاستثمارية.
ويعتبر هاس أن أميركا معرضة أيضا لمخاطر عالمية. ففي عام 2003 انتشر وباء سارس في الصين، مثلما انتشر مرض الإيدز والإنفلونزا قبل ذلك، مما يثبت أن الفيروسات لا تحترم الحدود، فعندما عطس الناس في الصين، أصيبت الولايات المتحدة وكندا بما هو أكثر من نزلات البرد. وتستطيع فيروسات من نوع آخر تصيب الكمبيوتر تدمير المجتمع الحديث.
وهناك أيضا عمليات تهريب المخدرات على نطاق عالمي، وهي تعمل على تلبية الطلب الأميركي مما يجعلها مسؤولة بشكل غير مباشر عن جانب كبير من الجرائم في أميركا. ويتناول المؤلف جانبا آخر من جوانب ما يسميه بضعف المناعة الأميركية،
ويتصل ذلك بالتغيرات الكونية في الطقس وفي رأيه أنه أصبح معروفا على نطاق واسع أن أسلوب استخدام العالم للطاقة يؤدي الى تغيرات في درجة حرارة الغلاف الجوي مما قد يؤدي - في وقت ليس بالبعيد - الى تغيير قدرة المحاصيل الزراعية على النمو، والحياة في المناطق الساحلية.
وهنا لا يشير صاحب الكتاب إلى موقف الإدارة الأميركية الرافض لما أجمع عليه العالم بشأن مواجهة المشاكل البيئية التي تواجهها الكرة الأرضية، وفي مقدمة ذلك رفض الإدارة الأميركية تنفيذ التزاماتها التي ينص عليها بروتوكول كيوتو،
وتنصل الرئيس الأميركي بوش من تلك الالتزامات القانونية والأخلاقية خاصة وأن بلاده مسؤولة عن انبعاث 30% من غازات الاحتباس الحراري رغم أن سكانها لا تتجاوز نسبتهم 5% من سكان العالم.
عرض ومناقشة: صلاح عويس