عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وأنزله الجنة، ذكر أهل التفسير أنه شعر بوحشة رغم ذلك النعيم اللامحدود، فخلق الله له حواء ليسكن إليها، وهكذا بقيت في ذرّيته تلك الحاجة الدائمة لأن يكون أحدهم ضمن مجموعة من الناس وأن يشعر بالانتماء لكيان ما، يألف من يعيش بينهم ويألفونه، ويتناغم الكل مع بعضهم البعض رغم الاختلافات التي قد تكون بينهم، وبالتبعية يكون هناك تناغم أيضاً وإن كان بدرجة أقل مع الجماعات المجاورة، فحصانة كل مجموعة لا تكون بتعلية الجدران ولكن بحسن التواصل والتكامل والتآلف مع الجيران!
يقول مايكل بورتر عرّاب الإدارة الشهير: «جوهر الاستراتيجية أن تحدد ما لا يجب عمله إطلاقاً»، وغالباً ما تكون ردّات الفعل المتسرعة هي أول ما لا يجب عمله أبداً تحت أي مسوّغ، فردة الفعل ليست استراتيجية ولا تُمثّل مستوى تخطيطياً بأي شكل، بل في غالبها لا تعدو أن تكون «تنفيساً» عبثياً تجاه موقف معين لا نستسيغه، ودوماً ما يتلو ذلك التنفيس تداعيات لا تُحمَد عُقباها ولا ينفع في دفعها أو إيقافها أي شرح لاحق أو محاولة للتملّص من ذلك المأزق الذي كان الإنسان المتسرّع بردة فعله في غِنى عنه!
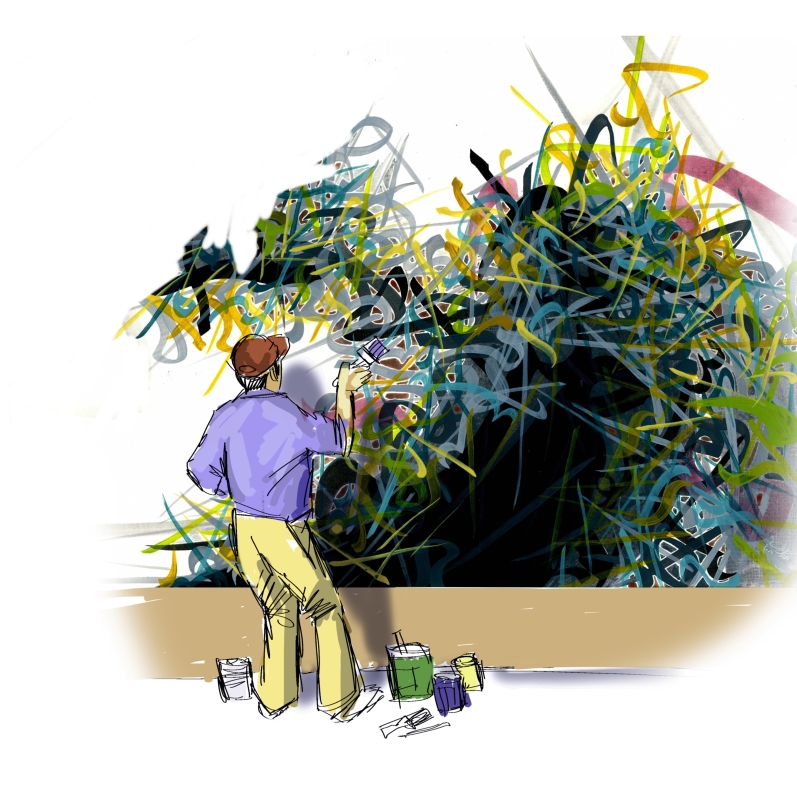
عندما يقول مثلنا الشعبي: «خذ علوم الدار من يهّالها»، فمقصد ذلك أن الصغار أقل حذراً وأكثر تسرّعاً في نقل المعلومة للغريب، فلا تكاد توجد حسبة «جدية» للمكاسب والخسائر فيما يقولون أو ينقلون، بل على العكس فالصغير يرى استماع الكبير له «وَزْناً» يُفاخِر به بين أقرانه ودليلاً بيّناً على كونه ممن يُلْتَفت لهم، حتى لو كان ما ينقله مما يتسبب بنتائج وخيمة، ولن أبتعد عن الحقيقة إن قُلت أن منصات التواصل الاجتماعي قد أعادت إخراج ذلك «الصغير» للواجهة من داخل الكبير، فتغريدة واحدة قد يشتهر صاحبها بسرعة تداول الناس لها، وتنهال ردود المتفاعلين معها ويدخل في «الخطِّ» الساذج الذي يُفسد أكثر مما يصلح، والمترصّد الذي يبحث عن فرصة لإذكاء النيران بين أهل الجدران وبين الجيران، والمتحمس الذي يدخل دوماً وهو على أهبة الاستعداد للعراك نُصرةً للقريب دون أن يعرف سبب العراك أصلاً ولكنها من باب «وقّعت واقف»!
مِن حق كل إنسان أن يؤمن بما يريد، لكن ليس مِن حقه أن يُذيعه على الملأ إن كانت هناك احتمالية ولو ضئيلة بأنه سيعود بأثر سيئ على مجتمعه، فالأمور تُقاس بنتائجها وتُعرف بعواقبها، وإن لم يستطع الإنسان أن يوسّع مساحة أصدقائه بكلامه وسلوكه، فلا أقل من أن لا يعمل أبداً أي تصرّف قد يزيد عدد خصومه، والأسوأ من ذلك أن يُحوّل الصديق عدواً، فَلَن يُحاسبك أحد على ما يكنّه قلبك، ولكن لن يسكت لك أحد إن نطق به فمك ووضح أنك تقصده أو تمس أمراً يحبه أو يُشكّل أهمية له، سواء كان ذاك الذي يُهمه شخصاً أو مؤسسة أو قيمة مجتمعية أو وطناً يُنافِح عنه كما تُنافح عن وطنك!
قد ينسى الناس الكثير من الأحداث السيئة، سينسون خسارة مالية، إقالة من عمل، وفاة عزيز، لكنهم لن ينسوا الإساءة أبداً، وقد أحسن كاتب الأورغواي الراحل إدواردو غاليانو في ذلك بقوله: «حتى حين نعود، نحن لا نعود، شيء منا يرحل للأبد»، ومادام الإنسان في سعة فلا يجب أن يُضيّق عليه مُقبِل أيامه بتصرفات ارتجالية هو في غنى عنها، بل يظهر بعد أول انطباع سوؤها ورداءة ما يعود بها عليه، ولا يجدر بعاقل أن يختار الإساءة إن كان بمقدوره أن لا يفعل، وأن يُبقي وشائج المودة مع الآخرين بدل أن يدفعهم دفعاً لعداوته، وإن أسوأ الناس فعلاً ذاك الذي بدل أن يُبقي على محبيه يجتهد لتحويلهم إلى خصوم!
عندما خرج محمد «صلى الله عليه وسلم» ليلاً ليوصل زوجته صفية ورآه اثنان من الصحابة فأنزلا رأسيهما وأسرعا بالمشي مبتعدين، ناداهما قائلاً: «على رِسْلكما، إنها صفية»، فقالا: «سبحان الله يا رسول الله»، كأنهما استعظما أن يظنّ صلى الله عليه وسلم أنهما يشكّان فيه، فقال مُعلّم البشرية الأعظم: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً»، فلا ترمِ بالكلمة الملتبسة ثم تقول «مش مشكلتي اللي يفهمني غلط»، فأنت في داخلك تعرف أنها ستعود بأثر سيئ من فئة ما، وكما لا تقبل بالإساءة لك أو لمجتمعك، فكذلك غيرك لا يقبل، ومَن أساء للصديق ماذا أبقى لرد العدو!
* كاتب إماراتي
