الوعــظ.. أدب يعـزف على وتـر النصـح والإرشاد
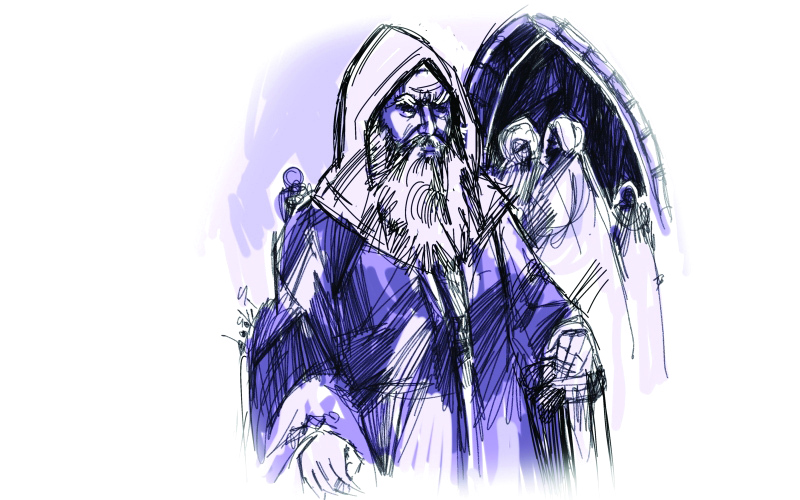
انفتحت الثقافة العربية على أشكال أدبية متنوعة، مثَّلت مساحات حرَّة للتعبير الإبداعي، ومع ذلك، ظل الشعر ديوان العرب وفنَّهم الأول، الذي حفظ لغتهم وخلَّد أخبارهم وبصمتهم الثقافية المميزة، فكان ولا يزال مسرحاً يُظهرون فيه قدراتهم البلاغية المتفاوتة، وبراعاتهم التصويرية المدهشة. وفي هذا الشهر المبارك، تصطحب «البيان» قارئها إلى عوالم نصوص شعرية، خاصة، ترتسم فيها روعة البلاغة لنحلق معها في فضاء البيان الأدبي.
الإنسان مشتق من النسيان، يعيش في الدنيا الآيلة إلى الزوال، مدركاً تمام الإدراك أن سفره فيها عمَّا قريب سينقضي، وأن أيام إقامته في ربوعها متى طالت سيقترب آخرها، لكنَّ تلك الحقيقة التي لا ينتابه فيها شكٌّ، تظل تتضاءل في نظره كلما انغمر في مشاغل الحياة؛ لذا كان لزاماً أن يبقى ناقوسٌ يدقُّ في عالم نسيانه على الدوام، ناقوس اسمه الوعظ.
يتكئ الأدب في أكثر جوانبه على أساليب تعبيرية غير مباشرة، تُحدث في وجدان المتلقي روعة بيانية، ولا يخفى أن الوعظ من القضايا التي جرى العُرف أن تؤدى بألفاظ واضحة وتراكيب مباشرة، ما يجعله من الناحية النظرية هو والأدب على طرفي نقيض، ومع هذا كلِّه، أفلح فريق من شعرائنا العرب في اقتحام موضوع الوعظ في نصوص بديعة راقية، من خلال المواءمة بين ضرورة الأسلوب الخطابي الذي يتم به النصح والهداية، وبين ما يقتضيه الإبداع الشعري من قدرة فنية يقوم بها العمل البليغ، وتفنَّن كل شاعر منهم في صناعة حيلة فنية تكون هي الركيزة الأسلوبية بحيث لا يحدث التنافر المقيت بين عناصر القصيدة.
لعل القصيدة التي تنسبها الدواوين إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، تحت عنوان «القصيدة الزينبية»، ومطلعها:
صرمَتْ حبالَكَ بَعْدَ وصلِكَ زينبُ
والدَّهرُ فيهِ تصرُّمٌ وتقلُّبُ
هي أوضح مثال على هذا التناغم في الصياغة؛ إذ لا تخلو من أفعال الأمر (دعْ، ازهدْ، اذكرْ، اخشَ)، التي تحدِّد مسار النص ضمن التوجيه وإملاء التعليمات الواجبة على العبد المسلم في دنياه، لينجو من غرور النفس ويفوز بالنعيم المقيم في الدار الآخرة، لكنها خلال ذلك ترسم صوراً رائعة من الخيال، تعوِّض جفاف الموقف، وتبعث فيه روحاً شاعرية مشرقة، لتأخذ بيد المتلقي إلى الاسترسال ومتابعة القراءة، وحينها يتحقق التوازن التعبيري، فيحصُل الوعظُ، ولا تختفي طبيعة الشعر من المشهد الإبداعي:
فدعِ الصِّبا فلقد عداكَ زمانُهُ
وازهدْ فعُمرُكَ منهُ ولَّى الأطيبُ
ذهبَ الشَّبابُ فما لهُ مِنْ عودةٍ
وأتى المشيبُ فأينَ منهُ المهربُ؟
ضيفٌ ألمَّ إليكَ لمْ تحفلْ بهِ
فترى لهُ أسفاً ودمعاً يُسكبُ
دعْ عنكَ ما قدْ فاتَ في زمنِ الصِّبا
واذكُرْ ذنوبَكَ وابْكِها يا مُذنِبُ
واخشَ مناقشةَ الحسابِ فإنَّهُ
لا بدَّ يُحصى ما جنيتَ ويُكتبُ
لمْ ينسَهُ الْـمَلَكانِ حينَ نسيتَهُ
بلْ أثبتاهُ وأنتَ لاهٍ تلعبُ
وبحيلة فنية أخرى، ضمن نص شعري ينتمي إلى عصر مختلف، يمنح أبو إسحاق الإلبيري الأيام والساعات صفة حسية، فيجعلها كالريح التي تعصف بالأجسام فتنحتها حتى تأكل أطرافها، ويُنطق الموتَ، فيعطيه رهبة موحشة، كأنه يتعقَّب الأحياء مصرّاً على الفتك بهم، ويصنع صورة للدنيا، تتألف ملامحها من الغدر، كل ذلك في لغة خطابية لا تُفسد شيئاً من العناصر الإبداعية السابقة، فتبدو القصيدة لوحة فنية متآلفة:
تَفُتُّ فؤادَكَ الأيَّامُ فتَّا
وتنْحِتُ جسمَكَ السَّاعاتُ نحْتا
وتدعوكَ الْـمَنُونُ دعاءَ صدقٍ:
ألا يا صاحِ، أنتَ أريدُ، أنْتا