استراتيجية تكثيف العدوان لحجب الضعف القاتل
قد تحظى الضرائب التجارية بالنصيب الأكبر من الاهتمام، لكن في حقيقة الأمر، تشمل الحرب التجارية مجالات متعددة، بما في ذلك معدلات الصرف، والتكنولوجيا والإنترنت.
بل حتى مجال الأسلحة. وهذا ليس مؤشراً إيجابياً بالنسبة لقدرة العالم على مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الهجرة وتغير المناخ. وحسب بوب وودوورد، عميد صَحَفِيِّي واشنطن.
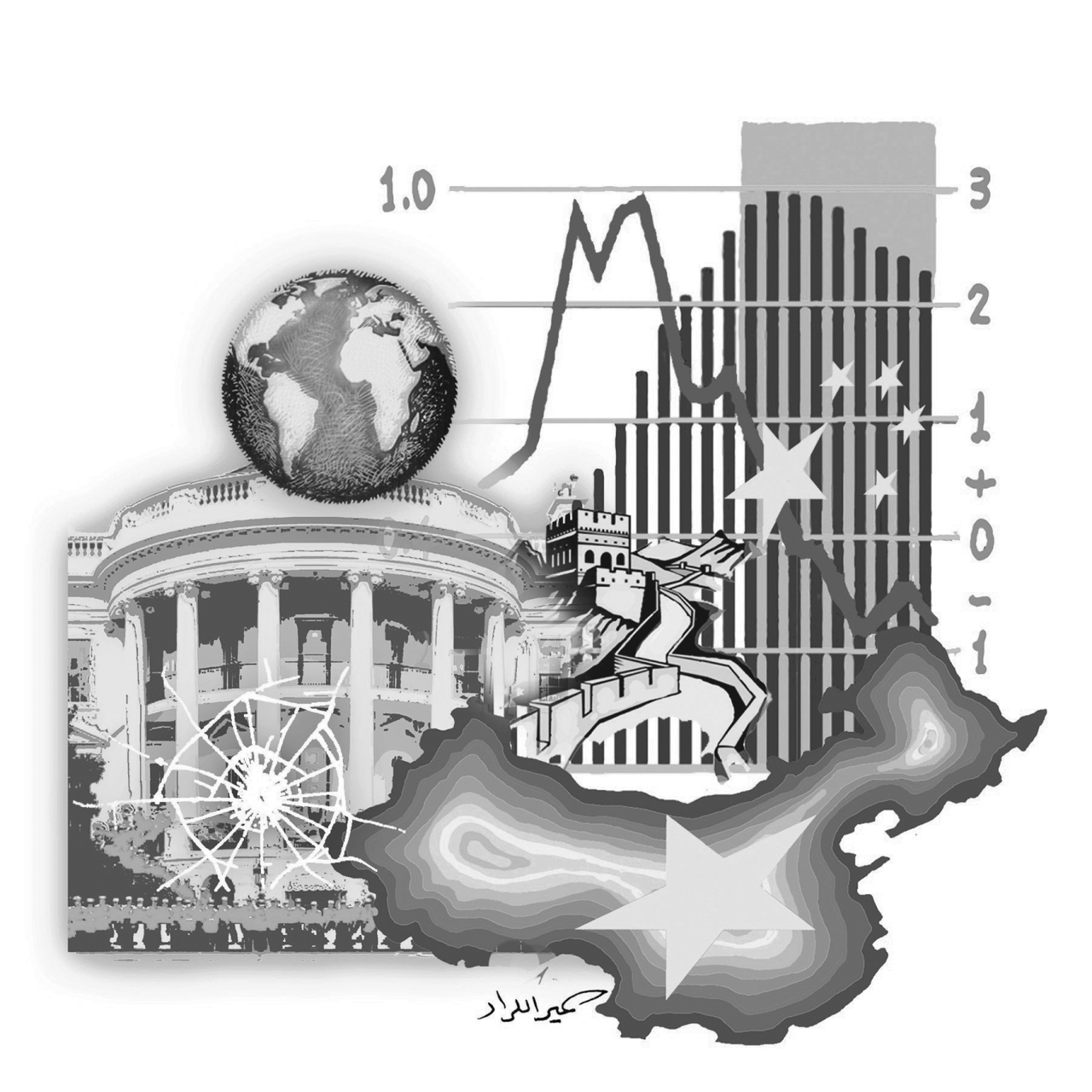
فإن أسلوب عمل الإدارة الأميركية هو «تكثيف العدوان، لحجب الضعف القاتل». وبالفعل، عندما يتعلق الأمر بالصين، تراهن الإدارة على أن النبرة العدائية، المعززة بالتهديدات والمؤثرة، سَتُحَول الانتباه من المشكلات المحلية الخطيرة قبل الانتخابات النصفية لشهر نوفمبر الجاري.
وتتناقض هذه النظرة الاستراتيجية بشدة مع اللعبة طويلة الأمد التي تلعبها السلطات الصينية. ورغم أن المؤشر المركب لشانغهاي تراجع بنسبة أكثر من مؤشر داو جونز، بالغاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014، فإن الصين تحافظ كثيراً على عملة رنمينبي من الهبوط لدرجة أن الولايات المتحدة الأميركية لقبتها بالبلد المتحكم في العملة.
وفي الوقت نفسه، تعمل الصين من أجل حماية اقتصادها من الظروف الخارجية القاسية، حيث إنها تخطط للانتقال إلى نموذج تنموي أكثر ابتكاراً وشمولاً واستدامة. وللنهوض بهذه الجهود، ضم القادة الصينيون القطاع الخاص، الذي يشكل.
كما أقر بذلك أخيراً نائب رئيس الوزراء ليو هي، 50% من مداخيل الضرائب، و60% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من الابتكار التكنولوجي و80% من التشغيل الحضري و90% من الوظائف الجديدة والشركات.
ويبدو أن المسؤولين الصينيين أدركوا أخيراً أنه إن لم ينته المطاف بالصين إلى حرب كاملة تهدد أمنها القومي، فإنها لا تمتلك إلا القليل من الأسباب تبرر بها دعمها المالي للشركات التابعة للدولة على حساب الشركات الخاصة.
وفيما يتعلق بوضع حد لكل ما من شأنه أن يزيد من عدم الاستقرار، اعتمدت الصين برنامجاً مناسباً. والمشكل هو أن العديد من الدول ترى أن المشكلات القومية - على سبيل المثال بريكسيت في بريطانيا - تتناقض مع القضايا العالمية المُلِحَّة، وبعد عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي، أصبحت الدول متداخلة مع بعضها البعض أكثر مما سبق. وأصبحت القرارات السياسية تؤخذ في بلد له تأثير واسع المدى.
وفي هذه الظروف، لا تستطيع أي دولة معالجة التحديات الرئيسية لاسيما تغير المناخ وتزايد اللا مساواة والتكنولوجيا المزعجة لوحدها. ومع ذلك، وبالتحديد في وقت أصبح فيه العالم يحتاج للتعاون أكثر من أي وقت مضى، انسحبت الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير من الساحة السياسية الدولية.
ومن المؤكد أنه رغم أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس المزيد من القيادة العالمية، فإن التحول القائم من عالم أحادي القطب إلى آخر متعدد الأقطاب سيستمر. وهذا التوجه ناتج جزئياً عن الديموغرافيا: الدول المتقدمة تشيخ بسرعة بينما آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لديها ساكنة شابة تنمو بسرعة وتزيد ثراءً، بفضل ديناميكيتها الكبيرة والتنافس الكبير على الموارد.
لكن ميول الإدارة الأميركية نحو الحمائية والاستراتيجيات قصيرة الأمد، تجعل الأمور أسوأ. فعلى سبيل المثال، لم تزد استراتيجية خفض الضرائب على الشركات والأثرياء من اللا مساواة فقط داخل أميركا، بل أدت أيضاً إلى سباق عالمي من شأنه أن يضعف الاستدامة المالية ويزيد من اللا مساواة عبر العالم.
ورغم أننا نفهم عدم رغبة الولايات المتحدة الأميركية دفع فاتورة أمن حلفائها، فإن أسلوبها في إقناع حلفائها في الناتو بالإنفاق أكثر على الدفاع ليس عاملاً مساعداً. بل على العكس، فبالإضافة إلى إضعاف العلاقات مع الحلفاء المقربين لأميركا، زادت استراتيجيات ترامب من التوتر مع روسيا، وبالتالي الزيادة في تكلفة ما يسميه الخبراء الاقتصاديون «الأسعار الوهمية» للأمن القومي.
ثم هناك بالطبع، السياسات التجارية للإدارة الأميركية، التي ستفعل أكثر من «معاقبة» الصين. إذ ركزت سياسة إلغاء القيود على خفض تكاليف المعاملات في التجارة العالمية والاستثمار وتدفق المعلومات.
ومن خلال منع الصين من الدخول إلى عالم التكنولوجيا، بحجة الأمن القومي، ترفع الإدارة من قيمة هذه التكاليف ليس فقط على الصين، بل حتى على الدول الأخرى التي تحاول الاستعانة بالتجارة والتكنولوجيا للنهوض بالنمو والتنمية.
إذاً بعد عقود من التفتح المتزايد والعولمة، أصبح العالم في طريقه نحو الانكسار. وهذا من شأنه أن يضعف التجارة العالمية بشكل كبير، وبالتالي إضعاف إمكانات نمو الاقتصادات، وفي الوقت نفسه منع العالم من مواجهة التحديات المشتركة.
وفي واقع الأمر، يمكنه أيضاً أن يزيد من هذه التحديات: مثلاً، من المحتمل أن يؤدي الدمار الإيكولوجي وندرة الموارد الناتجان عن تغير المناخ إلى الصراع وعدم الاستقرار، مما سيشجع على المزيد من الهجرة.
وقد تظن الإدارة الأميركية أن استراتيجيتها مع الصين تنتهي في وضع «أميركا أولاً». لكن سياساتها لن تضر الصين فقط، بل حتى الولايات المتحدة الأميركية، دون ذكر باقي دول العالم. والطريقة الوحيدة لتفادي انعكاسات سلبية على المستوى العالمي، هي تغيير مسار الأحداث، مع استرجاع التعاون مع الصين الذي يصب في مصلحة كلا الطرفين، خاصة أن الصين نشرت تقريراً حكومياً رسمياً لدعم هذا الهدف بالضبط.
ويدرك القادة الصينيون أنه بعد عقود من العولمة، أصبحت الدول ملتفة كثيراً من خلال سلاسل التوريد وشبكات المعرفة، وبالتالي فهي لا تستطيع الانعزال عن غيرها من الدول. ويعلمون أيضاً أنه من مصلحة الدول أن لا تحاول ذلك.
بل يأملون الاستمرار في تعميق علاقاتهم مع المجتمع الدولي، ليس بصفتهم مزعجين، بل بصفتهم أصحاب مصالح مسؤولين وملتزمين بدعم الاستقرار العالمي. وينبغي على الولايات المتحدة الأميركية القيام بالشيء نفسه.
* زميل مميز في المعهد العالمي لآسيا في جامعة هونغ كونغ وعضو في المجلس الاستشاري ليونيب المعني بالمالية المستدامة.
** رئيس مؤسسة هونغ كونغ للمالية الدولية، أستاذ في كلية HSBC للتجارة في جامعة بكين وفي كلية التجارة وعلوم الاقتصاد في جامعة هونغ كونغ.

