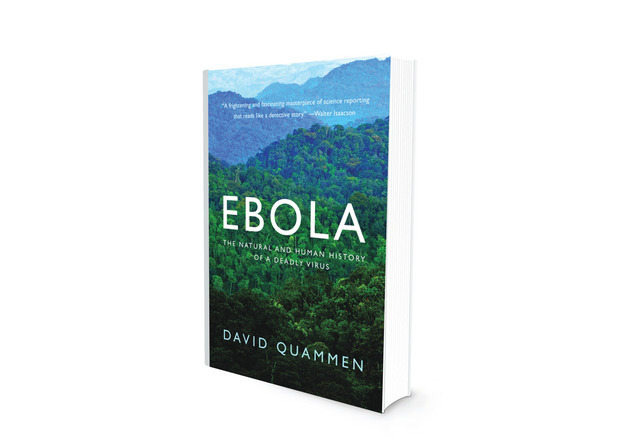"إيبولا" كتاب يصفه النقاد بأنه دراسة موجزة ومكثفة عمد المؤلف إلى إصدارها على أساس كتاب سبق المؤلف إلى إصداره منذ عامين في موضوع انتقال الأمراض من فصائل الحيوان إلى بني البشر.
وإذ يتناول الكتاب – كما يتضح من عنوانه المباشر- وباء الإيبولا الذي انتشر، كما أصبح معروفاً- في أكثر من قُطر في منطقة غرب أفريقيا، فإنه يعرض بقدر لافت من التفصيل إلى أهمية الوعي بظاهرة انتقال الإصابة إلى الإنسان من حيوانات تتعايش حاليا في غابات وأحراش وأدغال الغرب الأفريقي، ومنها على وجه الخصوص خفّاش الفاكهة كما يسمونه الذي تمارس جحافله وأسرابه أنماط التنقل والهجرة وطبعاً ملامسة البشر في تلك الأصقاع حاملة فيروس الإيبولا.
وهو الحمى النزفية التي لم يفلح العلم بشكل حاسم حتى الآن في تدارس أسبابها وأعراضها وسبل علاجها والوقاية منها، وهو ما أصبح يفرض – كما يوضح هذا الكتاب – ضرورة العمل على احتواء حالات الإصابة بهذا الوباء الخطير- من خلال إجراءات العزْل الصارمة وبما يحمي الآخرين وفي مقدمتهم اختصاصيو العلاج والعاملون الصحيون بطبيعة الحال.
وفي هذا السياق أيضاً يعرض الكتاب لاقتراحات مستجدة منها مثلاً العمل على استخدام الروبوت في تقديم جانب من خدمات التمريض والرعاية، مما يقي البشر مغبة انتقال العدوى، فيما يذهب الكتاب إلى عدم جدوى إغلاق الحدود مفضلاً بطبيعة الحال إحكام وتدقيق إجراءات العزل والاحتواء.
كان ذلك عند منتصف القرن الرابع عشر، وبالتحديد على مدار السنوات الأربع الفاصلة بين عامي 1347 و 1350 للميلاد هي الفترة العصيبة التي شهدت اجتياح فيروس الطاعون الرهيب لكل أنحاء القارة الأوروبية من أقصاها إلى أقصاها، حتى ليُعرف هذا الوباء في سجلات التاريخ باسمه الخطير: الطاعون الأسود.
وكان عبارة عن وباء سريع العدوى يتفشى بين جموع السكان على شكل إصابات باﻠفيروسات الصدرية والالتهابات الرئوية التي تدمر الجهاز التنفسي عند البشر، وتؤدي من ثم إلى نهاية الحياة.
يقول المؤرخون إن هذا الوباء منقول عن جحافل جيوش التتار التي كانت قد اجتاحت قبيل تلك الفترة أصقاع شبه جزيرة القرم الفاصلة بين آسيا وأوروبا.
والمعنى أن هذه الآفات من الأمراض المعدية التي تنشر غلالاتها السوداء، وبشكل فادح الخطورة على الأقطار والأمصار، إنما تشكل منعطفات لا تُنسى في تاريخ الحياة البشرية على ظهر كوكبنا، بقدر ما أنها تخلّف آثارها السلبية على أرواح البشر وعلى مسير الحضارة وعلى مصائر هذا الكوكب بشكل عام.
أعراض المرض الخطير
يحرص مؤلفنا من ناحية أخرى على أن يسجل أن علم الطب لم يوفَّق حتى الآن إلى تحديد مؤكد لمدى خطورة الإيبولا، اللهم إلا تسجيل عوارض الإصابة بالوباء المذكور، ومنها ما يتمثل في الفشل الكَبدي والفشل الكلوي وصعوبات التنفس، واضطرابات الجهاز الهضمي.
مع ذلك يكاد قارئ هذا الكتاب يشعر أنه لا يطالع كتاباً من إعداد صحافي علمي جاد ومتمرس، ولكنه يكاد يطالع إحدى روايات الرعب- البوليسية كما يسمونها، خاصة وأن مؤلفنا يوافي القارئ بمعلومات وتحقيقات من المواقع الميدانية التي اجتاحها هذا الوباء وبسبل انتقال العدوى- ديناميات الانتقال كما تسميها الناقدة ميتشو كاكوتاني (نيويورك تايمز، عدد 22/10/2014) فضلاً عن أحاديث عن الطرق الواقعية الممكنة لالتماس العلاج.
في هذا السياق يحدثنا المؤلف عن حيوان بعينه يكاد العلماء يشيرون إليه بالذات بإصبع الاتهام: الحيوان هو خفّاش الفاكهة الذي يعيش بالذات في أصقاع وسط وغرب القارة الأفريقية.
وخطورة هذا الأمر تتمثل في أن كائن الخفّاش لا يزال أوسع الثدييات انتشاراً وأقدمها وجوداً على سطح كوكب الأرض وقد تطورت فصائله على مدار الخمسين مليون سنة من وجودها على سطح الأرض فضلاً عن عاداتها في الهجرة والحركة والنزوح باستمرار، وعبر مساحات تصل إلى نحو ألف كيلو متر مربع بين فصل الصيف ومواسم الشتاء.
وهو ما زاد – كما تقول سطور كتابنا- من احتمال اقترابها وربما ملامستها لحياة البشر بكل ما تحمله من فيروسات وهو ما أصبح العلماء الاختصاصيون يطلقون عليه المصطلح التالي: زونوسس، وينصرف إلى معنى المرض الذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوان.
الحصار وضرورة الاحتواء
عند هذا المنعطف من مقولات الكتاب يحيل المؤلف إلى دراسة منشورة أخيرا (أغسطس 2014) في المجلة العلمية الأميركية تؤكد أن الإيبولا هو المرض الأسوأ في تاريخ البشر، وأن هذا اﻠفيروس لا يلبث أن يتغير باستمرار، بل ويتكاثر في حال انتقاله بالعدوى من كائن بشري إلى كائن بشري آخر، وهو ما يتطلب جهوداً، لا لمعالجة المرض بقدر ما يقتضي المبادرة إلى بذل جهود واسعة وحثيثة من أجل محاصرته واحتوائه والحيلولة من ثم دون انتشاره وتفشيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
في السياق نفسه ترتبط مقولات كتابنا بالنهج المستحدث الذي بات موضع اهتمام الاختصاصيين من حيث مكافحة الإيبولا وما في حكمه من الأوبئة البالغة الخطورة: إنه نهج استخدام الروبوت من أجل جهود الإنقاذ والعلاج والاحتواء والمكافحة ضد إصابات وانتشار جائحة الإيبولا.
حيث يستطيع الروبوت أن يقوم بوظائف قد تكون بسيطة – مثل نقل النفايات من مواقع العلاج أو رشّ المبيدات أو حمل المصابين، إلخ- بدلاً من البشر الذين قد يتعرضون للعدوى فيزيد بذلك عدد المصابين.
وهنا أيضاً يوضح كتابنا أن استخدام الروبوت أمر لا يزال بحاجة إلى توعية أو تمهيد ثقافي بالدرجة الأولى، فلم يصل الأمر مثلاً إلى موافقة أهل المريض – مهما كانت حالته – إلى تَرْكه لكي تعتني به آلة صناعية أو تقوم على خدمة احتياجاته الخصوصية أو الحميمة.
في كل حال نلاحظ – كما أسلفنا- أن مؤلفنا بكل خبرته التقنية والميدانية- يحرص على وضع مقولات الكتاب ضمن منظور موضوعي لا يتوخى منطق التهويل على نحو ما فعلت أدبيات وكتابات سابقة، بقدر ما أن الكتاب يؤكد، أهمية محاصرة وباء الإيبولا.
وخاصة في المواقع الأساسية التي اندلعت منها شرارته الأولى: ما بين ليبيريا وسيراليون وغينيا وجاراتهما في منطقة غرب أفريقيا، فضلاً عن تشديد جهود الفحص والمتابعة بالنسبة للمسافرين من تلك المناطق إلى خارجها في سائر أنحاء العالم.
يناقش مؤلف كتابنا تلك الدعوات غير الموضوعية وغير الواقعية، في رأيه، إذ تطالب بإغلاق جميع مطارات أميركا بوجه الطائرات والمسافرين القادمين من خارج الحدود، يؤكد أهمية احتواء المرض وتشديد إجراءات العزل، ولكنه عزل الحالات المصابة فقط دون اللجوء إلى منطق التعميم أو التوسيع.
وفي هذا الخصوص يستخدم المؤلف مهارته الصحافية، حين يمضي قائلاً بمنطق التهكم الساخر: نعم فنلمض إلى إغلاق حدودنا أمام القادمين من غرب أفريقيا على نحو ما تنادي به بعض الأصوات، والأفضل أن نغلق ليبيريا نفسها، حتى لا يخرج من مجالها الجوي طائرات على الإطلاق.
مسؤولية أميركا إزاء ليبيريا
والإشارة هنا تومئ – في تصورنا- إلى أن ثمة مسؤولية لا تزال تتحملها الولايات المتحدة تجاه دولة وكيان ليبيريا بالذات في منطقة غرب أفريقيا: إنها أقدم دول أفريقيا من حيث الاستقلال في عام 1847، ويرجع تاريخ إنشائها كدولة إلى الجمعية الكولونيل الأميركية التي دخلت في مفاوضات في مطالع القرن التاسع عشر مع حكام غرب أفريقيا المحليين من أجل إعادة توطين العبيد السابقين من أميركا إلى قارة أفريقيا بعد إجراءات عتقهم وتحريرهم من ربقة الاسترقاق التي ظلوا يرسفون فيها مع أسلافهم منذ أيام نقل الأفارقة من ساحل القارة الغربي إلى أصقاع العالم الجديد الذي حمل اسم الولايات المتحدة خلال عقود عديدة من القرن الثامن عشر.
ومن يومها ظلت واشنطن تولي اهتماماً خاصاً إلى فريتاون عاصمة ليبيريا، واسمها كما يبدو من إيقاعه مشتق بدوره من معنى الحرية والأحرار. على أساس هذه الخلفية التاريخية التي ما برحت ماثلة بالطبع في الذاكرة المعاصرة.
مشكلات إغلاق الحدود
من هنا يؤكد مؤلفنا في كتابه أهمية إجراءات العزل شريطة أن ينطبق على عزل الحالة، بمعنى عزل الفرد المصاب بعيداً عن سائر المخالطين، وخاصة في حالات ظهور أعراض المرض واحتمالات العدوى، وهو ما يقتضي بالضرورة وجود عيادات ومبان وإمكانات متخصصة ومعنية بهذه الإجراءات اللازم اتخاذها، ومن هذه الإمكانات – وخاصة في ضوء ظروف غرب أفريقيا- ما يمكن أن يشمل.
كما تضيف سطور هذا الكتاب – خيام الإقامة وأقنعة الوقاية وقفازات الفحص وأحذية المطاط ومعدات التنظيف والتطهير والملابس الواقية المتخصصة، لاسيما وأن فيروس الإيبولا يتصف في الأساس بأنه يتخلل المواد السائلة في طريقه إلى بدن الضحية.
ثم هناك مساحات الغابات الكثيفة وأراضي أشجار السافانا المترامية الأطراف في غرب أفريقيا، حيث يمكن نصْب نقاط تفتيش تحول دون فوضى التنقل والتجوال بما يؤدي إلى توسع انتشار الوباء، ولكن دون أن يتحول الأمر في تلك الأصقاع – وكما يحذر مؤلفنا أيضاً – إلى عمليات شبه عسكرية تؤذي مشاعر مواطني تلك المناطق وتستثير لديهم أحاسيس من الغضب وجرْح الكرامة إلى حد ليس بالقليل.
ثم إن إغلاق بلد بأكمله معناه أن حدوده المغلقة لن تكون في حالة تسمح بتيسير وصول معدات المعالجة وعناصر الإنقاذ اللازم توافرها بالسرعة اللازمة، سواء من أقطار العالم الخارجي أو من جانب المؤسسات والأطراف الدولية المتخصصة والمسؤولة عن توفير سبل الوقاية وطرائق العلاج، وفي مقدمتها بطبيعة الحال منظمة الصحة العالمية.
وهنا يحيل كتابنا إلى تصريحات مهمة أدلى بها في هذا الخصوص الدكتور توم فريدن مدير مركز المكافحة والوقاية من الأمراض وقال فيها: إذا حاولنا إغلاق الحدود بشكل تام.
فذلك أمر غير عملي، بل سوف ترتد آثاره السلبية علينا، فالعالم أصبح مترابطاً بشكل غير مسبوق. ومن ثم فالسبيل الوحيد لحماية أنفسنا ووقاية كل أحبائنا من الإصابة ﺒفيروس الإيبولا إنما يتمثل في دعم جميع الجهود المبذولة نحو الوصول بهذا الوباء إلى نهايته في منطقة غرب أفريقيا.
أخيراً، يؤكد مؤلف الكتاب على أهمية متابعة وتدارس أحوال المرض، وخاصة إصابات حيوانات الغابة، مثل الغوريلا والشمبانزي، مضيفاً أن الوباء امتد أيضاً إلى البشر بعد أن اندفعوا بغير روية إلى اجتياح الغابات أو غزو الأدغال، التي ظلت موئلاً لتلك الحيوانات على مر التاريخ، مركّزاً في ذلك على محور انتقال المرض من الحيوان إلى البشر.
وموضحاً كيف أن التاريخ الحديث – بل القريب- شهد وفاة 50 مليون نسمة في عام 1918 بسبب وباء الأنفلونزا ورحيل أكثر من 30 مليون إنسان بسبب مرض الإيدز وكان هذا كله نتيجة انتقال الوباء – كما ألمحنا – من الحيوان إلى الإنسان.
المؤلف في سطور
دﻳفيد كوامن كاتب اختصاصي في مجال ما يوصف بأنه الصحافة العلمية، وهذا مبحث ما زالت تهتم به الدوريات الأميركية وخاصة ما يتعلق بالعمل على توضيح وتبسيط المفاهيم والمعارف العلمية لصالح توعية الجمهور العريض، فضلاً عن تثقيفه بأبعاد تلك القضايا التي تقدمها كبريات الصحف الأميركية بشكل مستساغ في ملاحقها الأسبوعية.
يبلغ المؤلف من العمر 66 عاماً، وهو من مواليد ولاية أوهايو في أميركا. وقد تلقى تعليمه في اثنتين من أهم جامعات العالم وهما: جامعة اكسفورد في إنجلترا ثم جامعة يال في الولايات المتحدة. و أصدر حتى الآن 15 كتاباً منها خمس روايات.
هكذا تكلمت "نيويورك تايمز"
لقد تم وصف إيبولا في أفلام الرعب بأنه "إحدى الويلات التي أصابت البشرية" ، وهو مشابه لمرض الطاعون الذي قتل الملايين في الأزمنة القديمة، ويقتل ضحاياه بصورة مؤلمة وسريعة.
وقد وصف كوامين في كتابه الواقع المخيف لهذا الوباء الغامض، وعاد بنا إلى أول حالة مسجلة للإصابة بالمرض في عام 1976، وتحدث في الكتاب عن الجهود العلمية والطبية المبذولة لفهم هذا الوباء. وكما فعل في كتب التاريخ الطبيعي الأخرى التي ألفها، جمع كوامين بين التقارير التي تتحدث عن المرض والمقابلات التي أجريت بشأنه لتوفير فهم متعمق للوباء.
أخطر ما في الوباء انتقاله من الحيوان إلى الإنسان
يتابع عالمنا تطورات وباء الإيبولا، الذي أطل برأسه المخيف الخطير على حياة وسكان عالمنا، ومن الاختصاصيين من يصفه بأنه وباء الحمي النزيفية الذي يكاد يضاهي في خطورته الإصابة ﺒفيروس نقص المناعة البشرية (اتش آي في) المقترن – كما هو معروف- بغائلة متلازمة نقص المناعة المكتسب المعروف عموماً باسم الإيدز.
ولهذا كله تأتي أهمية الكتاب الذي نلقي عليه الأضواء في هذه السطور، خاصة وأنه من تأليف كاتب اختصاصي في الأدبيات العلمية – الطبية.
صدر الكتاب تحت عنوان رئيسي من كلمة واحدة لا خلاف عليها وهي: "الإيبولا". وجاء العنوان الفرعي الشارح بالطبع على النحو التالي: التاريخ الطبيعي والبشري ﻠفيروس فتّاك.
الكتاب من تأليف دﻳفيد كوامن، الذي يتميز بين أقرانه من كتّاب الصحافة العلمية بأنه يجمع في دراساته وإصداراته بين التحليل العلمي- المكتبي كما قد نسميه، وبين بذل جهود واسعة وحثيثة في تجميع المادة العلمية من مواقعها وعلى مستوى الميدان.
هنالك لا يتورع مؤلفنا عن استهلال صفحات الكتاب على إيقاع نغمة تحذير، بل هي نغمة إنذار، حين يقول في سطور هذا الاستهلال بأن معدل الوفاة بعد الإصابة بالإيبولا يصل إلى نسبة 90 في المائة حيث اﻠفيروس يقتل ضحاياه بصورة مؤلمة وسريعة. من هنا يقرن المحللون بين جائحة الإيبولا وبين خيالات كاتب الرعب الشهير في الأدب الأميركي المعاصر إدغار آلان بو حين عرض لوباء مماثل اختار له بو وصف الموت الأحمر.
على أننا نتعامل مع محتويات وتوجّهات كتابنا من منظور مستجد حرص المؤلف تسليط الأضواء عليه: وهو المنظور الذي يذهب إلى تأكيد خطورة انتقال الوباء من الحيوان إلى الإنسان.
والحق أن مؤلفنا ألزم نفسه بالمنهج العلمي والسرد الموضوعي بغير دراما التهويل وإثارة التضخيم على نحو ما قد يفعل كثيرون – وخاصة بعد أن كتب سابقوه (ريتشارد برستون مثلاً، في كتابه الصادر عام 1994 بعنوان المنطقة الساخنة وفيه يصور بريستون مرضى الإيبولا بأنهم يبكون دماً لأن أعضاءهم تتحلل وتذوي وهم طريحو الفراش، إلخ).
عدد الصفحات: 110 صفحات
الناشر: مؤسسة نورتون آند كومباني، نيويورك، 2014