أمام اللبنانيين فرصة مهمة الآن لاستمرار حراكهم الشعبي المعبّر عن غضبهم وعن مطالبهم من خلال التمسك بحق التظاهر السلمي، لكن من دون إقفالٍ للطرق أو أي ممارسات تُعطّل الحياة اليومية للناس أو تعتدي على الأملاك العامة والخاصة.
وهناك تجربتان للحراك الشعبي المؤثر ممكن الاستفادة منهما لبنانياً، ففي الجزائر وفي فرنسا جرى اختيار يوم عطلة الأسبوع للتعبير عن حجم الغضب الشعبي من خلال ممارسة حق التظاهر السلمي، وكان لهاتين التجربتين تأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في هذين البلدين.
لقد أصبح معلوماً ما الذي حرّك الشارع اللبناني بأسره، لكن السؤال الآن: ما الذي سيوقف حركته؟ وعلى أي أسسٍ أو حدٍ أدنى من المطالب الشعبية؟! فالتجمعات والمظاهرات الشعبية الضخمة في عموم المناطق حصلت، وما زالت، بشكل عفوي ومن دون مرجعية قيادية واحدة، وهذا أمر إيجابي مهم يُعبّر عن مدى اشتراك كل اللبنانيين بالهموم ووحدة المصائب، لكن الوجه الآخر لهذا الأمر هو صعوبة التوافق على برنامج واحد للمطالب الشعبية وسقوفها العليا أو الأهداف المنشود تحقيقها الآن، إضافة إلى أنّ ذلك يفسح المجال لقوى سياسية عدة من أجل توظيف هذا الغضب الشعبي لصالح أجندات سياسية خاصة.
لذلك، فإنّ من المهم الآن إنتاج «هيئة تنسيق» بين قوى المجتمع المدني اللبناني، وأيضاً مع الأشخاص الفاعلين في الحراك الشعبي، من أجل التوافق على برنامج عمل يُحدد المطالب المرحلية وكذا الأهداف الكبرى المنشودة (كإلغاء الطائفية السياسية)، إضافة إلى التوافق على أساليب التحرك الشعبي وزمانه الدوري الأسبوعي وأمكنته الشاملة لكل لبنان وضمانات سلميته وعدم القبول بأي شعارات أو هتافات فئوية والاكتفاء برفع العلم اللبناني كتعبير عن وحدة اللبنانيين.
ففي تحقيق ذلك، تتوفر عناصر نجاح الحراك الشعبي اللبناني من حيث سلامة القيادة والأهداف والأسلوب.
ما يحصل في لبنان اليوم مهم طبعاً بما قد ينتج عنه من إصلاحات ضرورية لحياة الناس، لكن الأهم من ذلك كلّه أنّ شباب لبنان وشعبه يصيغون الآن، ولأول مرة في تاريخ بلدهم، المعنى الحقيقي للهوية الوطنية اللبنانية التي تتجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
فوحدة المصائب أفرزت الآن وحدة وطنية شعبية حقيقية لم يعرفها لبنان من قبل.
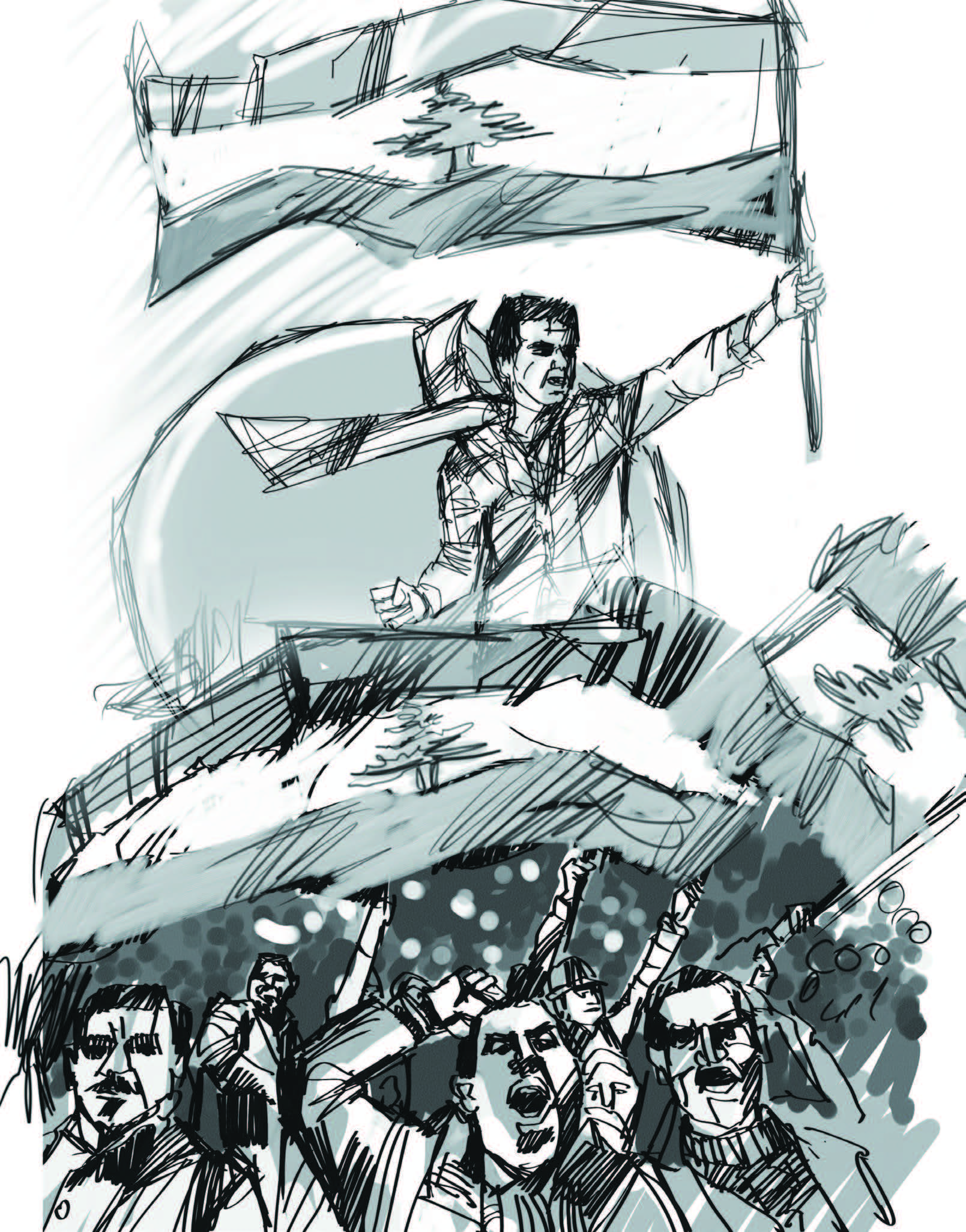
ولعلّها مصادفة زمنية أن لبنان هو الآن عشية الذكرى المئوية لولادته على يد المستعمر الفرنسي «الجنرال غورو» الذي أعلن قيام «دولة لبنان الكبير» في العام 1920 بعدما جرى تفكيك «الدولة العثمانية» ووضع «سوريا الكبرى» تحت الانتداب الفرنسي بقرار من «عصبة الأمم» في نهاية الأولى، ففي الأول من شهر سبتمبر 1920 أعلن الجنرال غورو تقسيم سوريا إلى دول عدة، ومنها «دولة لبنان الكبير» جاعلاً بيروت عاصمة لها.
ووُصفت الدولة الجديدة باسم «لبنان الكبير» على أساس إضافة مدن الساحل والبقاع وطرابلس والجنوب وسهل عكار إلى المنطقة الجبلية التي عرفت تاريخياً باسم «متصرفية جبل لبنان» الذاتية الحكم، والتي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ عصر النظام السياسي الطائفي في لبنان، وبدأت أيضاً مشكلة «الهوية الوطنية اللبنانية».
فالمستعمر الفرنسي، الذي تحرر منه لبنان في منتصف حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، كان مسؤولاً عن صناعة «أزمة النظام الطائفي»، وعن حدوث «مشكلة الهُوية»، من خلال ما قام به من تقسيم لأراضي «سوريا الكبرى»، حيث رفض العديد من سكان المناطق التي اُلحقت بمنطقة جبل لبنان هذا التفكيك، كما رفضوا المشاركة في إحصاء السكان الذي أشرفت عليه فرنسا، والذي بناءً عليه جرى صياغة النظام السياسي الطائفي في لبنان المستمر حتى اليوم!
وما حصل في الأيام الماضية من حراك شعبي لبناني كبير أثبت أنّ اللبنانيين قادرون على تجاوز آثار مائة سنة من مشكلتي: الطائفية والهوية، فهم خالفوا كل الزعامات السياسية الطائفية وصرخوا بصوت واحد: «الشعب يريد تغيير النظام»، لكن «النظام» هنا ليس عبارة عن أشخاص بل هو هذه المحاصصة السياسية التي تجري على أسسٍ طائفية ومذهبية ومناطقية.
فلماذا تُمارَس الديمقراطية في لبنان فقط من خلال التوريث السياسي القائم على الحصص الطائفية والمذهبية؟ ثمّ لماذا «تنتقل البندقية من كتفٍ إلى كتف» على جسم هذا الزعيم أو ذاك، وتتغيّر تحالفاته الإقليمية والدولية، لكن لا يجوز عنده تغيير النظام السياسي الطائفي؟ أليس حال كهذا هو المسؤول عن الاستقواء بالخارج كلّما دعت الضرورة؟ ألا يجعل هذا الأمر من لبنان مزرعة لا وطناً؟ ويحوّل الناس من شعبٍ إلى قطيع يُساس ثمّ يُذبَح عند الحاجة؟! أوَليس ذلك هو السبب الأول لكثرة التدخّل الإقليمي والدولي في الساحة اللبنانية؟ فعطب الدّاخل هو الذي سهّل دائماً تدخّل الخارج، وبإصلاحه تتعطّل فاعلية التأثيرات السلبية الخارجية، وبذلك أيضاً ينتقل لبنان من حال المزرعة والقطيع إلى لبنان الوطن والمواطنة.
هي فرصة مهمة الآن للبنان الوطن من أجل إعادة بنائه من جديد ولترسيخ مفهوم المواطنة السليمة التي لا تميز على أساس طائفي أو مذهبي أو مناطقي.
فهذا التوحد اللبناني في الشارع يجب أن يكون مقدمة لتغيير مفاهيم وعادات وتقاليد أقامت الحواجز والسدود بين المواطنين، وحيث كانت الأجيال اللبنانية تتوارثها كما كان المستفيدون من النظام الطائفي يتوارثونه.
لا قيمة فعلية ودائمة لأي مطالب أو إصلاحات اقتصادية الآن ما لم يتمّ التخلي عن النظام الطائفي في لبنان.
ولا إجماع على «هوية وطنية لبنانية» يمكن الافتخار والاعتزاز بها ما لم تسقط الطائفية السياسية في لبنان. فهي علاقة جدلية بين وحدة المواطنين وبين وحدة الوطن، بين «كلنا للوطن» وبين «الوطن لنا كلّنا»، بين «مشكلة النظام» وبين «أزمة الهُوية».
فمائة سنة كافية لإزالة آثار المستعمر الفرنسي ومخلفاته السياسية والثقافية!
