جائزة محمد زفزاف للرواية العربية بعثت في نفسه الأمل
حسونة المصباحي: أعيش بعيداً عن المافيات الثقافية
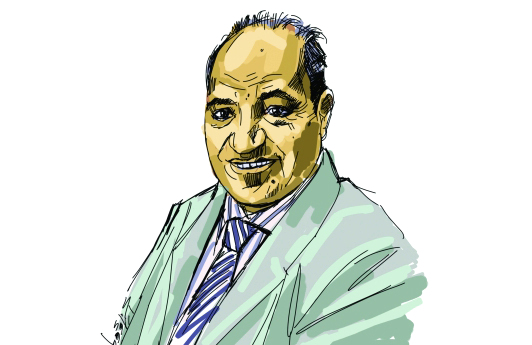
حسونة المصباحي
الحديث مع الروائي التونسي حسونة المصباحي، له نكهة خاصة، فإلى كونه روائياً وقاصاً، هو زميل في مهنة الصحافة، لذا تحسّ خلال الجلوس معه بدفء الحوار وشفافيته.
اللقاء مع المصباحي جاء إثر تسلمه جائزة «محمد زفزاف للرواية العربية» في دورتها السادسة، خلال حفل ختام موسم أصيلة الثقافي الدولي الثامن والثلاثين قبل أسبوعين في مدينة أصيلة شمال المغرب. واختارت لجنة التحكيم المصباحي، لما تمثله كتاباته من تجربة فنية استثنائية، وحساسية سردية فريدة في حقل الكتابة الروائية العربية.
وبالمناسبة ذاتها، أصدر منتدى أصيلة كتاباً بعنوان «حسونة المصباحي: سردية الهامش والمنـــفى»، أعده الناقد المغربي شرف الدين ماجدولين ورئيس لجنة التحكيم.
في جلسة بمقهى مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، أبحرنا في عوالم المصباحي المتنوعة بين القصة والرواية وكتابة السيرة والعمل في الصحافة التي تحدث عنها بشغف المهني المحترف.
خيبات المبدعين
بداية، ما كان شعورك وأنت تتسلم جائزة محمد زفزاف للرواية العربية، و كيف تنظر إلى هذه اللحظة في مسيرتك؟
أنا سعيد جداً لأنني أكرّم بتسليمي جائزة الروائي الراحل، وهو صديق عزيز تعرفت عليه عندما زرت المغرب في أوائل الثمانينيات، واستمرت صداقتنا حتى وفاته، وقد زرته في باريس حيث كان يعالج من مرض خبيث. وغني عن القول إن محمد زفزاف شكل منعرجاً في الكتابة المغربية، هو من الرواد في كتابة القصة واستحداث تقنيات جديدة في فن السرد الروائي.
إنه من جيل محمد شكري وإدريس الخوري وغيرهما من الرواد المغاربة، لذا تغمرني الغبطة بأن أحصل على جائزة تحمل اسمه، وجاءت في فترة أشعر فيها بالخيبة مما أصاب بلدي، حيث الأوضاع سيئة جداً خصوصاً في المجال الأدبي، نعيش أزمة كبيرة، إذ أن هناك عدد كبير من المثقفين قضوا في السنوات الأخيرة بالسكتات القلبية والأمراض الخبيثة من جراء هذه الإحباطات..
شعراء يعيشون المرارات ويموتون أمام أعيننا جراء الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وكثيرون منهم منكفئون على أنفسهم، لا يستطيعون أن يقدموا ما لديهم في المجال الإبداعي.. وعندما تأتيني هذه الجائزة في مثل هذه الظروف العسيرة، لا يسعني إلا أن أفرح بها، لأنها تبعث فيّ شعوراً بالأمل.
كيف رأيت توصيف لجنة التحكيم لتجربتك لدى منحك الجائزة؟
كان توصيفاً رائعاً، لأنه كان ملماً بتجربتي الروائية ومناخاتي المختلفة في الكتابة، إذ لا يقتصر اشتغالي على نوع محدد من الأدب، فأنا أكتب التحقيقات الأدبية من خلال مهنتي الصحافية..
وأكتب السيرة، ومنها سيرة بورقيبة الذي كان أكثر الكتب مبيعاً في تونس لدى صدوره عام 2012. وسيرة القديس أغسطين، كما كتبت القصة القصيرة والدراسات النقدية عن العديد من الشعراء والمبدعين العرب والأجانب، وتناولت المناخ الريفي والخاص وسيرة جيلي في أعمالي القصصية والروائية.
سلاح القلم
أنت مستغرق منذ 40 عاماً في عالم الكتابة، وما الذي تمثله في حياتك؟
هي مصدر للاستمرار في الحياة، فقد عشت في المنفى الاختياري في ميونيخ بألمانيا، وأناضل من أجل الحصول على خبزي اليومي..
لا سلاح مادي لدي ولا دخل إلا قلمي، وستجعلني هذه الجائزة أطمئن إلى حد ما لمواصلة الكتابة والقراءة والوحدة، فأنا إنسان أعيش الوحدة بعيداً عن الحلقات الأدبية والملل وما يسمى بالمافيات الثقافية.. وأتمسك بوحدتي وقلمي الذي دأبت عليه منذ أربعين عاماً.
مسيرة حافلة
شعلة البداية، كيف تصفها، ومن أي الهواجس أتيت إلى الكتابة؟
بدأت مسيرتي الأدبية بمجموعة قصصية بعنوان «حكاية جنون ابنة عمي هنية» وهي عن الريف وأجوائه في القيروان، حيث أنحدر من تلك البيئة، التي جعلتني شغوفاً بالكتابة عن الخاص في العيش.. ثم كتبت عن سيرة جيلي في «هلوسات ترشيش» أولى رواياتي، وجيلي هو جيل السبعينيات الذي كان يسارياً ومتعاطفاً مع قضايا الشعوب..
لكن شيئاً فشيئاً بدأت الأحلام تنهار، وأنا من ضمن الذين شعروا أن كل الذي عشناه كان أوهاماً بأوهام.. لذلك تخليت عن العمل السياسي ووجدت في الكتابة والقراءة والفن ملاذي وملجئي.. لأنني كنت مريضاً بالإيديولوجيات التي هي مجرد وهم، لأنك فجأة تستيقظ وتجد أن كل ما حلمت به كان سراباً ومجرد نظريات.
علاج روحي
كانت الكتابة إذاً بمثابة علاج للروح المنكسرة والنفس المحبطة؟
كتبت روايتي «هلوسات ترشيش» عن جيلي الضائع، جيل الأوهام والأحلام المنكسرة.. كانت علاجاً روحياً بكل ما للكلمة من معنى، وهي الأولى التي تؤرخ لذلك الجيل ومعاناته.. وقراءة الواقع التونسي عن كثب..
فقد أشرت فيها إلى تراجع وانكسارات اليساريين وصعود المتشددين، ثم كتبت «الآخرون» التي تتحدث عن ناس يعيشون في منافي عدة ويروون عذاباتهم وهم على أرصفة المدن. ثم كتبت «وداعاً روزالي» وهي رواية تخيلية ولدت فكرتها في طنجة عن ذلك الذي يعيش بين الشرق والغرب، يقول البطل وهو في عرض البحر: «في النهاية، أرى أن الشرق طردني وأن الغرب يرفضني».. إنه معلق بين الـ«هنا وهناك».
وحدتي تحميني
تقول إنك تعيش الوحدة بينما أنت غارق في أوضاع البلاد، برؤيتك وأفكارك، ألا يشكل ذلك تناقضاً مع ما قلته في إجابة سابقة؟
لا يتناقض أبداً، قلت إنني أعيش بعيداً عن الحلقات والملل الثقافية، وليس الناس والواقع.. فأنا أعيش في قلب الواقع، ويومياً أحس بنبضات هذا الواقع كما أحس بنبضات قلبي، وأنا حين أسافر في تونس أتنقل بوسائل النقل العام أسمع الناس وأدخل الأسواق..
ووحدتي تحميني، فأنا أسمع أرى وأحس وأحلل ما يجري بنفسي.. بعيداً عن تأثيرات الأحزاب والتنظيمات والمثقفين السلبيين الذين أخشاهم.
الصحافة والأدب
أخيراً، بين القصة والرواية والتحقيق الصحافي والسيرة، أين تجد قدرتك في التعبير أكثر، وتوصل رؤاك بشكل جليّ، وما الذي يترك أثره في طقوسك الحياتية والإبداعية؟
أجد نفسي في كل هذه المجالات، وأرى أن الصحافة أفادتني كثيراً، كتّاب كبار اعترفوا أنهم يعملون في الصحف، ماركيز وفارغاس يوسا وغيرهم من الكتاب الأجانب والعرب كانوا صحافيين.. الصحافة تجعلك تطوّع اللغة أكثر.. تصبح اللغة ممارسة يومية، وليس كالأكاديمي الذي يتعامل معها كأنها شيء مغلق عليه في خزانة.. في الصحافة، اللغة تصبح حبيبتك التي لا يمكنك الابتعاد عنها..
من خلال التحقيقات اكتشفت عوالم جديدة قرّبتني من الواقع، اكتشفت العالم ومناخات أخرى.. وأنا معجب بالسينما لذا ترى الصورة والمشهد المرئي في روايتي.. وأجمل أوقاتي أمضيها في مشاهدة الأفلام ومتأثر بالكثير منها. السينما وكذلك المسرح والموسيقى تعادل تأثير الكتب في نفسي..
كان صديقي الكاتب الراحل محمد شكري يقول لي: «إذا لم أسمع الموسيقى أخرج عن طوري».. وأنا أيضاً، خلال غربتي الألمانية، كنت أحن إلى بلدي وأستمع إلى «المالوف» التونسي الشعبي وأغنيات الرواد، وتنهمر الدموع من عيني، ولست أدري لماذا!
جائزة
تعد جائزة «محمد زفزاف للرواية العربية» إحدى أهم الجوائز العربية، التي تمنحها مؤسسة منتدى أصيلة كل سنتين خلال موسم أصيلة الثقافي الدولي، والمصباحي هو الفائز السادس بها، بعد الطيب صالح، وإبراهيم الكوني، ومبارك ربيع، وحنا مينة، وسحر خليفة، وهي أسماء تنتمي إلى أجيال وتجارب سردية مختلفة، وإلى بلدان عربية تغطي المشرق والمغرب العربيين.
سيرة
حسونة المصباحي روائي وقاص ومترجم وصحافي من مواليد قرية الذهبيات في ريف القيروان عام 1950. صدرت له: «حكاية جنون ابنة عمي هنية»- (1986)، «هلوسات ترشيش»- (1995)، «ليلة الغرباء»- (1997)، «السلحفاة»- (1997)، «الآخرون»- (1998)،«وداعاً روزالي»- (2001)، «نوارة الدفلى» - (2004)، «حكاية تونسية»- (2008)،«يوميات ميونيخ 2001- 2004»- (2008)، «يتيم الدهر»- (2012).
«أشواك وياسمين».. عودة إلى التاريخ لرؤية مرارة الواقع
تعكس أحداث رواية حسونة المصباحي «أشواك وياسمين» التي صدرت عام 2015، مراحل مختلفة من تاريخ تونس، ولكنها جاءت في أجواء تداعيات ما حدث بعد انهيار نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
يقول مؤلف الرواية: الفساد لم يكن مقتصراً على فترة حكم بن علي أو بورقيبة أو غيرهما فهو متأصل في التاريخ التونسي.. كل الناس اعتبروا أن الحقبة تلك هي الوحيدة، بينما عدت إلى التاريخ، لأنني أعتبر الكاتب ضمير شعبه، وعليه أن يكشف المخبوء والمتستر عنه. ويضيف: كثيرون ظنوا أن سقوط بن علي هو ثورة الحرية والكرامة والياسمين..
ولم يكن ذلك دقيقاً، وبدأ الحماس ينهار.. وبدأت الأشواك تظهر: العنف، السلفية، الإحباط والانهيار الاقتصادي جعل الناس ينظرون إلى الواقع بعين الريبة والإحباط، قلت للناس انتبهوا أن هناك الأشواك إلى جانب الياسمين.. كان عليهم أن ينتظروا طويلاً قبل أن يحصلوا على الياسمين. كان سقوط نظام وليس ثورة، واستغلته أحزاب من مختلف الأشكال، وخصوصاً الإسلاميين واليساريين».
في «أشواك وياسمين»، يعود المصباحي إلى التاريخ، لكي يقول إن الفساد، الذي قامت الاحتجاجات ضده لم يقع فقط في عهد بن علي، بل في فترات مختلفة من تاريخ تونس أيام الاحتلال الفرنسي وما تلاه من استبداد وفساد وتطرف ديني.
وظّف المصباحي السياق التاريخي بأسلوب فريد بتقديم صورة مفصلة عن تونس، وقرأ تاريخ بلده انطلاقاً من الأحداث، التي أسقطت نظام بن علي، ليفصّل ويكشف ما هو مجهول عبر شخصيات وأحداث..
بينما اعتمد على تقنية خاصة، إذ راح يكتب الرواية خلال تنقله بين عواصم وبلدان، تونس وألمانيا وبراغ ولوس أنجليس، حيث أقام هناك في العام 2012. في كل واحد من هذه الأمكنة، كتب المصباحي فصلاً حتى يعرف القارئ أين هو وكيف ينظر إلى الأحداث.
تقنية تتحدى التكرار
زار المصباحي الدار البيضاء، وتخيّل ظهور البوعزيزي، الذي كان سبباً في هذه الانتفاضة بعدما أحرق نفسه، ليحكي قصة حياته الأخرى، لافتاً إلى أنه عندما فعل بنفسه ما فعل لم يفكر في القيام بثورة ضد النظام، وإنما كان يومها في حالة غضب وأضرم النار في جسده.
وفي لوس أنجليس، روى عن الفتن الدينية، مشيراً إلى المكان، الذي كتب منه. ومن خلال هذه التقنية في الكتابة، أراد الكاتب أن يتحدى النماذج المكررة، التي نجدها في أغلب الروايات العربية، إذ ليس مهماً فقط الأحداث المرويّة، بل ينبغي التركيز على اللغة والتقنية والبنية.
في رواية «أشواك وياسمين» ثمة شيء أساسي، فرغم كثرة الأحداث والأمكنة والتنقل بين الأزمنة، لا يمل القارئ، لعلها خاصية التشويق في السرد الروائي.