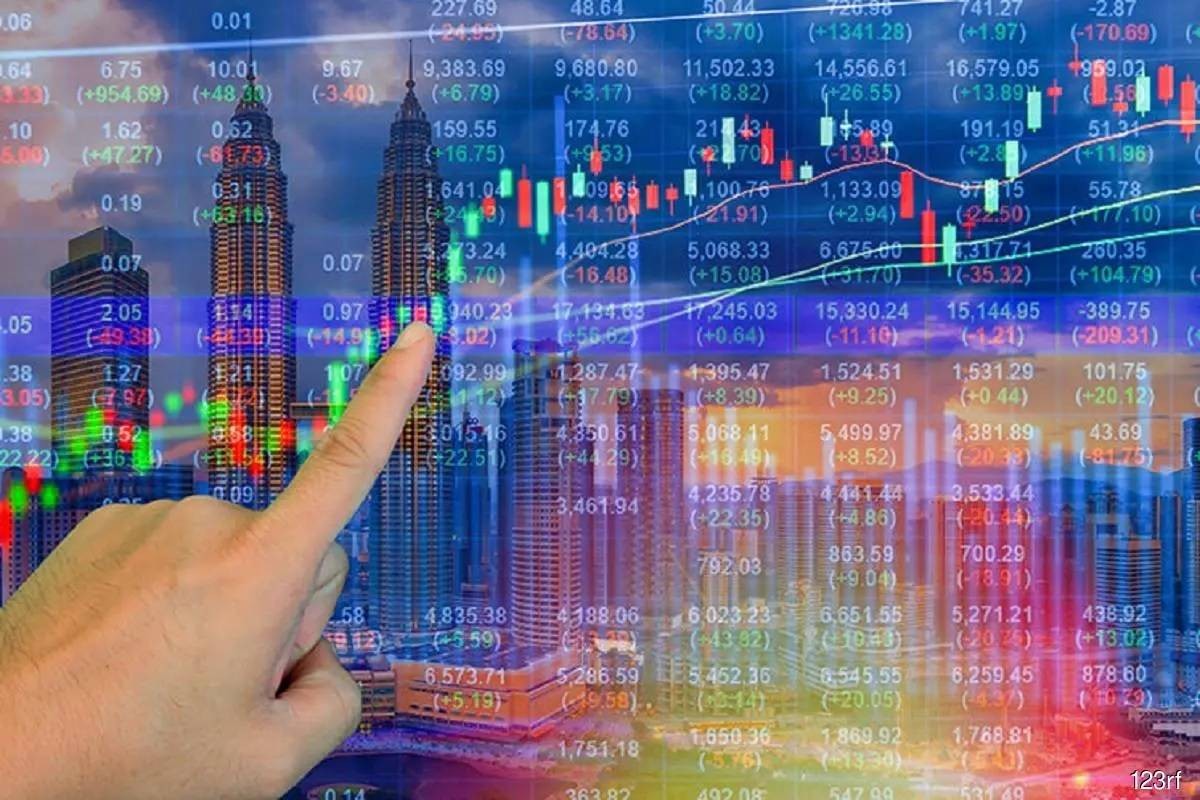يعد علم الاقتصاد واحداً من أكثر التخصصات التي نالت نصيبها من التآكل تحت وطأة الموجة الشعبوية المتصاعدة، وما رافقها من انعدام ثقة متزايد بالخبراء الأكاديميين والنخب الممسكة بزمام القرار. وفي الولايات المتحدة، وتحديداً منذ عودة دونالد ترامب للرئاسة، جرى تقويض الركائز التقليدية لاقتصاد السوق الحر، التي ظل هذا العلم يروج لها لعقود طويلة، لصالح تحول حاد نحو سياسات الحماية، ورأسمالية الدولة، والتدخل المباشر في مؤسسات اقتصادية مستقلة مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
والمشكلة أن الولايات المتحدة ليست حالة فريدة، إذ يتكرر المشهد ذاته في أنحاء مختلفة من العالم، حيث يكتفي خبراء الاقتصاد بالتعبير عن امتعاضهم من رفض المجتمعات لأكثر قناعاتهم رسوخاً، من فضائل الاندماج في الاقتصاد العالمي والانضباط المالي إلى ضرورة انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بمسارها، وهنا يبرز السؤال: لماذا تراجع نفوذ الاقتصاديين إلى هذا الحد؟
لطالما اعتمدت الأحكام والتوقعات الاقتصادية على تبسيطات لتفسير العلاقات السببية، وأهمها الافتراض المعروف بـ«بقاء العوامل الأخرى ثابتة». وخلال ما سُمي بـ«مرحلة الاعتدال العظيم» في العقود التي سبقت الأزمة المالية العالمية، بدا هذا الافتراض مقبولاً إلى حد كبير، إذ أسهمت السياسات المستقرة، الموالية للأسواق والمنفتحة على العالم، في كبح التقلبات الاقتصادية الكلية. لكن ذلك الاستقرار تلاشى، وأصبحت التوقعات التي تفترض ثبات الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية عُرضة للتقادم السريع.
ويزداد الأمر تعقيداً مع اتساع دور الدولة في إدارة الاقتصاد وتزايد الضغوط على النظام الدولي القائم على القواعد، ما يجعل رسم السياسات أصعب على التنبؤ. وقد قفز «مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية» أخيراً إلى مستوى قياسي منذ بدء تسجيل بياناته عام 1997.
وفي بيئة كهذه، يسهل تقويض التوقعات المستندة إلى علاقات اقتصادية مثبتة بالأدلة، فمثلاً، النظرية القائلة إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار المحلية قد تُفرغ من مضمونها إذا قرر رئيس متقلب المزاج تأجيل تطبيقها أو منح إعفاءات. كما أن الثقة بالبنوك المركزية يمكن أن تتزعزع بفعل سياسات مالية متقلبة تغير مسار التضخم مراراً.
ويبرع الاقتصاديون في العادة في معالجة القضايا الدورية القصيرة الأجل، لكن النظام الاقتصادي العالمي يواجه اليوم تحولات هيكلية كبرى. والتوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ تعيد رسم العلاقة بين الحكومات ومؤسساتها الوطنية. والتكنولوجيا تعيد صياغة أنماط التفاعل بين الدولة والأعمال والمجتمع، أما القطاع المالي فمستمر في التغير والتطور.
وقد مر أكثر من 15 عاماً على السؤال الشهير للملكة إليزابيث خلال زيارتها لمدرسة لندن للاقتصاد بشأن الأزمة المالية العالمية: «لماذا لم يتنبه أحد إلى وقوعها؟». ويعكس استمرار هذه الثغرات غياب التفكير متعدد التخصصات وبعيد المدى داخل أوساط المهنة.
وتتجاوز الشكوك تجاه الاقتصاديين ضعف قدرتهم على التنبؤ أو مواكبة التحولات. وغالباً ما تبدو نصائحهم غير شعبية، بل وقاسية. ويقتضي الترويج للتجارة الحرة والابتكار بالضرورة قدراً من الاضطراب في الوظائف ومصادر الرزق مقابل مكاسب اقتصادية بعيدة الأمد.
ويعني ضبط فواتير الرعاية الاجتماعية تقليصاً للدعم عن فئات من الناس. وعندما تتناقض رؤية الاقتصاديين مع التجربة المعيشية للناس، فلا عجب أن كثيرين يتوقفون عن الإصغاء إليهم. ومع صعود الشعبويين الذين يطرحون بدائل سهلة وسريعة وقليلة التكلفة، مثل الدعم الحكومي والحواجز الجمركية والتخفيضات الضريبية، تصبح مهمة الاقتصاديين في إيصال صوتهم أصعب بكثير.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن الاقتصاد فقد صلته بالواقع، بل في واقع الأمر بات دوره أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في كشف تكاليف السياسات الرديئة، حتى لو لم تحظَ هذه التحذيرات بالاهتمام المطلوب. ويمكن للمهنة أن تعزز أسسها عبر الانفتاح على معارف تخصصية أخرى، واستخدام مصادر بيانات لحظية، وتطوير أدوات لمحاكاة السيناريوهات بما يتيح نماذج أكثر دقة في عالم باتت ثوابته أقل.
في المقابل، فإنه إذا انسحب الاقتصاديون من المشهد، فإن النقاشات ستُترك لقادة ينشغلون أكثر بتكريس سلطتهم، بدلاً من السعي لنتائج اقتصادية رشيدة. ورد الفعل المعاكس تجاه علم الاقتصاد أكبر من أن يُترك حله لغير الاقتصاديين.