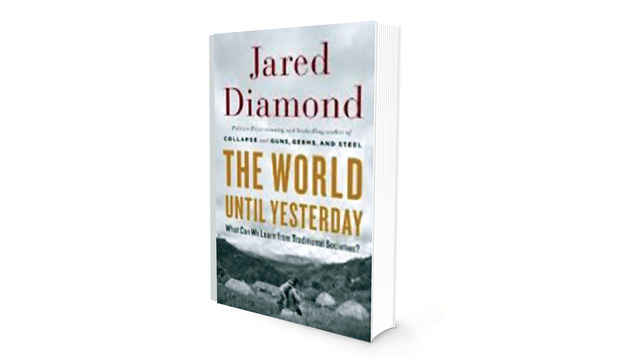العالم حتى الأمس
غياب الحكومة المركزية أخطر ما تواجهه الشعوب الأصلية
مؤلف هذا الكتاب "العالم حتى أمس" أكاديمي ضليع وأستاذ يجمع بين تخصصات الطب والجغرافيا والأنثربولوجيا والبيولوجيا وغيرها، ويتميز أسلوبه برشاقة العرض بما يجذب إلى كتاباته جماهير القراء، ولأنه كذلك، حاز كتابه اهتماما واسع النطاق، خصوصاً وأن المؤلف لم يقتصر في عرض مادة الفصول على ما حصّله من دراسات ومعارف متنوعة جمعت، كما أسلفنا، بين العلوم الطبية، التطبيقية والعلوم الإنسانية، ولاسيما علم الجغرافيا البشرية. والحق أن المؤلف استقى جانباً كبيراً من مادة الكتاب من واقع الرحلات البعيدة والاستقصائيات الميدانية التي حملته مثلاً إلى مجتمعات الشعوب الأصلية التي ما برحت تعيش حياة أقرب إلى الفطرة الأولى، في جزر غينيا الجديدة الواقعة قرب القارة الأسترالية في جنوبي المحيط الهادئ، حيث اتبع المؤلف نهج الصبر الطويل والرصد المتأني لجوانب حميمة من حياة هذه الشعوب، ومن منظور ما يمكن أن تتعلمه شعوب العالم المتحضر المعاصر من السلوك الفطري للشعوب الأصلية على نحو ما حرص على إثباته في عناوين هذا الكتاب الذي لم يكن ليقتصر، سواء في تصورات المؤلف أو تصورات المحللين والنقاد الذين عرضوا لهذا الكتاب، على مجرد ما رصده المؤلف من جوانب رآها إيجابية في حياة تلك الشعوب الفطرية، ومن ذلك مثلاً أساليبهم في تربية وتنشئة الأطفال.
لكن، كان لابد للبحث من أن يمتد إلى حيث يعرض كذلك للجوانب السلبية، فضلاً عن المقارنة الواجبة بين أساليب حياتهم وبين نظيراتها على صعيد الحضارة المعاصرة.
آن الأوان لتبديد الصورة النمطية المقولبة (ستريوتايب) التي حرصت سينما هوليوود على تكريسها في أذهان البشر عن سكان الغابات وقاطني الأحراش وأهل الأدغال، الذين مازالت تعجّ بهم أصقاع شتى في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، تلك هي الصورة التي ظلت ترسمها بدأب شديد وعلى امتداد سنوات أفلام "طرزان" التي طالما خلبت ألْباب أجيال من بعد أجيال من شباب عقود الثلاثينات إلى الستينات، وربما بعدها من القرن العشرين.
مع هذا كله فقد كان للقرن العشرين وجه إيجابي آخر، إذ بدأت أوائل القرن بدعوة حق تقرير المصير للشعوب، تلك التي نادى بها كما هو معروف، الرئيس الأميركي الأسبق ودرو ويلسون في عام 1918، ثم أبى القرن العشرون أن ينتهي إلا بعد أن تصاعدت في آخر مراحله الزمنية دعوات تتصل بإقرار حقوق الإنسان.
هنالك جاءت تعبئة الجهود التي ما برحت تبذلها المنظومة الدولية ممثَّلة بالطبع في منظمة الأمم المتحدة التي أصبح من واجبها السهر على إقرار وتنفيذ وتفعيل عدد من الصكوك، الوثائق الدولية الملزمة لمجتمع العالم، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق ذوي الإعاقات وما إلى ذلك بسبيل.
عن الشعوب الأصلية
بند جديد أضيف مع الثلث الأخير من القرن الماضي إلى جدول أعمال الجمعية العامة. وكان يحمل عنواناً يتصل بحقوق "السكان الأصليين" في طول العالم وعرضه على السواء.
وقد استخدمنا مصطلح "كان" لأن ممثلي هؤلاء "الأصليين" ما لبثوا أن طالبوا بتغيير صياغة البند المذكور لتصبح عبارته كالتالي: حقوق "الشعوب الأصلية" بمعنى أنهم إذاً ليسوا أفراداً متناثرين في فيافي البادية ولا في شعاب الغابات، هم يعّدون أنفسهم "شعوباً" تعيش في مجتمعات متكاملة وبيئات إنسانية لها أعرافها وتقاليدها وعاداتها وعقائدها ورؤاها وأحلامها، شأن البشر في كل زمان ومكان.
الشعوب الأصلية تعيش في المجتمعات التقليدية، فما الذي يمكن أن يتعلمه سائر سكان العالم الحديث المعمور من هذه الشعوب؟
هذا هو السؤال المحوري الذي ظل يلح على خاطر البروفيسور جاريد دياموند الذي يجمع من حيث التخصص والأساس العلمي والتحصيل الأكاديمي والتدريس الجامعي بين ممارسة الطب وبين البحوث والكتابات ذات الأساس العلمي، الإنساني ومنها بالذات الجغرافيا والأنثروبولوجيا.
من هذا المنطلق العلمي الحافل أصدر البروفيسور دياموند كتابه الذي نعايش فصوله في هذه السطور، حول ما يمكن أن يتعلمه مجتمعنا الحديث المعاصر من شعوب المجتمعات التقليدية، أو الشعوب الأصلية.
وإذا كان المؤلف قد اختار لكتابه عنواناً رئيسياً هو "العالم حتى الأمس"، القريب كما قد نتصور، فليس معنى هذا أن ثمة حضّاً على اتباع أساليب تلك المجتمعات الفطرية، ولا هو يدعو كما يقول الناقد ناثان سيبا إلى استخدام أساليب حياة تلك الأقوام والشعوب (مجلة "ساينس نيوز" المعنية بالعلوم الطبيعية)، وإنما يقصد المؤلف إلى أن نتأمل الشخوص والعادات والأفكار والرؤى والتوجهات السائدة بين سكان هذه الأصقاع النائية.
المؤلف يدعونا إلى أن نتأمل الفرد من هذه الشعوب الأصلية، هو نسخة، أصلية بدورها من كل فرد منا، من تكويننا ونوازعنا وأفكارنا بوصفنا من مخلوقات البشر، لكنها نسخة أصلية ولم تجتحها بعد نزعات وأفكار مستقاة من عصور تَلَت عبر تاريخ البشر على الأرض، هي النسخة "الخام" كما قد نقول، وهي لا تتوقف عن تذكيرنا بما كان عليه أسلافنا الأوائل.
الصبر منهجاً
ويعجب القارئ من أسلوب الصبر والأناة الذي اتبعه المؤلف منهجاً في وضع وعرض المادة التي تشكل متن هذا الكتاب، إنه يكاد يفرد فصلاً بأكمله ليشرح فيه، من واقع دراسته الميدانية، كيف تتعامل تلك الشعوب الأصلية مع الأطفال، وبالذات كيف يتعاملون مع طفل يبكي، المؤلف يشير إلى عادات قومه الأميركيين المحدثين، المعاصرين المتحضرين طبعاً، ومنها أن يتركوا الطفل كي يواصل البكاء إلى أن يكفّ ويسكت، أما عند شعوب "الأقزام" في "الكونغو" أو شعوب "الكونغ" في "بوتسوانا" (الجنوب الإفريقي) فهم لا يتوانون في هدهدة الطفل وفي مراضاته والتخفيف عنه، وملاعبته إلى أن يكف عن البكاء خلال ثوان معدودات.
في السياق نفسه، يرصد كتابنا كيف أن الرضاعة الطبيعية حليب الأم هي الأسلوب الأوحد لتغذية الوليد. ولا تعرف المجتمعات الأصلية عن ذلك بديلاً، وفيما عاودت المجتمعات الحديثة المعاصرة اللجوء إلى هذا المصدر الطبيعي بوصفه الأفضل صحياً فإن المؤلف يضيف ملاحظة تفيد بأنه فيما تُرضع الأم الأميركية وليدها حسب جدول أو مواعيد تحددها بمعرفتها، فإن الأم من الشعوب الأصلية لا تتردد في إرضاع طفلها حسب ما يبتغيه الكائن الصغير، يحدث هذا على مستوى مجتمعات جمع الثمار، وهي المجتمعات التي يلاحظ المؤلف أنها تُطلق الطفل الصغير على سجيته بمعنى أن تتيح له حيزاً من الحرية والحركة كي يتعلم فن التعامل مع الطبيعة وسلوك الفطرة بأكثر مما يتاح لطفل المجتمع المتقدم الحديث، صحيح أن هذه المساحات من الحرية تصل إلى أحوال الخطر في بعض الأحيان، فقد يتركون الطفل كي يلامس النار، ومن هذه التجربة يكتوي بالطبع.. ويتعلم، وهو ما رصده المؤلف خلال معايشته لتلك المجتمعات الأصلية، حين لاحظ ندوباً قديمة غائرة في وجوه الكثير من أبناء تلك المجتمعات وكانت راجعة إلى تجارب الطفولة المبكرة في ملامسة الجمْر المتقد من سعير النيران.
لكن الأمر لا يلبث أن يسفر في نهاية المطاف عن نضج مبكر لخبرات الطفل في تلك المجتمعات، وهو ما لاحظه من جانبهم أيضاً عدد من العلماء الغربيين الذين كان لهم خبراتهم مع هذه المجتمعات الصغيرة العدد من شعوب السكان الأصليين، "وكم راعتهم كما يضيف كتابنا، ذلك النضج من حيث المهارات الاجتماعية بين الأطفال فضلاً عما اتصف به الناشئة من كفاءة ودقة وحذق في أداء ما تتطلبه حياتهم وأساليب معيشتهم من مهام.
لا يراود أهل الشعوب الأصلية، القديمة أي إحساس بالوحدة: في جانب إيجابي من هذه الحقيقة، يعيش الأفراد في مجتمعاتهم، مع الآخرين، لا يهم الفرد اسمه ولا كيانه كفرد، لأنه طول الوقت يشكل جزءاً من كل حين يولد ويعيش ويعمل ويرحل عن الدنيا في إطار حيز محدود ومسافة معروفة ومطروقة، ولدرجة أن يلاحظ المؤلف في الكتاب كيف أن شعوباً في غرب إفريقيا يعيش أفرادها ويموتون دون أن يدركوا أن بلادهم تطل على سواحل الأطلسي رغم أن المسافة الفاصلة بين مجتمعاتهم البسيطة ومياه البحر المحيط لا تزيد على 15 كيلومتراً وربما أقل من ذلك بكثير.
الوجه الآخر للعملة
يحرص كتابنا من الناحية الأخرى على أن يعرض للجانب الآخر المقابل لعملة هذه الحياة المبسطة لشعوب السكان الأصليين، حياتهم ليست مجرد تجارب أو مهارات، ولا هي مجرد حرص على تنشئة الأطفال، ولا هي تستند إلى شبكات من وشائج نفسية وعلاقات اجتماعية تذوب فيها فردية الكائن البشري بمعنى انحسار نوازعه الأنانية إلى حد واضح ملحوظ.
ثمة وجه آخر مناقض تماماً لهذا كله، هو الوجه الذي يجعل البعض من هذه الشعوب تترك مرضاها في الفلاة كي يواجهوا مصيرهم ويعبُروا وحدهم عتبات الحياة إلى الآخرة بغير رفيق أو معين!
هذا ما رصده مثلاً عالم الأنثربولوجيا ألان هولمبرغ خلال فترة معايشته لهنود شعب "السيروتو" في أحراش "بوليفيا" بأميركا اللاتينية، تركت القبيلة المريضة وحدها، وقصاراهم أن وضعوا بجوارها مصدراً للنار وجرة للمياه.
هناك أيضاً حروب الصراعات على موارد المعيشة ومن أجل مصادر الحياة. هنا لا تمييز بين شعوب أصلية ذات حياة بدائية، وبين شعوب معاصرة تتمتع بكل مزايا الحداثة ومخترعاتها وتيسيراتها، ولكن الإنسان هو الإنسان، إنسان الحضارة المعاصرة يدخل حروب البترول، وحروب الذهب وحروب الحدود، وحروب الاستيلاء الاستعماري والاستغلال الإمبريالي، وإنسان الشعوب الأصلية يخوض القتال على موارد الثمر ومنابع المياه.
ضراوة الحروب
على أن كتابنا يوضح أن المشكلة في حروب هذه الشعوب الأصلية لا تتمثل في درجة "ضراوتها" بقدر ما تتمثل في حقيقة "استمراريتها".
والأخطر أيضاً كما يقول الكاتب الأميركي دفيد بروكس في نقد هذا الكتاب، هو أن الشعوب الأصلية، تفتقر بحكم التعريف إلى الدولة القومية التي يعيش الناس في ظلها وبالأدق تحت سطوتها في العصر الحديث، في السياق نفسه يقول بروكس: بين فترة وأخرى يحدث أن تخوض الدول الحديثة غمار حروب على نطاق واسع وخطير. لكن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة بحال من الأحوال، والحاصل أن معظم مواطني الدول القومية تصدّهم أنفسهم كبشر، عن الإقدام على قتل الكائن البشري، ثم أنهم تعلموا، من الأسرة إلى المدرسة والمجتمع كيف يضبطون جماح شهوتهم نحو الثأر والانتقام. (نيويورك تايمز، 13/10/2012).
هنا يسجل بروكس ملاحظة مؤلف كتابنا التي يقول فيها: إن شعوب السكان الأصليين لا تشارك الشعوب الحديثة المعاصرة هذه المواقف. وأول مشكلات هذه الأقوام البسيطة (المتخلفة كما قد نقول أيضاً) إنما يتمثل في غياب الدولة، وهو ما يعني بداهة غياب الحكومة المركزية، وبغير هذه السلطة المحورية يظل من الصعب، كما يقول مؤلفنا، وضع نهاية لما قد يشتعل في الدغل أو الغابة أو الجبال من نيران الحروب، ولهذا نستطيع أن نقول إن مجتمعات تلك الشعوب ما برحت تعيش تحت وطأة خطر متربص باستمرار وداهم في كل الأوقات.
هنا أيضاً يشعر القارئ بنبرة أقرب إلى التعاطف مع تلك الشعوب التي شاءت لها أقدارها أن تكتب عليها حياة شبه بدائية، وبحيث يتعين على الفرد، كل فرد، أن يعول نفسه ويحمي نفسه، هذا رغم ما يبثه المؤلف، كما أسلفنا، من روح الإعجاب ببعض أساليب تلك الشعوب في تنشئة أطفالها على أساس مخالطة التجارب الحياتية حتى ولو كانت صعبة، فمنها يتعلمون.
بين العْدل والتوافق
ثم إنهم أيضاً يعيشون حياة غير مقنّنة (بمعنى لا ينظمها القانون العام) وتتسم بطابع شخصي بالدرجة الأولى، على خلاف حياة الإنسان المعاصر التي تجمع بين الطابع المقنن والطابع غير الشخصي.
ولتفسير هذا التباين يعود ناقد "التايمز" دفيد بروكس إلى وقائع هذا الكتاب ليقول: عندما تقع مشاجرة أو نزاع بشأن حادثة مرور في مجتمعنا المعاصر، نبادر للذهاب إلى المحكمة، وتلجأ إلى اللوائح المقننة، ويكون هدفنا هو التوصل إلى حل "عادل" يستند إلى درجة الخطأ الذي جرى ارتكابه.
لكن أهل هذه الشعوب الأصلية المجتمعات التقليدية- يواجهون أي حادثة تقع بعقد سلسلة من الاجتماعات الشعائرية أو الطقوسية كما قد نسميها، وكلها اجتماعات تضم طرفي أو أطراف النزاع وجهاً لوجه. ولن يكون الهدف في هذه الحالة هو تحديد الطرف الذي يقع عليه الخطأ أو الذنب، بل يتمثل هدفهم في استعادة العلاقة التي أساءت إليها أو دمرتها الحادثة التي وقعت، وبهذا يمكن استمرار حالة التوافق بين الناس.
لهذا يقول مؤلفنا: إن أهل تلك المجتمعات لا يكفّون عن التواصل فيما بينهم، ولا تكاد تنقطع حواراتهم ومحادثاتهم آناء الليل وأطراف النهار، وهم في هذا يتقاسمون المشكلات والآراء. لقد كان صعباً بالنسبة لي يضيف البروفيسور دياموند أن أخلد إلى نوبة من نعاس طلباً للراحة خلال رحلاتي الميدانية التي قمت بها داخل تلك المجتمعات، لماذا؟ لأن أهل "غينيا الجديدة" (نيوغينيا جنوب المحيط الهادئ) حيث كنت أقيم بين ظهرانيهم كانوا لا يتورعون عن الاستيقاظ عند منتصف الليل كي يستأنفوا ما كانوا بصدده في ساعات سبقت من ثرثرة الأحاديث.
ثم يستطرد مؤلف الكتاب قائلاً: هكذا يُمضي الناس حياتهم في تلك الأصقاع، يعيشون، ويرحلون على مقربة من الأماكن التي وُلدوا فيها، ويظلون محاطين بحلقات من أقارب العشيرة ورفاق الطفولة .
هنا لا مكان للسأم أو الضجر من رتابة الحياة، الهوية الشخصية، الفردية ليست بالأمر المهم، فالمعيشة وسط الجماعة، العشيرة، القبيلة نابضة بالحيوية، ومن ثم فعندما يكون المرء في "غينيا الجديدة" فكأنك تشاهد الدنيا بإيجاز شديد ولكن بألوان زاهية نابضة بالحياة، ساعتها لا تملك أن تقارن بينها وبين سائر الأماكن في العالم، عالمنا الخارجي فتجدها وقد اتسمت باللون الرمادي.
ومرة أخرى يعلق دفيد بروكس قائلاً: يبدو أن الناس هناك، كما يصورهم مؤلف هذا الكتاب، لا يتعاملون مع الحياة على أنها رحلة، بل على أنها دورة، وبهذا فأبناء تلك المجتمعات يختلفون عنا تمام الاختلاف.
على كل حال يصلح هذا الكتاب في تذكيرنا بأهمية الجغرافيا قدر تذكيرنا أيضاً بأهمية الثقافة وأهمية التاريخ، وهو ما يفضي بنا إلى تأمل أعمق لحقائق حياتنا نحن أهل الحضارة والتقدم والتكنولوجيا، نحن سكان المناطق المأهولة والأرجاء المستنيرة المعروفة من خارطة العالم، بكل ما أصبحنا ندركه ونعايشه بل ونعيشه من أبعاد الزمان والمكان ومن قيم الإنسانية والفردية ومن منظومات السلوك والأخلاق.
صحيح أن هذا الكتاب يحاول أن يقبس شيئاً من تجارب الشعوب التي ما برحت تعيش على الفطرة. ولكن الأصح أن نقرأ مثل هذه النوعية من الكتب لندرك بيقين كم نحن مختلفون أشد الاختلاف.
المؤلف في سطور
ولد البروفيسور جاريد ماسون دياموند في سبتمبر من عام 1937. وقد درس في اثنتين من أهم جامعات الغرب، وهما "هارفارد" في الولايات المتحدة و"كامبردج" في إنجلترا. وكان تخصصه الأساسي في مجال الطب، علم وظائف الأعضاء وبالذات في معالجة أمراض المرارة. وبعدها امتدت اهتماماته المتنوعة كي تغطي مجالات وتخصصات أخرى، منها مثلاً الجغرافيا ثم علم الأنثربولوجيا المعني بنشأة الإنسان وتطور حياته وعلوم الأيكولوجي المعنية بجوانب البيئة الطبيعية والبشرية فضلاً عن علم التطور البيولوجي، وهو ما أدى بداهة إلى توسيع خبرة ومعارف المؤلف لدرجة دفعته إلى دراسة الشعوب والأقوام التي تعيش في مجتمعات أقرب إلى الفطرة ، سواء في أميركا اللاتينية أو في أصقاع الجنوب الباسيفيكي قرب قارة أستراليا.
يعمل البروفيسور جاريد دياموند حاليا أستاذاً لعلم الجغرافيا في جامعة "كاليفورنيا". وقد ذاعت شهرته في هذا المضمار لدرجة أن أطلقت عليه المجامع المختصة لقب "أشهر جغرافي في أميركا". وقد نال عدة جوائز رفيعة في مجالات تخصصه ومنها بالذات الميدالية القومية للعلوم (عام 1999) وجائز الجمعية الملكية للكتب العلمية (أعوام 1992 و1998 و2006) ثم جائزة "بولتزر"، أهم جوائز الأعمال الفكرية الصحافية في أميركا وقد نالها المؤلف عام 1998 خاصة بعد صدور كتابه الذي حمل عنوان "المدافع والجراثيم والفولاذ".
عدد الصفحات: 499 صفحة
تأليف: جاريد دياموند
عرض ومناقشة: محمد الخولي
الناشر: مؤسسة فايكنغ، نيويورك،