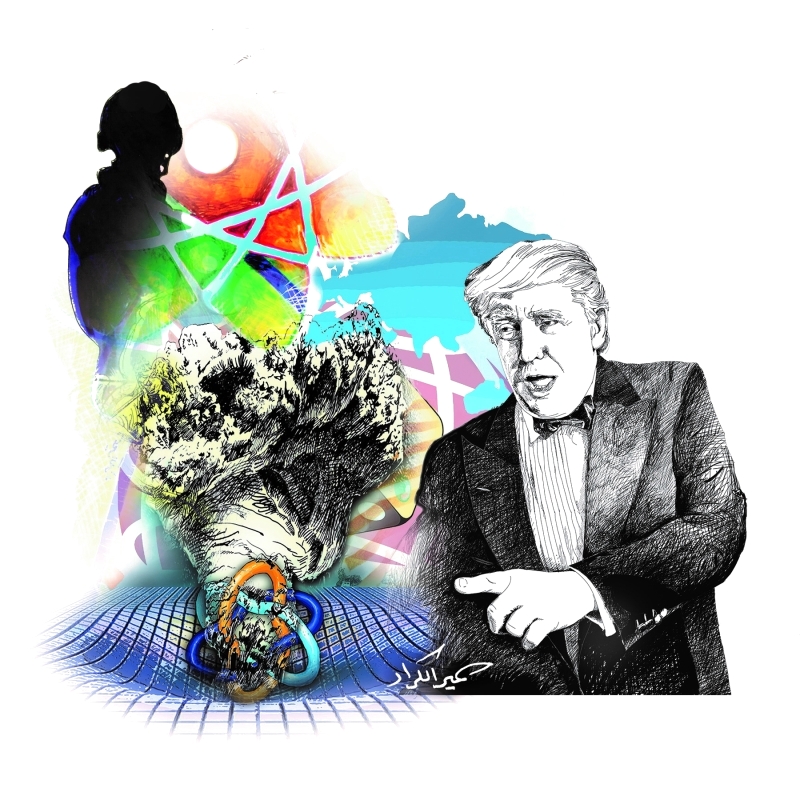صراع القوى العظمى ليس حتمياً
عادت التعددية القطبية، ومعها عادت المنافسة الاستراتيجية بين القوى العظمى، وكانت عودة الصين إلى الظهور وعودة روسيا إلى صدارة السياسة العالمية من الديناميكيات الدولية الأكثر بروزاً في القرن الحالي حتى يومنا هذا. خلال السنة الأولى من إقامة دونالد ترامب في البيت الأبيض، تزايدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين بشكل ملحوظ. ومع تدهور البيئة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، تدهورت أيضا العلاقات الأميركية مع الدول التي تعتبرها بين خصومها الرئيسيين.
عندما تولى الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطة قبل ما يزيد قليلا على خمس سنوات، طرح فكرة «نمط جديد من علاقات القوى الكبرى» يستند إلى التعاون والحوار، فضلا عن الاحترام المتبادل للمصالح الوطنية. لكن الصين لا تلتزم دوماً بما تبشر به عندما يتعلق الأمر بالتعاون، كما تشير تصرفاتها الأحادية في بحر الصين الجنوبي. وعلى نحو مماثل، تتناقض الخسارة النسبية لنفوذ الهيئة الدبلوماسية الصينية مع التعايش الناشئ بين شي جين بينغ وجيش التحرير الشعبي. حتى أن شي أظهر ميلاً مدهشاً لارتداء الزي العسكري.
من جانبها، غزت روسيا جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين في العقد الأخير، كما كان إنفاقها العسكري كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي في ازدياد بشكل غير عادي. فضلاً عن ذلك، تبادلت الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات حول انتهاك معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، وهي اتفاقية التسلح الوحيدة التي ظلت سارية المفعول من عصر الحرب الباردة بين الدولتين.
من المنطقي أن نعترف بالتحديات الراهنة، ولكن ينبغي لنا أن نمتنع عن المبالغة في تصوير حجمها. في الأشهر القليلة الفائتة، نشرت الإدارة الأميركية ثلاث وثائق مهمة: استراتيجية الأمن القومي، واستراتيجية الدفاع الوطني، ومراجعة الموقف النووي. وكل من هذه الوثائق تعتبر الصين وروسيا صراحة بين أعظم المخاطر التي تهدد النظام الدولي. لكن التهديد الرئيسي للولايات المتحدة اليوم لا يأتي من الصين أو روسيا، بل يأتي من قدر هائل من الارتباك والخلط يحيط بسياساتها، بسبب رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب للنظام الدولي الذي ساعدت الولايات المتحدة في صياغته ودافعت عنه لعقود من الزمن.
من الجدير بالذكر أنه عندما يحاول الرئيس ترامب تخويف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من خلال التباهي بالقوة العسكرية الأميركية، فإن الحقائق تقف في صفه ــ ولو لمرة واحدة. ذلك أن الإنفاق العسكري الأميركي هو الأعلى في العالم على الإطلاق، ويكاد يعادل ثلاثة أضعاف إنفاق الدولة صاحبة المركز الثاني وهي الصين، وتسعة أمثال إنفاق روسيا، صاحبة المركز الثالث. والواقع أن إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع يفوق إنفاق الدول الثماني التي تليها مجتمعة، وهي تمتلك الترسانة النووية الأكثر تطوراً في العالَم. ولكن على الرغم من تصريحات إدارة ترامب المتكررة عن التفوق العسكري، فإن تصرفاتها تشير ضمناً إلى أن هذا التفوق ليس كافياً.
وتُعَد مراجعة الموقف النووي المثال الأفضل في التدليل على هذا التنافر المعرفي. ينص المذهب الأميركي الجديد على زيادة عدد الأسلحة النووية التكتيكية ذات القدرات التفجيرية الصغيرة نسبياً. ويتلخص الهدف من هذا التدبير في تحييد القدرات الروسية في هذا المجال، وبالتالي «حرمان الخصوم المحتملين من أي ثقة في غير محلها بأن محدودية التوظيف النووي قد توفر ميزة مفيدة على الولايات المتحدة وحلفائها». ولكن إذا كانت هذه الثقة في غير محلها حقاً، فما الغرض من الاستجابة لها كما لو لم تكن كذلك؟
في تناقض مع وجهة نظر البنتاغون، قد يتسبب التطوير الباهظ التكلفة للمزيد من الأسلحة التكتيكية في خفض عتبة الصراع النووي في حقيقة الأمر. وكما يوضح الخبير روبرت آينهورن من مؤسسة بروكنغز فإن مراجعة الموقف النووي تتضمن فقرة أخرى عقيدية قد تخلف نفس التأثير: العبارة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد تستخدم الأسلحة النووية في الرد على «هجمات استراتيجية غير نووية» والتي لم تحدد إلا بشكل غامض.
إن خفض العتبة النووية يزيد من خطر وقوع كارثة عالمية، وهو الخطر الذي تضعه نشرة علماء الذرة حالياً عند أعلى مستوياته منذ عام 1953. وحتى في ظل الاحتمال البعيد تماماً والمتمثل في القدرة على تجنب التصعيد الجامح بعد «توظيف نووي محدود»، فإن استخدام سلاح تكتيكي واحد كفيل بتوليد انفجار مماثل للانفجارين اللذين دمرا هيروشيما وناجازاكي.
بعد مرور تسع سنوات منذ ألقى باراك أوباما خطابه الشهير في براغ، والذي التزم فيه بالسعي إلى عالَم خال من الأسلحة النووية، لم يعد نزع السلاح يمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة (التي ينبغي لها بوصفها القوة الأكبر في العالَم أن تقود الجهود في هذا المجال). الآن يبدو حصول أوباما على جائزة نوبل للسلام أثرا من الماضي، ولا تخلو الجائزة الممنوحة للحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية في العام الماضي من مفارقة تاريخية حزينة. فالآن يبدو أن سباق التسلح الجديد، الذي أعرب الرئيس ترامب عن دعمه له، يجري على قدم وساق، وإن كان يركز حاليا على تحسين ترسانات الأسلحة وليس زيادة حجمها الكلي.
علاوة على ذلك، قدمت الإدارة الاميركية للتو اقتراح موازنة يقضي بزيادة الإنفاق العسكري في حين يخفض الأرصدة المخصصة لوزارة الخارجية بنحو 25%. ورغم أن الدعم المقدم لهذا الاقتراح في الكونغرس ضعيف، فإن ميزانية ترامب تمثل عرضاً آخر من أعراض نفوره من القنوات الدبلوماسية. وهذا أحد الأسباب وراء التدهور الملحوظ الذي طرأ على صورة أميركا على الصعيد الدولي، ويبدو أن هذا الاتجاه لا يزعج الإدارة الحالية كثيراً.
الواقع أن ما يثير انزعاج إدارة ترامب حقاً - بعيداً عن إيران وكوريا الشمالية ــ هو المنافسة الاستراتيجية المتمثلة في روسيا، وقبل كل شيء الصين. ولكن نظراً للعسكرة الروسية والصينية المتصاعدة، فمن الأهمية بمكان تجنب صب المزيد من الوقود على النار. وصراع القوى العظمى ليس حتمياً ــ ما لم تتصرف هذه القوى وكأنه حتمي.
الحق أن الأمر الذي ينبغي أن يكون الأكثر إزعاجاً للولايات المتحدة ليس تعددية الأقطاب، والتي كانت في تطور منذ مطلع هذا القرن. فالخطر الأعظم الذي يهدد الولايات المتحدة يتمثل في نسيانها للمبادئ والمؤسسات التي عملت على دعم وتعزيز قيادتها العالمية. وإذا استمرت إدارة الرئيس ترامب في التأكيد على سرد المواجهة، فقد تنتهي بها الحال إلى خلق نبوءة ذاتية التحقق.
* ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. وهو يشغل حالياً منصب رئيس مركز إيساد (ESADE) للدراسات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.