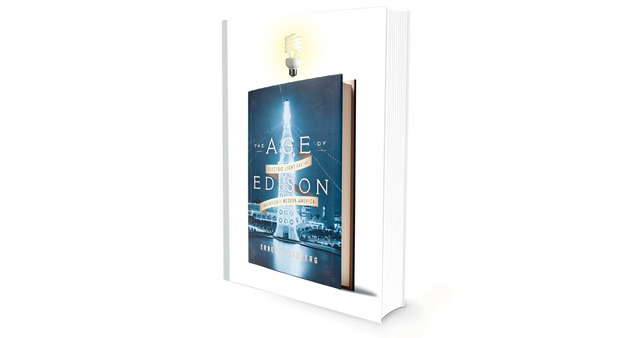عصر توماس أديسون
مصباح أديسون يحقق أحلام البشر
أدى اكتشاف نور الكهرباء إلى التحولات الديمقراطية في الحياة الأميركية.
تلك هي المقولة المحورية التي انطلق منها المؤلف، البروفيسور أرنست فريبيرغ، أستاذ علم التاريخ بالجامعات الأميركية في وضع مادة هذا الكتاب، وبمعنى أن المؤلف لم يقتصر في الكتاب على مقدمات وملابسات ونتائج التوصل إلى المصباح المضاء بطاقة الكهرباء على نحو ما تعرفه حياتنا، بل إنه يعمد إلى تقصي انعكاسات هذا الكشف التاريخي الذي توصّل إليه العبقري الأميركي توماس أديسون منذ 114 سنة أو نحوها من عمر هذا الزمان الحديث، مما أدى إلى إحداث ثورة في حياة الناس في كل أرجاء الأرض، يستوي في ذلك ساكن الغابة الذي يكبس زراً صغيراً لإضاءة مصباح كهربائي بسيط ورخيص، بقدر ما يستوي مشغّلو الآلات والماكينات ووسائل النقل الضخمة والحديثة التي أصبحت تندفع بطاقة الكهرباء.
وفي معرض السيرة الشخصية، يوضح الكتاب كيف أن أديسون لم ينل أي نصيب يُذكر من التعليم النظامي في سلك المدارس بولاية «أوهايو»، حيث كانت نشأته.
ومع ذلك فقد كان يمضي الأيام والساعات الطوال عاكفاً على إجراء التجارب المعملية في مختبره العتيد بولاية «نيوجيرسي» المجاورة «لنيويورك»، ومنه أعلن اكتشافاته المدوية التي ما برحت تؤثر في حياة سكان الأرض قاطبة وكان في مقدمتها جهاز «الفونوغراف» لتسجيل الأصوات للمرة الأولى في التاريخ، وبعده «المصباح الكهربائي» الذي حلّ محل مصابيح غاز الاستصباح التي طالما ضيقت على حياة الناس سواء بتقلبات أضوائها أو لرائحة الكبريت المنبعثة منها.
ظل أهل الأرض بانتظار أن يتيسر لهم مصباح يشع بالنور ليملأ حياتهم ضياء وبشراً وحبوراً قرونا طويلة.
صحيح أنه سبق لهم على مدار قرون وأحقاب استخدام مصادر عدة لعلها تجلب لهم نوراً أو بعضاً من نور، هكذا جاء استخدامهم المشاعل والشموع إلى أن تصوروا مع أواخر القرن التاسع عشر، وربما قبل هذه الحقبة بقليل، أنهم قد نالوا المراد عندما استخدموا «غاز الاستصباح» فأضاؤوا به الشوارع والبيوت وإن ظل الأمر مقصوراً على أرستقراطية المجتمع وصفوة الموسرين.
يذكر تاريخ المصريين مثلاً أن الخليفة الفاطمي «الحاكم بأمر الله» أصدر أوامره بأن لا يستخدم أهل القاهرة دروبها ومسالكها بالليل إلا بعد أن يحمل كل فرد مصباحاً ينير به أو يحاول أن ينير به ظلمات الطريق، وعندما استطاع «الخديوي إسماعيل» أن يضيء شوارع وسط القاهرة بغاز الاستصباح في ستينات القرن التاسع عشر سجلوا صنيعه في دفتر التاريخ على أنه تحديث لعاصمة المصريين، ما جعلها أقرب ما تكون إلى العاصمة الفرنسية باريس.
مشكلات غاز الاستصباح
بيد أن أضواء الغاز المذكور كانت تنطوي على مشكلات، كانت معتمة بقدر ما كان يعتريها الكثير من التقلّب الذي يحمل بدوره الكثير من الخيالات والظلال، هذا فضلاً عن روائح الكبريت البغيضة التي كانت تنبعث أيامها من مصادر الغاز.
والحاصل أن كان العالم بانتظار مخاض جديد يشيع الضياء والبهجة في جنبات الكرة الأرضية على نحو ما هو حاصل في حياتنا المعاصرة.
المهم أن ظل مسرح الانتظار خالياً إلى أن دخله ذلك الأميركي العجيب الذي كان يبلغ من العمر، وقت اللحظة الحاسمة 32 سنة. وقد حانت اللحظة الفاصلة في عام 1879، عندما أهدى العقل الإنساني إلى شعوب العالم «مصباحاً»، وهو أول مصباح كهربائي في التاريخ.
كانت الهدية من إبداع بطل الأحداث في الكتاب الذي نعايش فصوله في هذه السطور. توماس ألفا أديسون مكتشف الكهرباء في شكلها الراهن، ومخترع مصباح الكهرباء الأولى المبسط وهو الجد الأعلى أو السلف - كما قد نسميه - لكل مصادر النور والطاقة الضوئية في حياتنا المعاصرة.
أديسون الإنسان
ربما تتبادر إلى الذهن صورة توماس أديسون بوصفه عبقرياً من طراز أينشتاين مثلاً، بمعنى العالِم الجهبذ والمفكر الموسوعي الذي يرتبط باسمه وبتحصيله العلمي سنوات طويلة من الدراسة ومصفوفة من الشهادات والأوسمة ودرجات الماجستير والدكتوراه شأن عباقرة العلماء والمفكرين. لكن الحقيقة على خلاف هذا كله.
كتابنا الذي يعرض لسيرة (أبو المصباح الكهربائي) يقول لنا إن أديسون لم ينل من حظوظ التعليم النظامي في بلاده إلا ثلاثة أشهر، نعم ثلاثة أشهر أمضاها ملتحقاً بمدرسة ابتدائية شبه منسية في مسقط رأسه بولاية «أوهايو» بالولايات المتحدة.
أكثر من هـــــــــذا، يوضح لنا هذا الكتاب كيف أصيب أديسون بعاهة الصمم التي ظلت تشتد وطأتها كما يضيف مؤلفنا - كلما امتد العمر بالرجل الذي رحل عن الحياة عام 1931 وكان وقتها في سن الرابعة والثمانين.
ثم يمضي المؤلف موضحاً كذلك أن شوق الناس إلى الضياء جاء محفوفاً مع الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بهواجس سادت وقتها جنبات مجتمع أديسون الأميركي.
وقتها كان أهل «أميركا» يتسامرون عن الأصول الأولى للبحوث التي كانت تحاول التوصل إلى ضوء الكهرباء، وكانت البحوث في «إنجلترا» على وجه التحديد. والحاصل أن سنة 1809 شهدت عالم الكيمياء الإنجليزي «همفري دا» وهو يقدم إلى العالم كشفه التاريخي الذي حمل الاسم التالي:
«قوس الضوء الكهربائي». وكان هذا القوس عبارة عن جسمين من الكربون تعبر بينهما شحنة كهربية تبعث ضوءاً كم كان مبهراً في تلك الأيام البعيدة.
«القوس الكهربائي» كان بمثابة القريب البعيد كما يسميه كتابنا في عائلة «مصباح أديسون الكهربائي»، مع ذلك ظلت الأقواس المشعة بالضوء تنير شوارع مدن القرن التاسع عشر، فيما كان أهلها يعدونها آية على ما تتمتع به حواضرهم من نعمة التقدم والرفاه والرخاء.
ولم يكن مصادفة أن ظل أهل «نيويورك» مثلاً يتغّنون بحسن حظ مدينتهم التي أضاءت شارعها «الخامس» الشهير وهو شارع الفن والمسرح والترفيه بأضواء الأقواس المشعة التي تصوروا أنهم دخلوا بفضلها عصراً ذهبياً غير مسبوق.
لكن المشكلات ظلت قائمة كما تقول فصول الكتاب. أصوات الطنين الدائم تنبعث من أقواس الضياء، الأقواس المضيئة تضايق الناس، وخاصة الأثرياء الذين أنفقوا المبالغ الطائلة لجلبها إلى حيث يقطنون، وكان أخطر عوامل المضايقة، وكما ينقل كتابنا أيضاً عن أهل تلك المرحلة في أميركا تلخصه عبارة واحدة هي: أن أضواءها تؤدي إلى تضخيم ملامح الناس!
فإذا بالتجاعيد وقد تجلت وأخاديد التقدم في العمر وقد تبّدت، فما بالنا وأن الأضواء تميل إلى زرقة تنعكس سلباً على ملامح البشر، وخاصة الغيد الحسان! يومها قال قائلهم على نحو ما تنقل سطور الكتاب أيضاً: إن هذه الأضواء الزرقاء تؤدي إلى طمس معالم الجمال الطبيعي للجنس الأنغلوسكسوني في أميركا.
من هنا كان طبيعياً أن يتزاحم العلماء والمخترعون والمبدعون والمغامرون، وأحياناً المقامرون والمدّعون على التوصل إلى المصباح الكهربائي، المأمول من حيث الكفاءة والسلامة، والمعقول من حيث السعر، وربما المطلوب للحفاظ على ما كان القوم أيامها يدّعونه من جمال طبيعي يتمتع به أحفاد الأنغلوسكسوني من المهاجرين الذين كانوا قد وفدوا على الأرض الأميركية مع أيام القرن السابع عشر للميلاد.
حدث في 1877
يقول الصحافي ديد رايس ناقد صحيفة «وول ستريت جورنال» في معرض تحليله لمقولات هذا الكتاب: «حلت سنة 1877.
وكان أن قرر توماس أديسون أن يركّز جهوده على التوصل إلى ناتج عملي من ناحية الأداء واقتصادي من ناحية السعر، صحيح أنه دخل ساحة كانت وقتها تشهد سباقاً بين الطامحين إلى بلوغ الهدف نفسه، ولكن «أديسون» كانت له ميزة أفضل من سواه في هذا المضمار.
كيــــف؟ لأنه سبق وأن اخترع جهازاً للتسجيل الصوتي اسمه «الفونوغراف»، وسبق لهذا العبقري أن أضفى تحسينات ملموسة على اختراعين شهدهما عصره وهما «التلغراف» و«الهاتف التليفوني».
والحق أن كوفئ توماس أديسون بما أبداه من كفاح ومثابرة وإصرار: جاء عام 1879 فإذا به، عقب آلاف من التجارب في مختبره يعرض أمام زائري المختبر في ناحية «منلوبارك» بولاية «نيوجيرسي» المجاورة «لنيويورك» عدداً لا يقل عن 50 من الصنف الذي ظل يراود أفئدة البشر وأحلامهم على السواء، المصباح المتوهج بطاقة الكهرباء. ساعتها انتفض الصحافيون من بين الزائرين بشعور من الدهشة الممزوج بقدر لا يخفى من البهجة.
ساعتها قال صحافي: «لقد شهدنا دنيا جديدة مصغّرة من توهج أشعة الشمس».
وقال صحافي آخر: «كأننا طالعنا ألفاً من صفائح الماس».
وسواء شاهدوا شمساً مشرقة أو ماساً مبهراً، فالحاصل أن «أديسون» قدم للعالم ما يصفه ناقد «وول ستريت» في كلمات تقول: أياً كان الأمر، فقد أصبح المصباح الكهربائي كما عرفناه حقيقة واقعة، وأصبح بوسع العالم أن يستغني عن قسوة الأضواء المنبعثة من القوس الكهربائي القديم فضلاً عن التخلص من روائح الكبريت القابضة المنبعثة من لمبات غاز الاستصباح، ذلك أن توماس أديسون أنجز مساهمته وقتها وتلخصت فيما يلي: لقد قدم للعالم أنوار المستقبل.
وداعاً إذاً لما كان الناس قد درجوا على استخدامه حتى تلك الفترة من جذوة الحطب، إلى نيران الشعلة، إلى الشموع، ولمبات الكيروسين ثم مصابيح غاز الاستصباح.
سعر باهظ للمصباح
لكن اختراع المصباح الكهربائي لم يكن كافياً بكل تأكيد: هكذا يستدرك البروفيسور أرنست فريبيرغ مؤلف الكتاب، موضحاً أن الاستخدامات المنزلية والحَضَرية والجماعية لمثل هذا الاختراع كانت تتطلب رؤية أوسع نطاقاً وأكثر شمولاً من مجرد الحصول على مصباح كان سعره وقت نزوله الأول إلى السوق ما يصل بأسعار زماننا الراهن إلى 23 دولاراً، وهو ما كان يعادل وقتها أجر العامل الأميركي في يوم كامل، هنالك عاود «أديسون» اللجوء إلى عقليته البرغماتية التي تجمع بداهة بين المنحى العملي والمسار الواقعي بغير تزيّد أو استسلام للأحلام.
كان أول من يدرك أن الأمر بحاجة إلى رؤية جديدة لمستقبل مصباح الكهرباء، رؤية ترتبط بأبداع أساليب توزيع الطاقة الكهربية، من خلال شبكات ومنظومات ومحطات.
هنا يوضح الكتاب كيف خاض المكتشف - المخترع الكبير سباقاً محموماً ومنافسات ضارية مع غريمه في نفس المجال وهو جورج وستنغهاوس الذي كان قد توصّل بدوره إلى ما أصبح يعرف باسم «التيار الكهربائي المتردد أو المتناوب».
وبغير تفاصيل عن هذه المنافسات، فالحاصل أن استفادت البشرية من محصّلاتها على نحو ما تلمح إليه فصول الكتاب الذي نلاحظ من جانبنا أن مؤلفه ارتأى أن الأجدر بالتركيز ليس المعارك الاقتصادية بغرض المكاسب المالية التي خاضها توماس أديسون ومنافسوه، بل الأهم هو تدارس الظاهرة المستّجدة في أميركا، ومن ثم في المجتمع البشري بشكل عام، ويطلق عليها الوصف التالي: «مقرطة الضوء»، وبمعنى أن جاءت الكهرباء وصفةً ناجعة وناجزة لإشاعة التحول الديمقراطي ونشر ظاهرة المساواة على نحو أو آخر بين جموع المواطنين.
لقد كان ضوء الكهرباء أرخص ثمناً من الغاز، وكان من اليسير استخدامه بوساطة أي فرد، وذلك على خلاف ضوء الغاز الذي كان يتطلب أفراداً لهم مهارات خاصة لتشغيله فضلاً عن صيانته وإبقائه في حيز الاستخدام، والمهم يضيف الكتاب - أن هذه الثورة المكهربة، كما قد نصفها، وصلت إلى كل مجالات الحياة الأميركية.
لقد استطاع الأميركيون أن يمارسوا هواية القراءة في مضاجعهم بالبيت بعد أن توافر لهم نور الكهرباء، وجاء دور المدن كي تضاء شوارعها وأرصفتها وإشارات مرورها بأضواء الكهرباء فضلاً عن واجهات متاجرها ولوحات الإعلان المنصوبة على أسطح مبانيها.
كل هذا أدى إلى ما يصفه كتابنا بأنه «خلْق الإحساس العميق بتجربة الحياة الحضرية الحديثة»، وكان ذلك منذ وقت ليس بالقصير، بل كان على وجه التحديد ابتداء من عام 1904 حين عاشت أميركا، ومن بعدها عالم القرن العشرين ما اصطُلح على تسميته بأنه «ثورة الكهرباء» التي لم تقتصر بداهة على شوارع المدن ولافتات الإعلان بل امتدت إلى حيث أصبحت ثورة اقتصادية بعد أن دخلت الطاقة المستجدة إلى أروقة مصانع الإنتاج ومواقع الخدمات على اختلاف تخصصاتها، ويكفي مثلاً أن أتاحت الكهرباء تنظيم ما أصبح يوصف بأنه «النوبة الليلية» في المصانع والمعامل وما في حكمها وهو ما أدى بالطبع إلى ما يقرب من مضاعفة الإنتاج والإنجاز.
أما في دنيا العلم فقد أدى ضوء الكهرباء إلى المزيد من دقة العمليات الجراحية كما فتح السبيل أمام اكتشاف قاع البحر بكل ما يحتويه منذ بدء الخليقة من إمكانات وكنوز.
وهناك السلبيات أيضاً
لكن لكل إيجابية سلبياتها بطبيعة الحال.
جاءت الكهرباء لتضيء الدنيا. لكنها كانت وافداً مستجداً على حياة الناس الذين لم يألفوها ولا اعتادوا عبر السنين على التعامل معها ومع ما قد ينطوي عليها من أخطار.
هكذا شهدت أميركا في بواكير تعاملها مع الكهرباء أعداداً من الضحايا من العمال الذين أصيبوا بصدمة الصعق الكهربائي، ما أدى إلى الوفاة أحياناً أو إلى إصابات بالغة في بعض الأحيان.
ولأن عمال الكهرباء كانوا يعملون في تمديد الأسلاك ونصْب الشبكات على مرأى ومسمع من المارة في شوارع المدن الأميركية وساحاتها، فكم فوجئ الناس بضحايا الصعق الكهربائي وهم معلقون على الأسلاك، لدرجة أوحت لصحافي أميركي كما يقول مؤلفنا - باقتراح تشغيل المحكوم عليهم بالإعدام في نشر الأسلاك وتجهيز الشبكات وعلى أساس أنهم سوف يُعدمون بالكرسي الكهربائي في كل حال!
وبديهي أيضاً أن اختراع أو اكتشاف توماس أديسون لم يكن ليقتصر على حكاية المصباح الكهربائي، لأن طاقة الكهرباء مازالت هي المحور رقم واحد في حياة أهل المعمورة على اختلاف أقطارهم وثقافاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، يستوي في ذلك زر الكهرباء البسيط في ردهة الكوخ الإفريقي بقدر ما تستوي السيارة الكهربية المرتقب انتشارها في المستقبل أو فلنقل السيارة الهجين (Hybrid) كما يسمونها، حيث تجمع في تشغيل محركها بين الكهرباء والبترول، بقدر ما تستوي القطارات الحديدية فائقة السرعة أو الهواتف النقالة حديثة الإمكانات.
ولقد قاد توماس أديسون كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب - حقبة فريدة في تاريخ أميركا والعلم، لأنها كانت حقبة المخترعات التي أدت إلى تحويل، بل تثوير، حياة الأفراد والشعوب منذ الهزيع الأخير من القرن التاسع عشر وربما حتى ثلاثينات القرن العشرين.
ولهذا فقد أحسن المؤلف، البروفيسور أرنست فريبيرغ، عندما ظل يبحث عميقاً بين الأضابير والملفات لكي يستخلص المعالم الأساسية لحكاية توماس أديسون، لا من خلال سيرته الذاتية كمخترع عبقري، ولكن بوصفه مفكراً ومكتشفاً يعيش في وسط اجتماعي اقتصادي كان له أبعاده وسماته المميزة - وذلك على نحو ما يقوله تحليل مارسي بارتوزياك في جريدة «واشنطن بوست» لهذا الكتاب، مضيفاً أن «أديسون» نفسه لم يكن يتخيل أن كثيراً من مجالات حياة البشر سوف تفيد من ثمار اكتشافه لضوء الكهرباء ابتداءً بفنّ ومهنة التصوير الفوتوغرافي وليس انتهاء بجهود الأبحاث الميكروسكوبية، ومن هنا كان حقاً على دنيا الفن أن تبدع المصابيح المنحوتة دقة ورشاقة وجمالاً، فيما كان على دنيا التعليم أن تفسح جامعاتها كي تضم أقساماً ومختبرات ودراسات تمنح الدرجات العلمية المرموقة في عالم كان مستجداً واسمه: «هندسة الكهرباء».
المؤلف في سطور
كانت النشأة الأولى لمؤلف الكتاب، البروفيسور أرنست فريبيرغ في منطقة «نيو إنجلند»، شرقي الولايات المتحدة، وهي التي مازال أهلها يعتزّون بأصولهم الممتدة في معظمها إلى أوائل موجات المهاجرين إلى أرض «العالم الجديد» كما كانوا يسمون «أميركا» منذ أيام القرن السابع عشر وربما قبلها.
وقد بدا المؤلف العمل مذيعاً في إذاعة ولاية «مين» بعد إكمال دراسته الجامعية، ثم أصبح أستاذاً متميزاً للعلوم الإنسانية في جامعة «تنيسي»، حيث أصدر كتابين نالا جوائز الامتياز وكانا في مواضيع تتصل أساساً بأحداث ووقائع التاريخ الأميركي، ويلاحَظ أيضاً أن أغلب الدراسات التي عكف المؤلف على بحثها، ومن ثم إصدارها، لا تلبث أن ترقى إلى مرتبة الجوائز التي تبادر إلى إعلانها ومنحها الجمعيات العلمية المتخصصة من باب التقدير لجهود البروفيسور «فريبيرغ» في الرجوع إلى المصادر الأصلية المتعلقة بما يختاره من قضايا وشخصيات، وقد اشتهر المنهج الذي يتبعه المؤلف بأنه لا يقتصر على الحقيقة التاريخية بقدر ما يعمد إلى بحث وعرض الصلات التي تجمع بين هذه الحقيقة وبين ارتباطاتها ومدلولاتها ومآلاتها وتأثيراتها في كل من الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وربما النفسي في حياة الناس.
وهذا المنهج، الذي يتمازج في إطاره البُعد العملي مع البُعد الاجتماعي والثقافي والسلوكي، هو بالضبط ما اعتمده البروفيسور أرنست فريبيرغ في بحثه عن مادة كتابه الذي يعرض فيه بإيجاز للجوانب الشخصية من حياة العبقري الأميركي توماس أديسون، فيما يلقي مزيداً من الأضواء على انعكاسات المصباح الكهربائي وطاقة الكهرباء بشكل عام على جوانب شتى من الحياة الأميركية.
عدد الصفحات: 378 صفحة
تأليف: إيرنست فريبيرغ
عرض ومناقشة: محمد الخولي
الناشر: مؤسسة بنغوين، نيويورك،